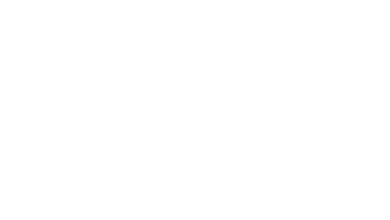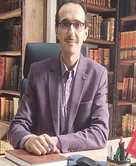لحظات سلام مصطنعة: هل أصبح ترامب أداة في يد خصومه قبل حلفائه؟(الطاهر بكني)
لم يتوقف دونالد ترامب منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض، عن تقديم نفسه كـ«صانع سلام عظيم» حُرم من التقدير العالمي الذي يراه مستحقا، وفي مقدمته جائزة نوبل للسلام. غير أن هذا الهوس الذي بدأ كطموح شخصي تحول إلى نقطة ضعف جيوسياسية استغلتها العواصم بذكاء، إذ أدركت أن طريق النفوذ إلى ترامب يمر عبر صورته لا عبر مواقفه، وأن إغراؤه بمشهد سلام أو وساطة رمزية قد يدر مكاسب ملموسة في الاقتصاد أو الأمن أو السياسة.
وهكذا، تحولت “دبلوماسية نوبل” في عهده إلى أداة للتأثير المعكوس: رئيس يسوق ذاته بصفته رمزا للسلام، بينما تعيد القوى الإقليمية والدولية صياغة علاقاتها مع واشنطن وفق منطق الغرور لا منطق المصالح.
وجد ترامب نفسه، وهو يدير الشأنين الأمريكي والعالمي بمنطق نزوي تغذيه نزعة سلطوية واستعلاء أيديولوجي، أمام اختبار قاس تمثل في أزمة الإغلاق الحكومي التي شلت مؤسسات الدولة، أعقبها قرار بطرد آلاف الموظفين، ما فجّر موجة احتجاجات عارمة في مئات المدن الأمريكية، رفعت شعارات منددة بتسلطه وعبثه بالمؤسسات الديمقراطية.
وهكذا بدا المشهد الأمريكي وكأنه انعكاس لفوضى يقودها رجل يرى في السلطة امتدادا لذاته، لا تكليفا بخدمة الأمة، لتتحول قرارات البيت الأبيض إلى ترجمة مباشرة لمزاجه المتقلب أكثر مما هي حصيلة رؤية استراتيجية أو مشروع وطني جامع.
ولا شك أن ترامب، في جوهر سلوكه السياسي، يميل إلى الابتزاز كمنهج تفاوضي؛ فهو لا يرى في الدبلوماسية أداة للتفاهم، بل ساحة للمساومة المستمرة. فكلما تفاعل معه طرف دولي وقدم له تنازلا، ازداد نهمه لانتزاع المزيد، مدفوعا بقناعته بأنه “الرجل الذي لا يهزم في عقد الصفقات”.
ومن هذا المنطلق، تتحول المفاوضات معه إلى سلسلة لا تنتهي من المقايضات، يبتز فيها الآخرين باسم “الصفقة الكبرى” التي لا وجود لها إلا في خياله السياسي، حيث تختزل السياسة في منطق التفاخر لا في منطق الدولة.
وهو ما أدركته حركة طالبان جيدا حين رفضت الانصياع لتهديدات ترامب بشأن قاعدة باغرام، مدركة أن أي تنازل في هذا الملف لن يكون سوى بداية لسلسلة لا تنتهي من المطالب والضغوط، فترامب –في نظرها– لا يكتفي بنصف خطوة، بل يسعى دوما لفرض إملاءاته على مراحل، مستغلا كل تراجع لصنع مكسب جديد يفاخر به في الداخل الأمريكي.
وهو المنطق ذاته الذي طبّقه ترامب مع أوكرانيا، حين حول الحرب إلى صفقة تجارية صريحة؛ فبعد أن طالب كييف بتخصيص نصف عائدات الموانئ وبعض مواردها الطبيعية، بما فيها المعادن النادرة، مقابل استمرار الدعم، عاد ليصرح لاحقا بأن أمريكا “تبيع” الأسلحة لحلفائها في الناتو، وهم بدورهم يزودون بها أوكرانيا، في محاولة لتصوير الأمر كصفقة مربحة لا كالتزام استراتيجي.
وبهذا الطرح، أفرغ مفهوم التحالف من مضمونه، محولا الحرب إلى مشروع استثماري يُدار بالأرباح لا بالمبادئ، حيث تتنصل واشنطن من كلفة الصراع لتظهر بمظهر التاجر الذي يربح من كل الأطراف دون أن يدفع ثمنا سياسيا أو أخلاقيا.
واليوم يعيد ترامب السيناريو ذاته مع فنزويلا، كما فعل سابقا مع غزة، حيث يتعامل مع الأزمات لا كقضايا إنسانية أو نزاعات تحتاج إلى حلول سياسية، بل كفرص لابتزاز الأطراف وتحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية. ففي الملف الفنزويلي، يربط المواقف الأمريكية بمصالح الطاقة والنفوذ في القارة اللاتينية، محاولا إعادة رسم خريطة التحالفات وفق منطق “الصفقة لا الشراكة”.
أما في غزة، فقد استخدم خطاب “السلام” لتبرير دعم غير محدود لإسرائيل، متحدثا عن “إنهاء الحرب” وهو يمنحها ضوءا أخضر لمواصلة التصعيد، في مفارقة تكشف أن “السلام الترامبي” ليس إلا غطاء بلاغيا لسياسات القوة، وأن كل أزمة في عهده تُختزل في معادلة واحدة: من يدفع أكثر، ومن يمنحه مشهد الزعيم المنتصر.
وبالرغم من أنه شيد صورته على أنه “الرجل القوي” القادر على استعادة هيبة أمريكا، إلا أنه سرعان ما وجد نفسه محاصرا بتآكل شرعيته الدولية نتيجة سلسلة قرارات ارتجالية أقرب إلى استعراضات إعلامية منها إلى حسابات دولة عظمى. فحين تباهى بأنه أنهى حروبا ومنع أخرى، لم يكن يتحدث عن استراتيجية مدروسة بل عن ردود أفعال آنية تحكمها نزعة “اللقطة الرئاسية” التي تضمن له حضورا في العناوين أكثر مما تحقق مصالح وطنية طويلة الأمد.
ولأن السياسة الخارجية في عهده تحولت إلى مسرح لإدارة الصورة لا لموازنة القوة، فقد فهمت العواصم العالمية مفتاح التعامل معه: لا عبر النقاش في الملفات الشائكة، بل عبر منحه مشهدا يوحي بأنه صانع سلام تاريخي. وهكذا، تحول هوسه بالاعتراف والرمزية إلى أداة تفاوضية بيد الآخرين، يقدم من خلالها تنازلات سياسية واقتصادية في مقابل لحظة مجد عابرة أمام الكاميرات.
فحين أعلن عزمه على سحب الدعم عن أوكرانيا، دخلت العواصم الأوروبية في سباق دبلوماسي محموم لإنقاذ ما تبقى من وحدة الموقف الغربي، لكنها سرعان ما أدركت أن منطق المصالح والقيم لا ينفع مع رئيس تحكمه نزعة استعراضية، بل إن الطريق إليه يمر عبر مداعبة غروره لا إقناعه بالعقل.
لذلك، صاغ الأوروبيون خطابهم بلغة تغذي نرجسيته، فحولوا فكرة الاستمرار في دعم كييف إلى “مبادرة سلام بطولية” تعيد إليه وهج الزعامة وتقدمه للعالم كمن أنهى الحرب لا من أشعلها. ومن باريس إلى برلين، تكاثرت العروض التجارية والصفقات الاقتصادية في مقابل بقاء الدعم ولو في حدوده الرمزية، في مشهد يلخص ما يمكن تسميته بـ”الدبلوماسية النفسية”، حيث يقايض الغرب وهج الصورة باستمرارية الموقف.
فالغاية لم تكن إقناع ترامب بعدالة القضية، بل إقناعه بأنه البطل الذي وحد أوروبا من أجل السلام، فيما الهدف الحقيقي ظل أكثر براغماتية: حماية أوكرانيا وتماسك الغرب من الانهيار تحت نزوات البيت الأبيض.
ويعد ترشيح باكستان لدونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام في يونيو 2025 أحد أوضح الأمثلة على توظيف العالم لهوسه بالاعتراف الدولي لتحقيق مكاسب استراتيجية. فهذه الخطوة لم تكن مبادرة ودية بقدر ما كانت مناورة دبلوماسية ذكية استغلت نرجسيته لتطويع الموقف الأمريكي بعد سنوات من البرود.
فبمجرد أن قدمت له إسلام أباد ما يشتهي من المديح والرمزية، فقد فتحت لنفسها أبواب واشنطن مجددا، بينما توترت علاقاتها مع نيودلهي. لكن هذه الواقعة تكشف أيضا جوهر ما يمكن تسميته بـ”السلام الترامبي”: سلام قائم على القهر والدعاية لا على المصالحة والحلول.
فترامب الذي رأى في قصف إيران “خطوة نحو السلام”، اعتبر أن الصمت الذي تلاه برهان على حكمته، متجاهلا أن الهدوء المفروض بالقوة ليس سوى هدنة عابرة. لذلك، لم تكن اتفاقياته سوى مسرحيات سياسية قصيرة العمر، تنهار فور غياب الكاميرات، لأنها صُنعت لتخدم الصورة لا التاريخ.
ولم تكن باكستان وحدها من قرأت مفاتيح شخصية ترامب. فموسكو وأنقرة بدورهما تعلمتا كيف تتعاملان مع “الرئيس المهووس بصورة الزعيم العالمي”. ففي الكرملين، كان فلاديمير بوتين يدرك أن مكالمة هاتفية تحمل عبارة من قبيل “معك يمكن أن يتحقق السلام العالمي” كفيلة بتليين موقف ترامب في ملفات معقدة مثل العقوبات والطاقة.
أما أنقرة، فقد استخدمت الأسلوب ذاته لتخفيف الضغط الأمريكي في ملف منظومة إس-400 الروسية، عبر تسويق مبادرات وساطة في سوريا وشرق المتوسط تظهر ترامب كـ”الوسيط الأعظم”.
كانت النتيجة متشابهة في جميع الحالات: هدنات مؤقتة بلا مضمون حقيقي، حيث حصد ترامب أضواء الكاميرات ورضا نرجسيته، بينما حصدت الدول الأخرى تنازلات سياسية واقتصادية ملموسة. وتحولت الولايات المتحدة، بفعل هذا النمط، إلى قوة يمكن التلاعب بها عبر مداعبة غرور رئيسها، لتصبح كما يرى بعض المراقبين الأمريكيين أداة في يد خصومها قبل حلفائها.
وفي عهد ترامب، صار “السلام” سلعة دعائية تُسوَّق عالميا، يمنح من خلالها الرئيس وعودا دون استراتيجية واضحة، ويتيح لمن يعرف مفاتيح غروره تحقيق مصالحه الخاصة. وهكذا، لم تعد واشنطن تصنع السلام، بل تبيعه في مشاهد مصطنعة تتحكم فيها العلاقات العامة، ويتقلص نفوذها الحقيقي من قوة قيادية إلى مجرد صورة قابلة للتداول.
الأخطر أن هذا المنطق ترك أثره العميق على صورة الولايات المتحدة في العالم. فقد تحولت من قوة تُهاب إلى قوة يمكن استرضاؤها، ومن زعيمة للنظام الدولي إلى ممثل في مسرح الغرور السياسي. والنتيجة: اتفاقيات هشة، هدنات مؤقتة، وسلام يدار من وراء الكاميرا لا من وراء الطاولة.
في الشرق الأوسط، كما في أوكرانيا وآسيا، استُخدم خطاب “صانع السلام” لتغطية سياسات القوة والانحياز، فكان القصف يُقدم كخطوة نحو الهدوء، والانسحاب كبرهان على الحكمة.
لكن أي سلام هذا الذي يُبنى على التهديد؟ وأي دبلوماسية تلك التي تتحرك بوحي التغريدة لا بحسابات المصالح الكبرى؟ لقد أصبحت أمريكا، في عهد ترامب، تبدو كمن يبيع صورة “السلام” بدل أن يصنعه فعلا. فهل تدرك واشنطن اليوم حجم الضرر الذي يلحق بسمعتها عندما تُختزل قوتها في نزوات رجل؟ وهل يمكن للعالم أن يثق في دبلوماسية تقاد بالغرور أكثر مما تقاد بالعقل؟