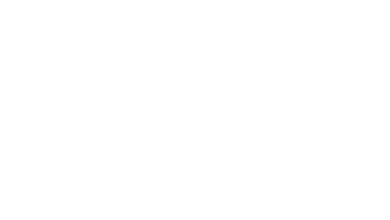“تهويد الأندلس”: تزوير التاريخ العريق لأغراض أيديولوجية حديثة(إغانطيوس غوتيريث دي تيران غوميث بينيتا)_1_
من المسلم به أن هناك روابط تاريخية وثقافية وحضارية عميقة تربط إسبانيا بالعالم العربي الإسلامي، تمتد أكثر من 2500 عام. وتُعد الأندلس محور هذه العلاقة المتجذرة، إذ تمثل نقطة التقاء حضاري شكّل الهوية المشتركة لكلا الطرفين.
يضع هذا الإرث الفريد إسبانيا في موقع استثنائي مقارنة ببقية الدول الأوروبية التي لم تشهد تفاعلًا مباشرًا ومستدامًا مع العرب والإسلام.
وإذا طُلب منا تلخيص هذه العلاقة في كلمة واحدة، فلن نجد أفضل من “الأندلس” بكل ما تحمله من دلالات تاريخية وأبعاد ثقافية لا تزال تثير الجدل والانقسام في الأوساط الإسبانية. فالذاكرة الأندلسية تحضر بقوة في كل نقاش حول الثقافة العربية في إسبانيا، حيث تحاول بعض الجهات استدعاء “القضية الأندلسية” عند مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالعرب والإسلام، لتقييم التجربة الأندلسية وفق معايير معاصرة، من دون أخذ سياقها التاريخي بالاعتبار.
شهدت العلاقات الإسبانية العربية مراحل متباينة بين التصادم والحوار، لا سيما بعد سقوط الأندلس في القرن الخامس عشر. فقد كان لهذه القضية تأثير عميق على مسار هذه العلاقة، سواء خلال المواجهات بين إسبانيا والإمبراطورية العثمانية في البحر الأبيض المتوسط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، أو في التفاعلات اللاحقة مع دول المغرب العربي. كما لعبت الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية دورًا محوريا في إنهاء الوجود الإسلامي في الأندلس، بدءًا بترحيل اليهود ثم فرض قوانين مجحفة على المسلمين، وصولًا إلى الطرد النهائي للموريسكيين عام 1615.
الأندلس.. هوية متنازع عليها تاريخيا
لم تقتصر انعكاسات الأندلس على العلاقة مع العرب والمسلمين فحسب، بل امتدت إلى الداخل الإسباني، إذ ظلت محل جدل بين النخب الثقافية منذ القرن التاسع عشر. فهناك تيار يرفض الحقبة الأندلسية باعتبارها انحرافًا عن الهوية القومية الإسبانية، في حين يرى آخرون أن هذا الإرث جزء لا يتجزأ من التراث الوطني الإسباني. وقد أدى هذا التباين إلى مطالبات بحماية المعالم الإسلامية والبحث في الإرث الأندلسي من منظور أكثر إنصافًا. ومن المفارقات أن بعض الأوساط العلمانية المناهضة للكنيسة الكاثوليكية كانت أكثر تقبلًا لهذا التراث مقارنة بالدوائر المحافظة المرتبطة بالمؤسسة الدينية.
أدت هذه التناقضات إلى “أدلجة” النقاش حول الأندلس، مما جعل تحليل الثقافة العربية في إسبانيا مسألة شائكة تخضع لتأويلات متضاربة، يغيب عنها المنهج العلمي الموضوعي. ويبرز التسامح والتعايش بين الأديان في ظل الحكم الإسلامي كإحدى القضايا المحورية في هذا الجدل، حيث قدمت بعض المبادرات صورة مثالية عن الأندلس باعتبارها نموذجًا “للحضارات الثلاث” -الإسلامية والمسيحية واليهودية- التي يُقال إنها ساهمت بشكل متساوٍ في بناء الحضارة الأندلسية.
في هذا السياق، ظهرت أطروحات تدّعي أن المسيحيين واليهود كانوا شركاء في إدارة الدولة الأندلسية، وأن الإنجازات الحضارية الكبرى تُعزى إلى مساهمات شخصيات وتيارات غير إسلامية. ورغم أن بعض الباحثين يربطون هذا التوجه بالسعي لتعزيز البعد المسيحي في الهوية الإسبانية، فإن هذه الرواية تتجاهل الواقع التاريخي. فالمصادر الأندلسية والعربية والمسيحية لم تشر إلى دور محوري لليهود في المجال السياسي أو الاجتماعي، إذ كانوا يعيشون في الأندلس كمجتمع منعزل يركز على شؤونه الاقتصادية، من دون أن يكون لهم تأثير يُذكر في رسم سياسات الدولة أو تشكيل مسارها الحضاري.
“غزو تهويدي” ممنهج في المدن الأندلسية
إننا نشهد في المدة الأخيرة نزعة متزايدة تهدف إلى تضخيم الإسهام اليهودي في حضارة الأندلس على حساب الدور الإسلامي، عبر إعادة تشكيل الذاكرة التاريخية لمنح اليهود مكانة لم تكن لهم في الواقع. وقد أخذت هذه النزعة منحى خطيرًا في العديد من المدن الأندلسية العريقة، حيث تشهد اجتياحًا ثقافيا منظمًا يثير قلق الأوساط الأكاديمية والثقافية والاجتماعية.
منذ سنوات قليلة، برزت محاولات متزايدة لإقناع البلديات والجهات الحكومية الإسبانية بضرورة “إحياء التراث اليهودي” تحت ذريعة إعادة الاعتبار لما يُعرف “بأبناء سفاراد” (يهود الأندلس) ودورهم في تشكيل الهوية الإسبانية الحديثة. وتحت هذا العنوان، تدفع بعض الجهات، بدعم من “اللوبي الداعم لإسرائيل”، نحو إعادة قراءة التاريخ الأندلسي برؤية تُسلط الضوء على الوجود اليهودي، في حين يجري تهميش الهوية الإسلامية للمدن الأندلسية، رغم أن معظم المعالم والبقايا الأثرية تشهد بوضوح على الطابع العربي الإسلامي لهذه الحواضر.
وقد أصبح من المألوف أن يصادف الزائر إلى المدن الأندلسية القديمة لافتات وإعلانات سياحية وتصريحات لمسؤولين محليين تتحدث بإسهاب عن “استثنائية” العنصر اليهودي، في حين يجري التقليل من الإرث الإسلامي لهذه المدن. والأمر لا يقتصر على الخطاب الرسمي فحسب، بل يمتد إلى الإهمال المتعمد للآثار الإسلامية الذي أدى إلى تدهور بعضها بسبب غياب الصيانة، بينما تُرمم بعض المواقع التي يُنسب إليها طابع يهودي رغم محدوديتها من حيث العدد والتأثير التاريخي.
- مدينة كاثيريس
من بين المدن التي تعكس هذه الظاهرة، تبرز مدينة كاثيريس (Cáceres) في إقليم إكستريمادورا، والتي كانت تُعرف في الأندلس باسم “قاصرش”. أسست هذه المدينة على أنقاض مستوطنة رومانية، لكنها اكتسبت أهميتها في العصر الإسلامي، خاصة بعد استيلاء الموحدين عليها في القرن الثاني عشر. ورغم أن المسلمين حكموا المدينة لما يقارب 5 قرون، وأقاموا فيها أسوارًا يبلغ طولها نحو 1200 متر، فإن الخطاب السياحي الحالي يضخم الدور اليهودي فيها، بينما يتم تجاهل البصمة الإسلامية التي أكدها العديد من الجغرافيين والمؤرخين العرب، مثل ابن حوقل والإدريسي وياقوت الحموي، والذين شددوا جميعًا على أن المدينة كانت عربية إسلامية بامتياز.
ورغم أن اسم Cáceres نفسه مشتق من الاسم العربي “قاصرش” (مشتق من كلمة “قصر”)، فإن البلدية المحلية تضع لافتات وإشارات توجه الزوار إلى ما يُسمى “بالمعالم اليهودية”، في حين تُترك المعالم الإسلامية عرضة للإهمال أو يُعاد استخدامها من دون الإشارة إلى أصلها الإسلامي. ويلاحظ الزوار غياب أي جهد لتعريف السياح بالتاريخ العربي للمدينة، مقابل الترويج الكثيف لرواية “الحارة اليهودية” و”الإرث السفاردي”.
- مدينة سيغوبيا
لا يختلف الأمر كثيرًا في مدينة سيغوبيا (شقوبية) الواقعة وسط إسبانيا، حيث تحظى الأحياء التي يُنسب إليها إرث يهودي باهتمام كبير، في حين يُطمس الإرث العربي الإسلامي للمدينة، رغم أن المسلمين فتحوها في القرن الثامن للميلاد وبقوا فيها حتى أواخر القرن الحادي عشر، عندما استولى عليها الملك القشتالي ألفونسو السادس. وبينما تُخصص البلدية مسارات سياحية متكاملة لاستكشاف “الأحياء اليهودية”، فإن الإشارة إلى الحقبة الإسلامية تكون سطحية ومحدودة للغاية، كأن المدينة لم تكن جزءًا من الأندلس لقرون طويلة.
- مدينة ألميريا
تتجلى هذه المحاولات أيضًا في مدينة ألميريا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي شهدت تحركًا ملحوظًا من قبل أكاديميين ومثقفين محليين لمواجهة محاولات طمس هويتها العربية الإسلامية. ومن أبرز هؤلاء الباحث جرجس ليرولا أستاذ التاريخ والأدب العربي الأندلسي في جامعة ألميريا الذي قاد جهودًا لمواجهة عمليات “التهويد الثقافي” التي تتبناها السلطات المحلية بالتعاون مع جهات دولية تسعى إلى إعادة رسم خريطة الإرث الأندلسي وفق أجندات محددة، كما أدان مثقفون عرب كالشاعر والمترجم جعفر الوني في كتاباته هذه الظاهرة الخطيرة.