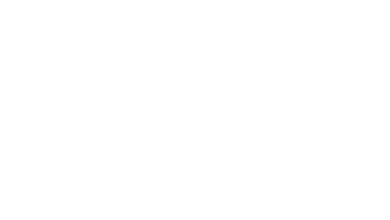تأملات في الأمة والدولة والمعارضة: (إدريس مقبول)
لما ظهرت عبارة (الدولة الأمة) كانت تتماهى مع (دولة الرفاه) من جهة، و(الدولة القومية) من جهة ثانية، وقد ضغطت السياقات الدموية والحروب في أوربا من أجل ولادة ما يسمى (الدولة الأمة)، فكان من نتائجها صعود نزعة التوحيد والصهر، ولو بالعنف، والإبادة ومصادرة التعددية بكافة أشكالها، كما نقرأ عند البريطاني إريك هوبسباوم في كتابه (عصر الامبراطوريات)..
هناك سياق آخر لمناقشات (الدولة الأمة) ارتبط بحقوق الإنسان وبالقوميات المتعددة داخل الدولة الواحدة، إذ نشطت دعاوى إيديولوجية وفلسفية تشترط تأسيس وبناء وحماية (الدول الأمم) لضمان حقوق الإنسان وبخاصة العنصر اليهودي وأزمته التي تم حلها عبر الأطروحة الصهيونية على حساب الشعب الفلسطيني، وهو ما ناقشته حنة أرندت في (أصول التوتاليتارية).
أظهرت الخبرة التاريخية أن (الدولة الأمة) قد يرافقها غرور خَطِر يدفع في اتجاه نفي باقي القوميات المختلفة والاتجاهات الثقافية المبايِنَة للقومية المركزية التي تتماهى مع الدولة، نصبح إزاء عنف واستغلال واحتكار للصلاحيات والوظائف، في مقابل تجريد بقية العناصر من وطنيتهم وانتمائهم بل وإنسانيتهم وجنسهم.
لا ننسى أن نفي كل أشكال التعددية سيأخذ صيغا مختلفة مرونة وتشددا، بين من يبحث عن أكثر من مشترك، وبين من يستبعد كل القواسم لصالح قاسم جذري أو محوري تقوم عليه (الدولة الأمة)، ويكون أساسَ قوتها وتلاحمها، مثلما دعا الألماني يوهان هيردر حين تحدث عن الثقافة المشتركة، القائمة على وحدة اللسان أكثر من قيامها على وحدة الدين أو المعتقدات.. المهم أنه جرى في التاريخ باسم الوحدة والتوحيد عمليات قيصرية مؤلمة، ستظل دروسا مفتوحة للتأمل.
فيما يتعلق بالأمة كما وردت في القرآن الكريم، نحن في سياق تداولي مختلف، لهذا نجد أن من بين معاني (الأمة) أنها قوة الجماعة، ولهذا حين قال الحق سبحانه “وأن هذه أمتكم أمة واحدة” فهو يشير إلى القوة الجماعية(الموحدة) ولا يشير إلى كيان سياسي أو دولة..
القرآن يتحدث عن كيان جماعي أو مجتمعي له وظائف من أجل حمايته من التحلل، يجوز لنا حينها من منظور الفلسفة السياسية أن نتحدث عن قوة الأمة في بناء التنمية أو لنقل بلسان القرآن مساهمة المجتمع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا تمارس الأمة السياسة بمفهومها الحيوي المتفاعل مع ما يجري في الواقع كتجسيد للإيمان، تفاعلا مع ما ينفع الإنسان وما يضره. لننتبه أن القرآن يُحمل المسؤولية للجماعة إذا هي فرطت في وظيفتها رغم أن الفعل الجريمة قد تكون فردية، ففي قصة ناقة صالح، كان الذي عقر الناقة واحد، لكن القرآن تحدث عنهم جميعا(فعقروا الناقة) ولهذا استحقوا جميعا العقاب(فدمدم عليهم ربهم).
نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تغيير المنكر ومقاومته جزءا من إيمان الأمة وفاعليتها، وليس مجرد مقتضى من مقتضياته، وقوةُ الإيمان وضعفُه وكماله ونقصه، ليس مما يختص به الأمراء والعلماء، بل هو مما يهم كل عناصر الأمة، ولهذا نجد الحديثين في صحيح مسلم ضمن أبواب الإيمان، وتحت هذا العنوان المعبر(باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان).
وفي حديث السفينة الذي يصور لنا كيف ينشأ (الفكر الأخرق) في الأمة وفي المجتمع على حد تعبير الأستاذ سيف الدين عبد الفتاح، وذلك من خلال صمت الأمة عن الانحرافات التي لا تمس حياة الناس الخاصة بل حياتهم(سفينتهم) الجماعية. (فإن تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا)..فيه تنبيه على السلبية واللامبالاة، كيف يمكن أن تكون أحد أخطر عوامل تفتيت الأمة وانهيارها.
الأمة كما أتصورها وأفهمها هي ثقافة حية، وليست مجرد كم عددي سلبي، والخبرة التاريخية تدلنا على أن الثقافة الحية وهي ثقافة الأمة تظل مهمشة وجانبية التأثير ما لم تتحول إلى سلوك وإلى مشاركة وفعل وإلى تغيير، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد هذه الوسائل التي تعمق فاعلية الثقافة وتقوي حضورها الحي في كينونة الأمة كحضور قيمي وثقافي قبل أي شيء آخر.
لابد أن نذكر أن الأمة الإسلامية كما تجسدت في التاريخ لم توجد في صورة واحدة، فقد عرفت تموجات بحسب تشبعها بقيم القرآن، فقد كانت على العهد النبوي نموذجا فيما أرى للتنوع والتعايش الذي جسدته صحيفة المدينة، وهي وثيقة سياسية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أن غالبية المجتمع حينها كانت من المسلمين الموحدين، لكنها ضربت مثلا متقدما بالنظر لزمنها في التعايش المبني على التعاقد، فقد كان فيها الجميع مواطنا بمعنى من المعاني، للجميع حرية الاعتقاد دون إجبار أو إكراه على عقيدة معينة، لكن الأقليات المسيحية واليهودية والمشركة أيضا حصلت على اعتراف رسمي بحقها في الوجود داخل المجموع/الأمة شريطة التزامها بما تُلزمها واجبات المواطنة كالمساهمة المالية في خزينة الدولة للقادرين؛ من أداء الضرائب (وهي ما عُرف بالجزية) والتي كانت مقابلا لما يساهم به المسلمون من زكاة، لأن الزكاة لم تكن مفروضة على المواطنين غير المسلمين وإن كان يستفيد منها غير المسلمين كما هو رأي بعض مشاهير الفقهاء كعمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وجابر لارتباطها بالهشاشة والاحتياج والفقر في صفوف المواطنين بالدرجة الأولى، وهي مسألة غاية في الأهمية لنفهم سبق العقل الإسلامي إلى تأسيس فقه المواطنة، وقد فصلنا في المسألة في كتابنا عن(الزكاة: سؤال التنمية والعدالة التوزيعة). كما كان على الجميع ممن يشملهم لفظ الأمة؛ مسلمين وغير مسلمين مهمة الدفاع عن أمن المجتمع وحمايته. وقد كان فيه الجميع كما هو معلوم خاضعا لقيادة وإدارة سياسية واحدة وموحدة وتحظى بالإجماع.
طبعا كانت الدولة بسيطة لأن المجتمع حينها بسيط، وإدارتها لم تكن بحاجة إلى وضع قوانين كثيرة، فقد كان وجود النبي بينهم قيادة ومثلا أعلى ومرجعا استشاريا لكثير من احتياجاتهم وأسئلتهم، لكن مع تقدم السنين توسعت الدولة ومعها توسعت الأمة، لكن وقع في الفقه انتكاسة، فالفقه الذي يؤطر إدارتها لم يتقدم إلا بما يناسب زمن الإمبراطوريات الكبرى وإرادتها، فانسلخت الأمة شيئا فشيئا في موضوع إدارتها السياسية عن روح الشورى والتشاور، وتم التمكين لحكم العصبيات والطوائف والعشائر، وصار لحكم المتغلب بالسيف والعصابات الكلمة العليا.
نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يختار للأمة من يدير شؤونها؛ أي لم يشأ أن يعين السلطة السياسية التي تحكم الأمة بعده، وترك الأمر ليقع في دائرة المشورة بعده، أي للأخذ والرد وللترجيح والعقل وللتقدير والمصلحة، لأن أي توجيه منه صلى الله عليه وسلم سيعتبر تشريعا بعده وانتصارا لعائلة او قبيلة أو جنس، وهو ما يناقض جوهر رسالة الإسلام، تركَ الرسول عليه السلام الأمر للأمة لتستهدي بقيم القرآن في اختيار من تراه مناسبا، وليبقى الأمر دائرا في دائرة المصالح المرسلة العليا وليس دائرة العقائد، غير أن المسلمين سنة وشيعة انحرفت بوصلتهم مرة أخرى، فنظروا لمبحث الإمامة من باب الكلام والعقائد، فوسَّعوا الخلاف.
لم تكن الأمة محتاجة لوصية، لأن الأمة حين ترشُد، وقد تركها النبي راشدة، تتحمل مسؤولية اختيارها سواء كان صحيحا أم خاطئا.والأمة الراشدة لا تعني أنها معصومة، وإنما تعني النضج فقط، والنضج في مقابل القصور، مثلما نقول شخص ناضج في مقابل شخص قاصر، والرشد لا يعني العصمة من الخطأ. وما يستدل به البعض من حديث (ما اجتمعت امتي على ضىلالة) كما ورد في بعض متون السنة حديث لا يصح وفي طرق روايته كلام نبه عليه النووي في شرحه على مسلم.
طبعا للأمة أن تصحح أخطاء اختيارها ما دام الأمر دائرا بين الصواب والخطأ، وبين الوفاء بمتطلبات الأمة والتخلف عنها، لكن التجربة التاريخية أثبتت أن الأمر لم يكن كما نتصوره اليوم في معالجة القضايا الخلافية، وإن كان هناك تحزبات وليس أحزابا بالمعنى العصري للكلمة، كانت الأمور تُدبر في العادة بطريقة فيها قدر لابأس به من العنف والدموية والروح الجاهلية، ولهذا وجدنا ثلاثة خلفاء راشدين ينتهي حكمهم في وقت مبكر من تاريخ الإسلام بالاغتيال، وهو أسلوب بعيد عن قيم الشرعة والمنهاج قريب من قيم الجاهلية وأساليب المافيات وقطاع الطرق. يجب أن نقر بأن نظام الخلافة الراشدة الأول ليس مثاليا، فرغم أنه نظام غني قيميا بما جسدته القيادة أخلاقيا مع بعض الاستثناءات التي كشفت ضعف الخبرة السياسية لدى بعضهم، لكنه نظام بسيط للغاية في شكله وأدواته، ولم تكن هناك أدوات لحمايته، كما أنه يناسب طبيعة أمة في بداية تشكل إطارها السياسي، ولهذا اختارت من يحكمها دون ان تحدد له سنوات الحكم، بل قبلت أن تنتهي حياته بالاغتيال من معارضته في ظل ظروف يلفها التنازع والغموض.
اليوم نحن أمام الديمقراطية كشكل متقدم أبدعه العقل السياسي في إدارة شؤون المجتمعات والأمم، شكل أو لنقل أشكال تطورت وما تزال عبر تاريخ من صراع البشر وتدافعهم وبحثهم عن الأنسب بعيدا عن أسلوب الاغتيالات والتصفيات، وإن كان الأمر لا يعني النهاية التامة لاغتيال الرؤساء والحكام حتى في أقوى الدول(جون كينيدي مثلا وابراهام لينكون قبله في القرن التاسع عشر)، لأن هذا التفكير مرتبط إما بظروف الحروب الأهلية أو بالمافيات وهي موجودة على كل حال لكن الظاهرة محدودة.
قلت: رغم أننا لسنا أمام صيغة ديمقراطية واحدة مقفلة، إلا أن ميزة النظام الديمقراطي أنه نظام يسمح بالمساءلة والمحاسبة على حسب المسؤولية، وهو نظام يتحرك بدينامية الحكم والمعارضة وتنافسهما بسلمية في إطار القانون.
كما أن احترام المواعيد جزء من بنية النظام الديمقراطي التكوينية، وهو ما لا نجده في نظام الخلافة كما مر تاريخيا، تحديد المُدد هي ما يرسم إيقاع العمل الحكومي، والأصل في المواعيد أنها تقع فيها المحاسبة وعرض نتائج الحكم وبناء موقف جديد يمدد أو يلغي وكالة الأمة لمن يحكمها في شخص النواب والمؤسسات الدستورية، واحترام المواعيد الموقوتة سببٌ موجب لإعطاء الفرصة كاملة لمن يحكم قبل محاسبته بدل اختيار منحدرات الانقلابات والاضطرابات المستمرة التي تُعَطِّلُ كل بناء، هذا فضلا عن مزية أخرى وهي التحرز عمليا مما يتسرب لممارس السلطة من استمراء الخلود، وهو وضع يُعَقِّد مهمة أي إصلاح لاصطدامه بشهوات الخلود التي تسكن مجانين الحكم اقتباسا من رواية الأستاذ بنسالم حميش(مجنون الحكم).
في الواقع هناك “جنون السياسة” و”مجانين السياسة” و”جنون السياسة” هو متلازمة تصيب عشاق الكراسي سواء كانوا حكاما أو معارضين، ولا يسلم منها إلا من وعى خطورة البقاء طويلا على رأس الناس دونما حرج، كيفما كان هؤلاء الناس، مصفقين أو غاضبين. كان عالم الاجتماع الإيطالي روبرت ميشلز يتكلم عن “المرضى السياسيين” أثناء تطويره للقانون الحديدي لحكم الأقلية سواء في الدولة أو في الأحزاب موالية أو معارضة، فكما أن هناك مرضى بالحكم هناك مرضى بالمعارضة، وكلاهما مؤذ للنفس الإنسانية، ومضر بالاجتماع الإنساني حين يتحول إلى مجرد إدمان، لأنه يعكس ضعفا شديدا في نمو القدرة على التحكم في الدوافع في منطقة الوعي كما يقول عالم الاجتماع ورائد علم النفس السياسي الألماني تيودور أدورنو..يجب أن لا تصبح المعارضة مسكن الإنسان الأبدي، يورث جينات الغضب للأجيال اللاحقة مهما كانت ظروفها، طبعا أنا لا أومن بالجينوبوليتكس بعد، مثلما لا يجب أن يسجن الإنسان نفسه في دائرة السلطة والحكم. دائما هناك أكثر من سبب لنُغَيِّر أنفسنا ونغير العالم من حولنا، ولنغير أساليب المعارضة والإدارة على حد سواء..هناك يقين وحيد نعرفه من خلال دراسات التوقع المستقبلي وهو التغيير المستمر..من هنا تأتي أهمية فكرة (الموت) و(الآخرة) كفكرة جوهرية تمنع استرسالنا الوهمي في التعلق المرضي بأي شيء أو أي شخص من عالم الأشياء أو عالم الأشخاص في هذه الحياة، لان مبدأ الفناء يُطوق وجودنا فـ(كل من عليها فان)، كان هيدجر يقول بأن الوجود هو بطبعه وجود لفناء أو وجود للموت، فبمجرد أن يولد الإنسان يكون ناضجا وجاهزا للموت ، صحيح أننا خُلقنا للخلود، لكن ليس هنا، بل هناك. هذا التصور يدفع في اتجاه اختيار التغير والتغيير كمبدأ دافع في العادات كما في العبادات.
إذا عدنا للمعارضة، فرأيي ليس موقفا جذريا معاديا للمعارضة، ولكنه نقد موضعي لسيكولوجيا مرضية يمكن أن تصبح غطاء لحالة اكتئاب سياسي سوداوي لا يعجبه أي شيء، أما المعارضة كمؤشر على التوازن في أي نظام سياسي ديمقراطي محترم، فإننا نعتقد أن دولة خالية من المعارضة هي دولة نزوات. دولة تحكمها الأمراض المزمنة التي تجمع في أقبيتها الغموض وفي دهاليزها الخوف.
في غياب المعارضة كما يقول محمد الغزالي ينشأ وحش الاستبداد مهما كانت الظروف والملابسات، ويتصاعد التضايق من الآراء والتبرم من الاختلاف الذي حرصت الديمقراطية أن تشجع المعارض فيها أن يقول بملء فمه “لا”، حين وفرت الكرامة الفردية للمؤيد والمعارض على حد سواء ، لهذا لا يمكن تفسير “اللون الواحد” والحزب الواحد” و”الصوت الواحد” غير مرايا وتعبيرات مختلفة لشيء واحد هو”الاستبداد”.