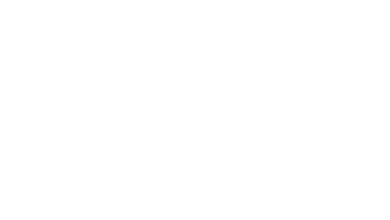دور الدراسات ما بعد الكولونيالية والحراك النسائي العالمي في تفعيل معركة الحرية النسائية المغربية:(إبراهيم القادري بوتشيش)
لا سبيل لإنكار انعكاسات الدراسات ما بعد الكولونيالية وما بعد الحداثية في تدويل قضية المرأة المغربية، واعتبارها من العوامل الخارجية التي ظهرت خطة إدماج المرأة في سياقها. فلم يكن من قبيل الصدفة أن تفرز هذه التوجهات العلمية الدولية الجديدة ذات النزعة النقدية ما بات يعرف بالفلسفة النسوية Feminism التي خرجت من العباءة الاجتماعية لتتمدّد في نسيج الإبستيمولوجيا وفلسفة العلم، بهدف إحداث رجّة في المركزية الذكورية Androcentrism، والقطيعة مع مبدأ مطابقة الخبرة الإنسانية بالخبرة الذكورية، وخلخلة التصنيفات البشرية إلى ذكورية وأنثوية، والارتقاء المتناغم الذي يقلب ما هو مألوف، ويسعى إلى صيغة أكثر توازنا وعدلا[1].
نحسب أن ثقافة ما بعد الحداثة وما بعد الكولونيالية فتحت بابا جديدا دلف منه ملف الحرية النسائية المغربية نحو الأفق العالمي، متجاوزا البُعْد الوطني، نحو نساء العالم الثالث والثقافات غير الأوروبية. وارتقت هذه الثقافة مع “سيمون دي بوفوار” وغيرها من رائدات الدراسات النسوية مدارج التنظير، لتلج إلى عتبة السؤال الإبستيمولوجي وفلسفة العلم[2]. كما أنها دخلت دهاليز معرفية جديدة مع التطور الفكري النوعي الذي شهده النظام المعرفي الفرنسي، ممثلا في الفيلسوف جيل دولوز، وميشال فوكو، وجاك دريدا الذين تحولت معهم المسألة النسوية إلى “مركزية العقل القضيبي “Phallogoncentrism المعبّرة عن فظاظة العقلية الذكورية. وحسبنا أن هؤلاء المفكرين أسهموا في تجديد أسلوب استثمار المقولات الفلسفية الكبرى، ومنحوا رواد الحرية النسائية مفتاحا جديدا لقراءة تفكيكية لنصوص الفلسفة الغربية الكاشفة لأبنية التسلط الذكوري والإكراه القسري [3].
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المعالم الكبرى للحركة النسوية العالمية – في موجتهاالثانية-بدأت مع نهاية المرحلة الاستعمارية، وأن الاستعمار شحن الفلسفة الذكورية بطاقة قوية، يتبيّن كيف أن الفلسفة النسوية استغلت معطيات مرحلة ما بعد الاستعمار، ووظفت خلالها مناهج جديدة لمراجعة الأبنية الفكرية الاستعمارية في إنتاج المعرفة، والكشف عن تسيّد التراتبية الهرمية الذكورية التي حرصت على تكريس دونية المرأة. ومن ثمّ فإننا نشاطر الرأي القائل بأن مقاومة الاستعمار، ونقد الثقافة الإمبريالية، سارا في خط موازي مع تحرير المرأة من العنصرية النسوية السوداء، ومن التسلط الذكوري في الوقت ذاته[4].وهذا ما يفسّر صدور الكتاب الرائد الذي حبّرته ساندرا هاردنج، والمتمحور حول سؤال العلم في النسوية، ودوره في جعل استبعاد المركزية الذكورية من العلم، طريقا لاستبعاد العنصرية والاستعمارية والرأسمالية[5].
ومع أن الفلسفة النسوية تمتد بجذورها إلى القرن 19م، وخصوصا مع الأب الروحي للفكر الليبرالي جون ستيوارت ملْ صاحب كتاب “استعباد النساء”، وزوجته “هاربيت” مؤلفة كتاب ” تحرير النساء”، فإنها تغذت بمقولات التيار الاشتراكي لتطوير أفكارها ونظرياتها [6]. بيد أن عودها لم ّيصلب إلا مع سبعينيات القرن الماضي، ليزداد تجدرا ومتانة ونضوجا تنظيرا وممارسة مع الألفية الثالثة[7] .
ودخل البحث الأكاديمي على المستوى الجامعي العالمي بدوره ليعزّز مكاسب المرأة الحقوقية، والسير بها في آفاق أكثر رحابة، حيث باتت الدراسات النسائية تحتل مكانة في الجامعات العالمية. ولا غرو فقد تأسست في الجامعات الأمريكية مجموعة من الأقسام والمختبرات الخاصة بالدراسات النسائية. و تمّ في فرنسا تنظيم أول درس حول النساء سنة 1973 بجامعة باريس7 ، تحت إشراف السيدة ميشيل بيرو[8].
وبدورها، لم تخل الساحة العربية من مساجلات أكاديمية وأبحاث تتسم بجرأة الطرح، وخلخلة المفاهيم الكلاسيكية السائدة حول المرأة. تجسد ذلك في كتابات نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي ومحمد الطالبي وغيرهم . وذهبت هذه الدراسات إلى إبراز مكانة المرأة في النصوص القرآنية والحديثية، وفي منظومة التراث الإسلامي، وقدمت تأويلا مقاصدياً للآيات القرآنية الخاصة بالنساء. ولم يكن صدفة أن تصدر هذه الكتابات في ثمانينيات القرن الماضي وتنتعش أكثر في التسعينيات[9] ، وهي العشرية الحاسمة التي ظهرت فيها الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. ولعلّ هذا الزخم الأكاديمي والنضالي للجمعيات النسائية على المستوى الأكاديمي العالمي ما جعل النزعة التحريرية تتجذر وتتوغل في أعماق المجتمعات، وضمنها المجتمع المغربي، بل تتحول إلى فلسفة تحررية ذات أبعاد متطرفة أحيانا، جعلت من الذكورة خصمها الأساسي.
في هذا المنحى، يمكن النظر إلى تيار اللاندسكيب Landscape ذي النـزعة التحريرية لنساء العالم من الهيمنة الذكورية[10]، وهو تيار عالمي ينتقد بشدة المظهر الحضاري لسطح الأرض الذي يكرّس الذكورية، ويهمش الوظيفة الحضارية للمرأة، ويطمس منجزها الحضاري تحت طغيان وتحكّم العقلية الذكورية، ويدعو إلى تغييره وتعديله بأسلوب يبرز أدوار المرأة، باعتبارها شريكا حضاريا، ومساهما في الإنتاج والبناء العلمي. ويمكن اختزال أهداف حراك اللاندسكيب في مسعيين أساسيين: إعادة الاعتبار للمنجز الحضاري النسوي وإبرازه، ونزع الاعتراف به، ثم إعادة تأسيس سطح الأرض الحضاري بعيدا عن الاحتكار الذكوري له.
وبموازاة مع هذا التيار النسوي العالمي، برز إلى الوجود في ثمانينيات القرن العشرين حراك نسائي متميز، عرف بالنسوية الإسلامية التأويلية، داخل المجتمعات الإسلامية وحتى المجتمعات الغربية التي توجد بها جاليات إسلامية. وهو تيار يدعو إلى إعادة قراءة النصوص الدينية الخاصة بالنساء قراءة متحررة من سطوة الفقه التقليدي. ولم يكن صدفة أن ينتعش هذا التيار في تسعينيات القرن الماضي التي تزامنت مع ظهور خطة العمل الوطني لإدماج المرأة في التنمية.
تشكلت هذه الحركة عبر فضاء جغرافي إسلامي امتد عبر إيران التي لعبت فيها صحيفة “زنان” دورا بارزا في طرح الفكرة، وجنوب إفريقيا التي ترعرعت فيها ونمت، خصوصا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، ثمّ أمريكا الشمالية التي تظافرت فيها جهود كوكبة من النساء المسلمات المهاجرات لطرح منظورات جديدة للجنوسة[11].
سطّرت هذه الحركة أهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة داخل المجتمع الإسلامي، والدفاع عن حقوق المرأة من المنظومة الإسلامية ذاتها. ودعت إلى تجديد فهم النصوص القرآنية الخاصة بالنساء بمنظور كلي شمولي وليس تجزيئي وتسطيحي، لفهم دلالات مقاصد الشرع الإلهي، ومناهضة فقه الذكورة الذي أنتج عقلا بطريركيا غيّب أصوات النساء، ووضعهن في موقع المخلوقات القاصرات. كما نادت هذه الحركة النسوية بقراءة نصوص الوحي قراءة متحررة من الفهم التقليدي، بالارتكاز على السياق التاريخي والأنثروبولوجي الثقافي، والاستناد إلى وعي هرمينوطيقي لكسر شوكة الفهم البطريركي للدين، بما يضمن المساواة بين الجنسين.
من المنطقي في سياق التفاعلات الثقافية العالمية أن تتأثر الحركات النسائية المغربية بنماذج من الفلسفة النسوية ونظرياتها المتوالدة باستمرار، وأن تشكل الموجات التحررية الجديدة مشتلا لنمو الحراك النسائي المغربي المطالب بحرية المرأة، وإثبات ذاتها ودورها وقدراتها وملكاتها، وكسر عظم السلطة الأبوية وقيّمها، ومزج المطالب الحقوقية النسائية بالعلوم، والتوليف بين النظرية والواقع والمعيش اليومي، في تركيب جدلي. وهذا ما يفسّر اعتماد خطة إدماج المرأة في التنمية على بعض عناصر الفلسفة النسوية، وتدعيم الآراء والمقترحات الواردة فيه ببعض الدراسات العلمية والإحصائيات.
تلك باختصار الخطوط الكبرى للسياقين الداخلي والخارجي اللذين أنتجا خطاب خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وتبلورت من خلالهما مفاهيم جديدة لحقوق المرأة. ولعل أهم الخلاصات التي يمكن أن نضع عليها الإصبع، تتمثل في أن مشروع “خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” يجسد أنموذجا لانتقال القضايا الوطنية من دائرة اختصاص السيادة الوطنية، إلى دائرة اختصاص السيادة الدولية التي أصبحت تفرض نمطها الثقافي، مقابل تفتيت السيادة الوطنية. بل إن هذا التنميط العولمي الكاسح بدأ يفرز أنماطا ذهنية جديدة، ووعيا مغايرا وجسورا، ومفاهيم جديدة غير مألوفة” في دائرة الموروث الإسلامي، أضيفت إلى قاموس الحرية والمسألة الحقوقية للمرأة التي كانت تقتصر على بعض المطالب السطحية، وهو ما سنقف عند خطوطه الكبرى في الفصل الموالي الذي سنقدم فيه مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.
[1][1] الخولي، يمني طريف، النسوية وفلسفة العلم، مؤسسة هنداوي، سي أي سي، المملكة المتحدة 2018، ص8.
[2] المرجع نفسه، ص 27، 28، 37، وخاصة كتاب سيمون دي بوفوار ” الجنس الثاني” The Second Sexالصادر سنة 1948 والذي وصف بأنه إنجيل الحركات النسائية العالمية.
[3]المرجع نفسه، ص 41- 42.
[4] الخولي، النسوية….م. س، ص 65- 66.
[5] Harding, Sandra, The Question of Science in Feminism,Cornell University Press, Ithaca & London, 1986, p 18,22.
مذكور عند: الخولي، النسوية… م.س،ص 68.
[6]من بين المؤلفات النسائية البارزة ذات النزعة الاشتراكية كتاب نانسي هارتسوك:
Nancy C. M. Hartsock, “The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism”, in: Harding, Feminism and Methodology, Indiana University Press, Blooming-.ton, 1987. pp. 157–180.
مذكور في المرجع نفسه، ص 75، هامش 38
[7]المرجع نفسه، ص11، 20.
[8]حبيدة، محمد، “البحث في تاريخ النساء، تجربة الغرب نموذجا”، مجلة أمل، العدد 13- 14، سنة 1998، ص 125- 126.
[9] صدر كتاب الطالبي، محمد : عيال الله، أفكار جديدة عن علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين ، عن دار سراس للنشر تونس سنة 1992. وكان قبل ذلك قد صدر للكاتبة فاطمة المرنيسي كتاب:
Le harem politique, le prophète et les femmes, ed. Albin Michel, 1987 .
[10]عن تيار اللاندسكيب، ينظر:
–Dowler, Lorraine, (Sous la direction de), Gender and landscape: renegotiating morality and space, Collection Routlege international Studies of Women and place, London 2004.
[11] جدعان، خارج السرب…، م.س، ص 76- 77.