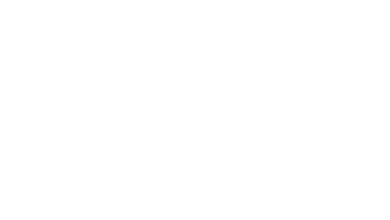التنصل الأخلاقي: كيف فشل العالم في إيقاف تدمير غزة؟ (ساري حنفي)
بصفته أنثروبولوجيًا، انتبه ديدييه فاسان من أمد طويل لما يُسمى في الأنثروبولوجيا بـ “الانعطافة الأخلاقية” ethical turn. انسجامًا مع سوسيولوجيا الأخلاق والسياسة عند لوك بولتانكسي، تشير هذه الانعطافة – ولا سيما منذ مطلع الألفية – إلى تحوّل نحو دراسة الحياة الأخلاقية ليس فقط من خلال المعايير والبُنى، بل كذلك كتجربة معاشة: كيف يفكّر الناس أخلاقيًا، ويجابهون المعضلات، ويصوغون القيم في سياقات الحياة اليومية. ومع ذلك، فإن فاسان يذهب أبعد من ذلك؛ إذ تتبّع أنثروبولوجياه باستمرار التشابك بين الأخلاق من جهة، والسلطة والمؤسسات من جهة أخرى. ففي أعماله مثل “العقل الإنساني” (2012) و”فرض النظام” (2013)، حلّل كيف تعمل المفردات الأخلاقية – كالرحمة compassion والكرامة والإنسانية humanitarianism – في ميادين مثل الشرطة والهجرة، وكيف أنّ الأفعال “الخيّرة” تُفرغ من مضمونها بسبب البُنى التي توصلها. هكذا يمزج نهجه بين النقد الأخلاقي (المسؤولية الأخلاقية) والتحليل السياسي (الظلم البنيوي)، كاشفًا كيف يمكن أن تخفي الادعاءات الأخلاقية علاقات قوى، ما يجعل مقاربته في آن واحد أخلاقية وسياسية.
في كتابه “هزيمة غريبة: حول القبول بسحق غزة” (منشورات لا ديكوفرت، 2024) [1] والمترجم إلى الإنكليزية بعنوان “التنصّل الأخلاقي: كيف فشل العالم في إيقاف تدمير غزة؟” (فيرسو، 2025)[2]،يطبّق فاسان هذه العدسة نفسها: فيفحص ليس فقط ما فُعل بغزة، بل أيضًا كيف سمح الخطاب الأخلاقي الغربي بحدوث ذلك. فهو يصف اللامبالاة العالمية كنوع من التخلي الجماعي عن المسؤولية الأخلاقية. الكتاب ليس عن السياسة وحدها، بل عن فشل الواجب الإنساني الذي تُلحّ عليه الانعطافة الأخلاقية في الأنثروبولوجيا.

يُنشئ فاسان ما يشبه الأرشيف، موثِّقًا الأشهر الستة الأولى التي تلت السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولا سيما كيف واجهت الأصوات المعارضة – من طلاب وناشطين وبعض المثقفين – القمع. غايته أن يحفظ أدلة المقاومة في وجه إسكات معاناة الفلسطينيين. والأهم أنّ فاسان يقدّم في الواجهة أصوات الباحثين الفلسطينيين (عبد الجواد عمر، طارق بقعوني)، والكتّاب، والشعراء (وخاصة رفعت العرعير)، ليمنحهم صوتًا حيث يعمد الخطاب الغربي إلى محوهم.
القبول السلبي والإيجابي
يميّز فاسان بين القبول السلبي (الامتناع عن المعارضة، وبالتالي التسهيل) والقبول الإيجابي (الدعم ومنح الشرعية). ويوجّه نقدًا لاذعًا إلى الحكومات الغربية والمثقفين ووسائل الإعلام بسبب قبولهم السلبي (مثل شلل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) أو قبولهم/ تواطؤهم الإيجابي (تبرير أفعال إسرائيل بوصفها “دفاعًا عن النفس”، بل وبيع الأسلحة لها). وهذا، كما يؤكد فاسان، يمثّل انهيارًا عميقًا للمسؤولية الأخلاقية.
من أقوى أقسام الكتاب تلك التي تتناول اللغة. يبيّن فاسان كيف جرى التلاعب باللغة بشكل منهجي، وكيف أصبحت الدعوات إلى وقف معاناة المدنيين تُوصم بـ “معاداة السامية”: فمفردات مثل “إبادة جماعية” و”تطهير عرقي” منعت، والعمليات العسكرية تُطهَّر بلغة مثل “ردود” (ripostes) في ما يُسمّى “الحرب بين إسرائيل وحماس”، بل يمنع ذكر كلمة “فلسطين”. لقد باتت الرقابة أو الرقابة الذاتية أمرًا مطبّعًا في الخطاب العام. ويوثّق فاسان كيف أن صحيفة “نيويورك تايمز”، على سبيل المثال، أوصت صحافييها بعدم استخدام تعابير مثل “إبادة جماعية” أو “تطهير عرقي”، أو حتى “فلسطين”، “مخيمات اللاجئين”، و”الأراضي المحتلة”، وطالبتهم بتجنّب الكلمات “العاطفية” مثل “مجزرة” أو “ذبح”.
بالنسبة لفاسان، كما لدى اللغوي الفلسطيني ياسر سليمان معالي (2023) في كتابه الرائع “اللغة العربية في ساحات الوغى: دراسة في الأيديولوجيا والقلق والإرهاب”، لا يتعلق الأمر بمجرد دلالات لغوية، بل هو ضبط للفكر، ويترافق ذلك مع حملات التنديد وتجريم الطلاب والأساتذة والمواطنين: “إن استعادة حرية التعبير، والمطالبة بالنقاش حول الكلمات، والدفاع عن اللغة… قد يجعل العالم أكثر قابلية للفهم”. وهذا يعني أيضًا استعادة التاريخ: فاعتبار هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر مذبحة معادية للسامية أو مقاومة يتوقف على ما إذا سُمِح للتاريخ بأن يدخل في التفسير. ويستشهد فاسان برواية جورج أورويل “1984” بأن “من يسيطر على الماضي يسيطر على المستقبل. ومن يسيطر على الحاضر يسيطر على الماضي”. يُطلب منا إذًا تحليل الأحداث والظواهر الاجتماعية من دون أن نُسقِط عليها بعدًا سوسيولوجيًا أو تاريخيًا. كما يستعيد فاسان كلمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بشأن الإرهاب: “عندما تبدأ بمحاولة تفسير ما لا يُفسَّر، فإنك تتهيأ لتبرير ما لا يُبرَّر” (ص 19).
ويرى فاسان أنّ مجرد الحديث عن “أزمة إنسانية” هو تهرّب من تسمية الأشياء بأسمائها، إذ يتم الاكتفاء بوصف النتائج من دون ذكر الأسباب؛ وبذلك يجري تبرير المطالبة بممرات أو هدَن إنسانية، مع السماح بمواصلة قصف المدنيين، في مظهر من مظاهر “الالتزام” بالقانون الدولي. واليوم، يقتصر طلب العديد من القادة السياسيين الغربيين من إسرائيل على السماح بدخول الغذاء إلى قطاع غزة. وما يحلّله فاسان ليس ظاهرة جديدة، فقد سبق للمفكر الإسرائيلي عدي أوفير أن دان “سياسات الكرثنة” (politics of catastrophization) باعتبارها وسيلة لوقف التفكير النقدي في الصراع باسم استعجال التدخل، وفي الوقت نفسه التعاون مع أولئك الذين كانوا السبب الفعلي في نشوب الصراع (أي قوات الاحتلال الإسرائيلي).(حنفي et al. 2010)
الإسلاموفوبيا كعامل بنيوي
يحدّد فاسان الإسلاموفوبيا كعامل مركزي في القبول الغربي. فهي أيديولوجية متجذّرة في التاريخ الاستعماري ما بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001؛ إذ يُصوَّر المسلمون بوصفهم خطيرين، والعرب كتهديد لهوية أوروبا، بينما يتم التعاطف مع حكومة إسرائيل (باعتبارها “عدو عدونا”). ويشير بحق إلى تداول التعبير: “المسلمون هم اليهود الجدد” في الأدبيات المعاصرة للعلوم الاجتماعية، بما يفيد أنّ معاداة السامية التاريخية في أوروبا قد أُزيحت اليوم لتُلقى على المسلمين.
توسيع النقاش: الليبرالية الرمزية
في الوقت الذي أؤيّد فيه تشخيص فاسان للتنصّل الأخلاقي، أقترح توسيعه من خلال ما أسميه أزمة الديمقراطية الليبرالية وصعود “الليبرالية الرمزية”. ففي كتابي “ضد الليبرالية الرمزية: نداء لعلم اجتماع تحاوري” (حنفي، 2025)، جادلت بأنّه في عصر الاستقطابات الحادة، يعيد منتجو اقتصاد المعرفة (بما فيهم باحثو العلوم الاجتماعية) إنتاج المظالم نفسها التي يسعون لمواجهتها، عبر تبنّي مواقف متصلبة مع استبعاد أي حوار يمكن أن يفتح آفاقًا بديلة. إنهم يتبنّون مبادئ الليبرالية الكلاسيكية، لكنهم يتصرفون بطرق سياسية لا-ليبرالية. أنتقد كيف تعمل الليبرالية الرمزية على تضخيم عالمية الحقوق في الوقت نفسه الذي تُضيّق فيه مساحة الحوار.
وأتفق تمامًا مع فاسان في إبراز بعض العوامل المساهمة في هذا التنصّل الأخلاقي، مثل الإسلاموفوبيا، وذاكرة الهولوكوست المتأرجحة بين الصدق والتوظيف السياسي، والإرث الاستعماري الأوروبي- الأميركي. وفي مقالي الأخير (حنفي، 2024) أضفت عاملين آخرين: أوّلًا، صعود “الصهيونية الليبرالية الرمزية” بوصفها تشويهًا لما كان عليه تاريخيًا صهيونية ليبرالية؛ وثانيًا، الفكرة القائلة إنّ إسرائيل دولة علمانية لا يمكن أن تكون على خطأ.
بالنسبة لي، الصِّهيونيّة في المقام الأول عقيدة قومية، يمكن أن تكون استعماريّة أو شوفينيّة أو إقصائيّة أو تحرُّريّة، تمامًا كأيّ شكل آخر من أشكال العقائد القوميّة. ومع ذلك، أعتقد أنّ التحوُّل الأيديولوجي الكبير حدث في سياقَين: أوّلًا، انتهاك الليبراليِّين لمبادئ الليبراليَّة نفسِها وإنتاج الليبراليَّة الرّمزيّة. وثانيًا، صعود القوى الدينيّة والتطرُّف الديني. سأتناول هنا الصِّهيونية الليبراليَّة، وسأبني على العمل الرائع للعالِم القانوني المصري- الكندي محمد فاضل، الذي يميِّز بين مختلف أشكال هذه العقيدة، ويقوم بانتقاد شكلها السائد الذي يسمِّيه “الصِّهيونية الليبراليَّة”. وربما يمكن تسميتُه بدقّة أكبر “الصِّهيونية الليبراليَّة الرّمزيّة”.
يقدّم فاضل تعريفه المتقَن لهذا الشكل من الصِّهيونيّة: “إدراك أنّ الفلسطينيين هم ضحايا شيء ما، لكنّ معاناتهم تتطلب فقط استجابة إنسانيّة، وليس استجابة قانونيّة تتماشى مع المبادئ الليبراليَّة العامّة للعدل”[3]. يفشل هذا الشكل من الصِّهيونيّة في أخذ المساواة مع الفلسطينيين على محمل الجَدّ، وهو ما يتبدّى في ثلاثة أبعاد رئيسة:
البعد التاريخي: كثيرًا ما يتجاهل الصَّهاينة الليبراليُّون الرمزيُّون تاريخَ فلسطين قبل تأسيس دولة إسرائيل. فإيفا إيلوز مثلًا، في مقابلة حديثة لها، انتقدت شعار “من النّهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرّة” بالقول إنّ مثل هذا الشِّعار يمثِّل سابقة في الدعوة إلى إلغاء أمّة (الإسرائيلية) بأكملها. تجاهلت إيلوز بسهولة حقيقة أنّ إسرائيل ألغَت، سلَفًا، الأمّة الفلسطينيّة قبل هذا الشعار بوقت طويل.
البعد القانوني: يتجاهل الصَّهاينة الليبراليُّون الرمزيُّون المعايير القانونيّة التي كانت موجودة في فلسطين قبل تأسيس دولة إسرائيل وبعده. فعلى سبيل المثال، كان قانون “أملاك الغائبين” يُوفِّر آليّة قانونيّة للدولة للاستيلاء على ممتلكات الأفراد والشركات الفلسطينيّة. هذا القانون يعامِل الفلسطينيين كأشخاص بلا حقوق، وغالبًا ما يُفسَّر الصراع بين الصّهاينة والفلسطينيِّين غير اليهود بوصفه صراعًا جاريًا في أرض مَشاع (terra nullius). وفي هذا السِّياق، تكفي الإشارة إلى هامشية اليهود التاريخيّة لتبرئة المشروع الصِّهيوني من اتّهامات الاستعمار. وبالطبع، يُنسَى تمامًا أنّ الضفة الغربيّة وقِطاع غزّة ومرتفعات الجولان تُعتبَر في القانون الدولي أراضيَ محتلة.
البعد السِّياسي: دفع الصّهاينة الليبراليُّون الرمزيُّون، منذ تأسيس إسرائيل، نحو نظام من التغلُّب العرقي اليهودي على فلسطين وعلى الفلسطينيِّين العرب غير اليهود. وهم يعتبرون أهدافهم السِّياسيّة عقلانيّة، فهي تركّز على أمن الشَّعب اليهودي، لكنّ “هذه الأهداف ليست معقولة (reasonable) لأنّ مقترحاتِهم لا تسعى إلى تأسيس أساس مشترَك للتعاون المتبادَل مع الفلسطينيِّين غير اليهود بناءً على الاعتراف المتبادَل بالمساواة”[4]. وفي النهاية، تستند صهيونيتهم الليبراليَّة الرّمزيّة إلى الاعتقاد بأنّ ما يناسب اليهود كشعب أهمّ من كلام المثاليِّين الليبراليِّين السِّياسيِّين حول الحريّة المتبادَلة. يشير جون رولز إلى هذا النوع من الترتيبات المؤقَّتة بعبارة “مودوس فيفيندي” (modus vivendi)، أي التعايش القَلِق على نحوٍ مؤبَّد، وهو أمر لا يمكن أن يُستدام. وبالنسبة إلى الليبراليّة السِّياسيّة لرولز، فإنّ الانتقال من العقلاني إلى المعقول ضروري للغاية، لكنّ الصِّهيونيّة الليبراليَّة الرّمزيّة ترفض هذا الانتقال[5].
عامل آخر يفسّر، في نظري، هذا التنصل الأخلاقي هو التصوّر الواسع الانتشار في الغرب لإسرائيل بوصفها دولة علمانية لا يمكن أن تخطئ. وإذا نظرنا إلى أحد مؤشرات توسُّع الاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وجدنا أنّ القادة الإسرائيليِّين اليساريِّين توسَّعوا أكثر من اليمينيِّين[6]. أتذكّر كلمة ألقاها آلان تورين في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة (EHESS) في باريس عام 1993، حيث استذكر “المعجزة” الإسرائيليّة المتمثِّلة في استيعاب 150 ألف يهودي روسي في غضون عام واحد. وحين اعترضتُ على وصفه ذلك بالمعجزة، مشيرًا إلى أنّ بعض هؤلاء المهاجرين أقاموا إقامةً غير قانونيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، أجاب: “هؤلاء المهاجرون سيغيِّرون المعادلة، فقد نشؤوا في الاتحاد السوفياتي، وهم عَلمانيون، لذلك سيدعمون عملية السلام”. لا يعلم تورين أنّ هؤلاء العَلمانيين هم من أسَّسوا “إسرائيل بيتنا”، الحزب السِّياسي اليميني المتطرِّف المتحالف مع حركة المستوطنين المتديِّنين في الضفة الغربية. التقينا مرّات عِدّة منذ ذلك الحين، وفي كلّ مرة ذكّرتُه بما قال وقتها، ردّ علي بضحكة أو بابتسامة عريضة.
أخيرًا، اسمحوا لي أن أدفع بتحليل فاسان الرائع حول التنصل الأخلاقي خطوة أبعد، عبر القول إنّ الأمر لا يقتصر على اللامبالاة تجاه الآخر أو تجاه أولئك الذين تُعتبر حياتهم غير جديرة، بل يتعلّق بتجريد المجال العام من أي إمكانية للتداول وذلك عبر تجريم التضامن مع الفلسطينيين. وقد بدأ هذا التجريم قبل الحرب على غزة، حين جرى، منذ أن تبنّى التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) تعريفه العملي لمعاداة السامية عام 2005، السعي إلى مساواة معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، بل وحتى إعادة تعريف الصهيونية ليس كعقيدة قومية بل كعرق. ووفقًا لهذا التعريف الجديد، يُنظر إلى الصهاينة على أنهم جنسية، شبيهة بالعرب أو المكسيكيين أو الفرنسيين، وأيّ نقد لهذه “الجنسية” يُوصم بالعنصرية. إنّها المبالغة في إضفاء القانوني على حياتنا (over-judicialization) التي تجعل إمكانية النقاش الأخلاقي في الفضاء العمومي أمرًا مستحيلًا. لقد أصبح تعريف الـIHRA لمعاداة السامية جزءًا من التشريعات في كثير من الدول الغربية، بهدف نقل النقاش من الساحة العامة إلى قاعات المحاكم، وإغلاق الباب أمام أي حجاج أخلاقي في المجال العام.
تتميّز وضوحية فاسان الأخلاقية (المعقدة) بكونها عاجلة واستشرافية في آن واحد. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 حذّر بالفعل من “شبح الإبادة الجماعية في غزة” (Fassin 2023). ومنذ ذلك الحين، تم تثبيت هذه الإبادة الجماعية ليس فقط من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بل أيضًا من قبل منظمتين حقوقيتين إسرائيليتين هما بتسيلم[7] وأطباء من أجل حقوق الإنسان–إسرائيل[8]، حيث اعترفتا في تقريرين بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. حتى المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال وصف ما يجري في غزة بأنه “النموذج الكلاسيكي للإبادة الجماعية” (textbook case of genocide) [9].
من خلال عدسة حقوق الإنسان والمساواة بين كل الضحايا، يضع فاسان أزمة غزة ضمن انهيار أوسع للسلطة الأخلاقية في الغرب، وهو طرح ردّده أيضًا حديثا عدد من الباحثين. إن هذا الكتاب واحد من أهم الكتب التي ترى أنّ العالم بعد غزة مختلف عما كان قبلها. وهنا أود أن أُبرز كتاب أندرياس مالم (Malm 2025) “تدمير فلسطين هو تدمير الأرض”، الذي يكشف عن نقطة تقاطع بين عمليتين، السياسية والبيئية، حيث تمثّل غزة مجهرًا لهما معًا. هذا “التقنوجينوسايد” (technogenocide)، كما يسميه مالم، والذي ترتكبه دولة متقدمة تكنولوجيًا، هو أول إبادة جماعية رأسمالية متأخرة تُنفذ بواسطة تكنولوجيا متطورة. وكذلك المقدمة التحليلية للفيلسوف الفلسطيني عزمي بشارة حول ازدواجية الأخلاق الدولية، حيث تُستخدم مفردات “التهديد الوجودي” لتبرير القتل الجماعي حتى الفناء، في حين تُغيَّب جذور الاحتلال والاستعمار (الجينوسايد أو جريمة الجرائم، 2025).
فاسان ليس متأثرًا فقط بالانعطافة الأخلاقية في الأنثروبولوجيا؛ بل يُعد أحد أبرز الأصوات بين المفكرين العموميين في فرنسا، الذي يصوغ أبحاثه بحدة سياسية تميّزه عن علماء الأنثروبولوجيا الذين يقتربون من أخلاقيات الفضيلة البحتة. في مواجهة الصمت الغربي، يمثّل كتاب التنصل الأخلاقي اختراقًا في الأنثروبولوجيا، وتدخلًا ملحًّا في النقاش العمومي العالمي.
أما الحملات التشويهية التي أعقبت صدور هذا الكتاب فتُذكّرني بمحادثة أجريتها مع الأنثروبولوجي اللبناني غسان الحاج حول عمله الميداني في لبنان أثناء الحرب الأهلية عام 1978. ذكر واحد ممَّن قابلَهم (من المنتمين إلى حزب الكتائب) أنّ الفلسطينيِّين في لبنان يسعَون إلى السيطرة على البلاد، وخلق وطن بديل لهم. وحينما سأل الحاجّ عن أيّ دليل يدعم ذلك، لمس غضبًا وصمتًا، ثمّ سمع لومًا للسؤال وسائلِه وتشنيعًا عليهما وأجاب: “سأذهب لإحضار مسدّسي من السيارة”. أشعر اليوم أنّ مستوى الحديث عن الحرب الإسرائيليّة على غزّة هو عند هذا المستوى من “الأدلّة”. حين ألقيتُ محاضرة في أوسلو حول الحرب على غزّة، كرّر أحد الحضور الحديث عن معاداة السّاميّة الطافح في أوروبا، عازيًا ذلك إلى المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزّة، وإلى حلّ سياسي للاحتلال الإسرائيلي. سألته عن معركة الجزائر في نهاية الخمسينيّات والإبادة الجماعيّة التي قامت بها ألمانيا في ناميبيا بداية القرن العشرين، وما إذا كان من الطبيعي الادّعاء بأنّ الجزائريِّين كانوا مناهضِين للفرنسيِّين، أو أنّ الناميبيِّين مناهضين للألمان، أو حتى إن كانوا مناهضِين للمسيحيّة.
إن مستوى النقاش لدى بعض منتقدي عمل فاسان – الذين يجادلون بخصوص مزاعم تصاعد معاداة السامية بين الفلسطينيين- يبقى عند هذا المستوى الرديء نفسه من النقاش. بعض النقّاد، مثل مراجعة لكتابه في جريدة “لوموند” الفرنسية[10]، اتهموا فاسان بتحريف المصادر. لكن مثل هذه الاعتراضات تتضاءل أمام قوة اتهامه: أنّ الغرب فشل ليس فقط سياسيًا بل وأخلاقيًا أيضًا، وأن هذا التنصل الأخلاقي قد يشكّل ملامح النظام العالمي المقبل.
* أستاذ علم الاجتماع، الجامعة الأميركية في بيروت.
المراجع:
Fassin, Didier. 2012. Humanitarian Reason: A Moral History of the Present. University of California Press.
Fassin, Didier. 2013. Enforcing Order: An Ethnography of Urban Policing. Polity.
Fassin, Didier. 2023. Le Spectre d’un Génocide à Gaza. AOC, November 1. https://aoc.media/opinion/2023/10/31/le-spectre-dun-genocide-a-gaza/.
Fassin, Didier. 2024. Moral Abdication: How the World Failed to Stop the Destruction of Gaza. Translated by Gregory Elliott. Verso.
Malm, Andreas. 2025. The Destruction of Palestine Is the Destruction of the Earth. Verso.
الجينوسايد أو جريمة الجرائم: مجريات محاكمة إسرائيل في لاهاي. 2025. عزمي بشارة. المركز العربي للأبحاث والسياسات.
حنفي, ساري. 2024. “الاستقطاب المجتمعي والحرية الأكاديمية في زمن الليبرالية الرمزية”. سياسات عربية، no. 67: 32–51.
حنفي، ساري. 2025. ضد الليبرالية الرمزية: نداء لعلم اجتماع تحاوري. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
حنفي، ساري. عدي أوفير، وميخال جيفوني. 2010. “مقدمة في سلطة الإقصاء الشامل: تشريح الحكم الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. تحرير ساري حنفي، عدي أوفير، وميخال جيفوني. مركز دراسات الوحدة العربية.
معالي، ياسر سليمان. 2023. اللغة العربية في ساحات الوغى: دراسة في الأيديولوجيا والقلق والإرهاب. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
هوامش:
[1] Didier Fassin’s Une Étrange Défaite: Sur le Consentement à l’Écrasement de Gaza (La Découverte, 2024)
[2] Moral Abdication: How the World Failed to Stop the Destruction of Gaza (Verso, 2025)
[3] Mohammad Fadel, “Beyond Liberal Zionism: International Law, Political Liberalism and the Possibility of a Just Zionism,” Transnational Law and Contemporary Problems (Forthcoming).
[4] Fadel, “Beyond Liberal Zionism,” p. 44.
[5] المرجع نفسه.
[6] Sari Hanafi, “Explaining Spacio-Cide in the Palestinian Territory: Colonization, Separation, and State of Exception,” Current Sociology, vol. 61, no. 2 (2013), pp. 190-205.
[7] https://www.btselem.org/publications/202507_our_genocide
[8] https://www.phr.org.il/en/genocide-in-gaza-eng/
[9] https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide
[10] https://www.lemonde.fr/livres/article/2024/09/28/une-etrange-defaite-sur-le-consentement-a-l-ecrasement-de-gaza-didier-fassin-s-arrange-avec-les-faits_6337484_3260.html