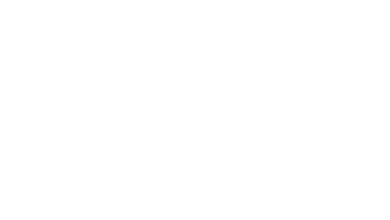مفهوم الحرية في الإسلام – تأملات في التأصيل والتنزيل(فيصل الأمين البقالي)_1_
ما أكثر ما تعترض المرء من التعاريف والمقاربات حول هذا المفهوم الحميم المعروف ولكن المتأبي على التعريف والضبط. إذ الحرية معنى أصيل في الذات البشرية، تعرفه بالحدس أكثر مما تعرفه بالحد، وتأنس إليه مع الفقد، فتطلبه بغاية الإلحاح مهما مُنِعَت عنه، كما تَضِنُّ به ولو دون تمام الوجد، فتَسْتَميتُ دونه بل تودُّ لو تمضي في سبيل ذلك إلى ما لا يحدُّه حدّ.
غير أن مشكل الحرية ما زال يطرح علينا في السياق الفكري العربي والإسلامي من وجوه ثلاثة رئيسة: وجهٍ تأثيلي ووجه تأصيلي ووجه تنزيلي. ونقصد بالتأثيل[1] صناعة المفهوم في اللغة، وكذا تشَكُّلَه في التاريخ أو قل إجمالًا (في الثقافة)، ونقصد بالتأصيل صناعته في المرجعية الفكرية أو قل (في الفكر)، ونقصد بالتنزيل صناعته في الممارسة والسلوك أو قل (في الواقع).
فأما ما يتعلق بالوجه التأثيلي للمشكل ففيه مستويان: مشكل تأثيل المفهوم في اللغة ومشكل تأثيله في التاريخ. ومعلوم أن المفهومات لا تؤتى عمقَها الفكري وقوتها الدلالية وحركيتها الإجرائية في ثقافة أمة إلا إذا تَـبَـيَّـن معناها في الأذهان وتَـبَـيَّـأ مبناها في اللسان، أما تبيُّن المعنى فركنٌ لا سبيل إلى المدركات من دونه. إذ المفهوم بصيغته المفعولية يعني أول ما يعني ما فُهِم في ذاته على ما هو عليه قبل أن يصار إلى ما يكون منه. وأما تبيؤه في اللسان فنقصد به طريقة الاصطلاح عليه -وإنْ لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال- ولكن لأن الاصطلاح القويم هو الذي يُدخِلُ المفهوم في حقل دلالي واشتقاقي غني، لأنه بذلك يفتحه على إمكانات اللغة،
ويفتح اللغة على إمكاناته؛ أو قل بعبارة أخرى أنه يغتني بغَنائها، وتغتني به. فتحصل بذلك المقاربة التي تكاد تكون تامة (وهي أبدًا لا تكون) بين المنطوق والمفهوم، تتضافر فيه دوائر الدلالة التي يتيحها الجذر الذي صير إلى التعبير من خلاله عن المراد حتى تحتشد حول (المفهوم) محل النظر، فتصيب قلبه، وتلملم ذيوله، وتجمع أشتاته ما استطاعت. وبهذا تتفاوت الاصطلاحات في القدر والقوة.
ولفظ “الحرية” بهذا الاعتبار غير قائم بكفاء السول في دلالته على المفهوم المراد به لأسباب يفطن إليها كثير من النظار العرب على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ويكفي أن أحيل في هذا الباب على مثالين دالّين: العلامة التونسي محمد الطاهر بن عاشور والمؤرخ والمفكر المغربي د.عبد الله العروي. فأما ابن عاشور، فنجده رحمه الله في (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) يقول: ((… إن لفظ الحرية وما اشتق منه في العربية يفيد معنى مضادا لمعنى الرقب والعبودية […] فلا يتصور معناها إلا بعد ملاحظة معنى الرق والتوقف عليه […] وليست الحرية التي نبحث عنها هي هذه))[2]. وأما العروي، ففي كتابه الشهير (مفهوم الحرية) نجده أيضًا يقول: ((إن الكلمة العربية ضيقة بالنسبة للمفهوم الأوربي))[3].
وقد اهتما -كما اهتم غيرُهما ممن تناول هذا المفهوم بالدرس- بأصول المصطلح في المعجم العربي، وأوضحا جوانب قُصوره عن الدلالة على ما يراد به ومنه في السياق الحديث للدلالة على مفهوم “La Liberté” كما تأسَّس في الثقافة الفرنسية، وبعدها في الثقافة الغربية بصورة عامة.
وإذا كان العروي قد هوّن من هذا الجانب اللغوي في النظر إلى هذا المفهوم، إلا أنه أفادنا كثيرًا في تلمُّس ما لا يدل عليه، وهو ليس بالشيء القليل في إطار تعريف الشيء بنفي ما ليس منه. فإذا كان العروي قد فعل ذلك، فإن ابن عاشور رحمه الله قد زاد بأن اقترح مقابلًا أو بالأحرى مقاربًا -وقد فعلها قبله رفاعة الطهطاوي،
وإن وجدتُ الطاهر بن عاشور أدقَّ وأوفق- فقد أشار ابن عاشور إلى أنَّ لفظي (الانطلاق) و(الانخلاع) أقوى في الدلالة على مقصدنا من لفظ (الحرية)[4]. ولكنه عاد فأثنى على ركوب مركب هذا اللفظ (الحرية)، لما في حقله الدلالي الأساس من غنى وأصالة في الثقافة العربية، ربما شطَّت بالمتلقي، ولكنها لا تذهب به بعيدًا.
هذا عن اللغة؛ أما عن التاريخ، فإن مشكلتنا مع (الحرية) لتنطرح ابتداء بالنظر إلى سياق تشكلها في الغرب وسياق تشكلها (أو بالأحرى اقتباسها) عندنا مفهومًا يحيل على عناصر تنداح على أبعاد فلسفية ميتافيزيقية ونفسانية وسوسيولوجية لا تتحملها بداهة اللفظ كما استقر في تراثنا. فقد كانت من عقابيل تغيير اجتماعي ثوري استبدل توازنًا اجتماعيًا وحضاريًا معينًا بتوازن اجتماعي وحضاري آخر، ووفق شروط تاريخية استدعت ما كان، فطاوعته. فجاءت مهجوسة بل حتى منوجدة داخل الوعي فائضة على خارجه. في حين إن شروط اقتباسنا لها على حاجتنا الماسة إليها وتوقف صلاحٍ كبير في اجتماعنا عليها، لم تكن مهجوسة ولا منوجدة بل صدم الوعي العربي بها وبغيرها في سياق تدافع حضاري ثقافي وديني واقتصادي وسياسي وعسكري مع من نشأ فيهم، وتشكل عندهم مفهومها، وتراكبت عناصره وتراحبت أبعادُه.
ولعلنا نسوق كلامًا يلخص هذا المعنى في ما كتبه د.العروي في (مفهوم الحرية)، و د.عزمي بشارة في كتابه (مقالة في الحرية).
فأما د. عبد الله العروي، فيقول: ((… ما يهمنا في هذا المجال […] كونُ المجتمع العربي الإسلامي كان لا يفهم من كلمة الحرية ما تفهمه أوروبا الليبرالية. إن كلمة حرية في اللغات الأوربية كانت عادية لدى الغربيين في القرن التاسع عشر والمفهوم كان بديهيا لدرجة أنه لا يحتاج في الغالب إلى تعريف. أما علماء وفقهاء الإسلام فإنهم كانوا لا
يستعملون عادة الكلمة التي لم تعرف رواجا إلا كترجمة اصطلاحية للكلمة الأوربية، وكانوا كذلك لا يتمثلون بسهولة ودقة مفهوم الحرية))[5] ثم يخرج من هذا التحليل اللغوي إلى التاريخي فيخلص إلى أن ثمة ((…تخارُجا بين مفهوم الحرية ومفهوم الدولة في المجتمع العربي الإسلامي التقليدي. كلما اتسع مفهوم الدولة ضاق مجال الحرية […] إذا تصورنا -خطأ- الدولة الإسلامية على نمط الدولة الليبرالية فإننا بالطبع سنلاحظ أنها تنافي وتعارض حرية الفرد، ولكن إذا نظرنا إليها في واقعها التاريخي سنجد أن مجالات واسعة تنفلت من وطأتها، وبالتالي أن الفرد يحافظ داخل تلك المجالات على حرية أصلية…))،[6] ويؤكد قائلًا: ((… لا يجوز إذن أن ننطلق من مفهوم مسبق ونتسائل عن مضمون مفهوم آخر في ضوء ذلك المفهوم المسبق، لا يجوز أن نطلق من الدولة الليبرالية […] ونتساءل عن الحرية في الإسلام…))[7].
هذا المعنى سوف يسهب فيه د.عزمي بشارة على طول فصل كامل، حيث سيُنَبِّه ابتداءً إلى ما كان من انتقائية في التعامل مع فكرة الحرية (المستوردة) في ما سماه : ((…تجاهُلُ الليبراليين العرب الأوائل تاريخيةَ هذه الأفكار وحذف سياقات تطورها. وهذا الحذف هو، كما يبدو، من متطلّبات عملية تطبيقها جاهزة على تاريخ آخر…))[8]؛ وهو ما يؤكده بعد ذلك قائلًا: ((…علينا أن نحذر من محاسبة الحضارة الإسلامية في الماضي بموجب مصطلحات ترتبت عن تجارب استمرت قرونا في حضارة أخرى…))[9]. ولا يكتفي د. بشارة بأن ينبهنا إلى هذا البعد التاريخي المهم الذي أدرجناه في الوجه التأثيلي للمشكل، بل يصحبنا إلى جذوره في محاولة بديعة لفهم أساسه، وذلك عندما يناقش تطور مفهوم الدولة من الجماعة/القبيلة إلى الجماعة/الوطن ومفهوم المواطنة من الفرد عضو القبيلة إلى الفرد المواطن، وارتباط الحرية بوصفها ((…معنى قائما على العقل وحرية الإرداة عند الأفراد…))[10] وليس ((…بمعنى عدم التعبية لسلطة سياسية…))[11]، فيشير مثلًا إلى تعلّق مفهوم الحرية بالفرد كما تأسّست في سياقها الأوروبي في مقابل تعلّقها بالجماعة في السياق العربي، فيقول: ((… ليست الفردية حريةً في نظر البدوي، فالحرية عنده تنطبق على الجماعة، وذاتيته لا تكمن في كونه سيد نفسه، أو حريته الفردية بل في كونه عضوا في قبيلة حرة …))[12]. حتى إذا صير إلى زمن الدولة العربية الحديثة التي احتكرت السلطة لنفسها وركزتها في يدها : ((…انتشر البحث في الحرية عربيا. أصبح الإنسان يولد في الدولة ويموت فيها […] الدولة التي أصبحت العنوان الرئيس لمطلب الحرية…))[13].
في ختامنا لهذا الذي سميناه بالوجه التأثيلي للمشكل بشقيه اللغوي والتاريخي، نؤكد على الخلاصات الآتية:
إن أهمية هذا الوجه من وجوه المشكل في كونه ينبهنا إلى خطر الرافد اللغوي والثقافي عمومًا لأنه يحيل على خطر (المكر) الذي تمارسه الثقافة (من خلال اللغة خصوصًا)، علمًا بأن النظار العرب في مشكل الحرية تفطنوا جميعًا تقريبًا إلى قصور اللفظ العربي، وحاولوا معالجته كل على طريقته، ولكنه كان تفطنًا (قاموسيًّا)، وليس من جهة طريقة تشكل المفهومات. إنَّ لفظة الحرية في القاموس العربي لا تقوم بكفاء المفهوم الذي يصطلح عليه به. وإن هذا الاصطلاح السائد يحيل على غير المقصود منه، ويقصر عندما يحيل عليه. إنّ سياق تشكُّل المفهوم في الوعي العربي لم يكن في الغالب مستنبتًا مهجوسًا، فلم يتخلق منه بل هجسه غيره فانهجس له لأسباب ذاتية وموضوعية معينة.