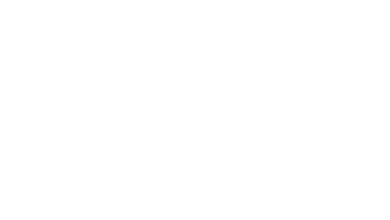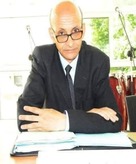نشأة الدولة مع المرابطين(محمد شقير)
هناك بعض الباحثين المغاربة الذين يتبنون طرحا مغايرا يتجسد في ربط نشأة الدولة بقيام المرابطين . و يعتبر الأستاذ بزاوي من أهم الـبـاحـثـين الذين نظروا لهذا الطرح و ذلك من خلال أطروحته الجامعية حول ( دور الدعوة في نشأة الدولة المغربية) .
و تـقـوم هذه الأطروحة بالأساس على فكرة رئيسية مفادها أن ” عهد يوسف بن تاشفين قد شهد لحظة ميلاد الدولة الـمـغربـيـة ، وحقق المجتمع المغربي طفرة نوعية تجلت في إرساء القواعد و الهياكل الأولى للدولة المغربية و في توحيد المجال الأصلي للمغرب الأقصى تحت سلطة سياسية و احدة . ” (4)
من هنا ، يخلص الباحث إلى أن نشأة الدولة المغربية قـد ارتبطت بتبلور عنصرين رئيسين : أولهما انتشار الدعوة الاسلامية بالمغرب و ثانيهما توحيد المجال السياسي . (1)
أولا : الدولة و الدين في المغرب
ينطلق الباحث من أن انـتـشـار الاسلام في المغرب قد ساهم إلى حد كبير في التمهيد لظهور الدولة المغربية و ذلك من خلال خلق الوحدة الاعتقادية و تحقيق الاستقلال السياسي .
أ – الاسلام و خلق الوحدة الاعتقادية
يـرى الباحـث بـأن الـمـغـرب الاقـصى” قـبـل الـدعـوة الاسـلامـيـة كان يـعاني تـمـزقـا سيـاسيا و تـعددا عـقـائـديـا … (2) “، الشيء الذي عرقل تبلور سلطة مركزية مغربية . و هكذا يشير الباحث إلى أنه ” في إطار هذا الوضع عاش المغرب طوال هذه الفترة بدون سلطة مركزية، ولم يستطع المجتمع المغربي بناء المؤسسة السياسية التي توحد مختلف أجزائه أو القيام بإنشاء دولة لها سلطة على المجال المغربي . ” (3)
ويرجع الباحث أسباب هذا الوضع إلى ثلاث عوامل رئيسية :
– البنيات الاجتماعية التي بقيت شبه راكدة
– التدخل الأجنبى .
– غياب إيديولوجية موحدة . (4)
فالمغرب لم يعرف قبل الفتح الاسلامي تبلور أية دعوة دينية استطاعت أن توحد مكوناته السياسية. فحتى انتشار المسيحية في المغرب إبان الاحتلال الروماني لم يؤد إلى هذا التوحيد.
ويفسر الباحث عدم تحول المسيحية إلى إيديولوجية موحدة في المغرب ” بمحدودية انتشارها و نظرا لطبيعة ظـهـورها فـي الـمنـطقـة، فـلم تـدخـل كـحركة إيـديـولـوجـيـة أو ديـنـية مدعمة بنفوذ عصبي أو سلطة سياسية أو عسكرية “… ” لكنها تسربت بأسلوب التبشير ، فبقيت مختفية و محصورة ، و لما اكتسبت الدعم السياسي كان هـذا الـدعم يـمـثـل رمـز الاحتلال و الاستعباد و هذا الوجه الجيد حولها إلى إيديولوجية المحتل مما جعل المغربي ينفر منها . ” (1)
لذا فانتشار الدعوة الاسلامية بالمـغرب قـد سـاعـد عـلى تـجاوز كـل الـمعوقات التي كانت تؤخر نشوء الدولة بالمغرب(2) ، بحـيـث أن الـفـتـح الاسـلامـي أدى إلى خلخلة البنيات الاجتماعية الراكدة و التي كانت تتجسد في سيطرة النظام القبلي(3) . فالمضمون التوحيدي الذي كان يستند عليه الاسلام مهد بشكل كبير لتجاوز التعددية القبلية في المغرب و سمح ، في نظر الباحث، ” لخلق أمة واحدة منسجمة تؤمن بالله الواحد و ترتبط بمصير مشترك تتجاوز بذلك التعددية القبلية و تعدد مراكز السلطة ” (4) الشيء الذي كان يتجاوب و منحى التطور الذي كان يعرفه المجتمع في هذه الفترة .
ب – الاسلام و إذكاء الروح الاستقلالية
يشير الباحث إلى أن الدعوة الاسلامية لعبت دورا كبيرا في إذكاء الروح الاستقلالية في المغرب و ذلك من خلال تبني السكان للمبادىء الدينية التي تدعو إلى المساواة ورفض كل أشكال الاستغلال و العبودية. وقد تأججت هذه الروح خاصة مع انـتـشـار حـركـة الـخـوارج التي كانت دعوة ” تتسم في جوهرها بالبحث عن الذات المغربية و تتمحور حول بناء كيان مـسـتـقـل . ” (5)
وفـي هـذا الإطـار ، حـقـقـت حركة الخوارج المغاربة ثلاث أهداف أساسية لعبت دورا رئيسيا في تحقيق استقلال الكيان السياسي المغربي :
1 – وحدة الحركة بين مختلف القبائل البربرية ” فوحدة الجيش ووحدة الزعامة و اعتناق مذهب الـخوارج و الـسـعـي نحـو هـدف واحـد – الـتـحـرر مـن سـلـطـة الـعـرب الـحـاكـمـيـن – كـل ذلك جسد وحدة الحركة . (1) “
2 – نشر الاسلام و تعميقه في الوسط البربري ؛ بحيث يمكن القول بأن الاسلام دخل إلى أغلب مناطق المغرب مع دعوة الخوارج، مخترقا بذلك الحاجز النفسي المتولد عن ظروف الفتح ، و متجازوا سلبية الماضي الناتجة عن ممارسة و أعمال الولاة . ” (2)
3 – استقلال المنطقة الذي تمثل في مواجهة الادارة العربية و طرد الولاة الذين كانوا يخدمون توجهات الخلافة الأموية . (3)
ج – الاسلام و توحيد المجال المغربي .
إن طرد الفاتح العربي من المغرب، إذا كان قد أرسى استقلال المغرب ؛ فإن ذلك لم يسهم في بلورة سلطة مركزيو موحدة . فالتناقضات المذهبية و الصراعات السياسية أسفرت عن ظهور عدة إمارات تكونت في مختلف أرجاء المغرب . وهكذا أشار الباحث إلى أنه ” بعد أن استقلت المنطقة- المغرب الاقصى- عن سلطة الخلافة الأموية ، بدأت تتجه للبحث عن ذاتها، وتعمل لبناء كيانها و مقوماتها الحضارية انطلاقا من التوجهات العامة للدعوة الاسلامية ، وارتـبـاطـا بـمـعطياتها التاريخية و مانشأ عنها من تيارات مذهبـيـة واختلافات عقائدية . كل ذلك في إطار المحيط الاجتماعي و الخصائص المحلية . وهكذا ظلت المنطقة مخبرا لعدة تجارب محلية ساهمت فيها مختلف الدعوات و الاتجاهات العامة للفرق الاسلامية، فكانت تجربة الخوارج الصفرية مع إمارة بني مدرار بسجلماسة “…” لكن هذه التجربة بقيت محصورة في مجال ضيق … ومن منطلق الدعوة الشيعية الزيدية تأســست سـلـطـة مـركـزيـة كـانـت تطمح إلى بناء خلافة إسلامية من منطلق شيعي يعتبر الأحقية لأبناء علي ، فكان طموحها متجها نحو الشرق مما حال دون عملها على توحيد المجال المغربي “…<<
و فـي ظـل أوضـاع الــتمـزق الـتـي بـدأت تـعـيـشـها بـعـض الـمـناطق ظهرت حركات مغالية في كل من تامسنا و غمارة و السوس ” … ” لكن تجارب الغلاة المـتـمـثلة في إمارة برغواطة و ثورة حاميـم الغماري و تجربة الشيعة البجلية مع أبـنـاء إدريـس فـي الـجـنوب كانـت مـحدودة مكانيا و مرتبطة بالتجربة المحلية و ببعض التقاليد و العادات الموروثة . ” (1)
ورغـم فـشـل مـخـتـلـف هـذه الـتـجـارب في تكوين الدولة المغربية ؛ إلى أنها قد ساهمت مع ذلك في بلورة لبناتها الأولى :
– فـبـناء إمـارة بـنـي مـدرار” لمركز حضاري بسجلماسة و تأسيسها لسلطة سياسية محلية تكون قد خلقت بذلك تقاليد الاستقرار و مـمارسة الـسـلــطـة الـسـياسية متجاوزة أفق النظام القبلي . و بذلك غرست في المنطقة لبنة من لبنات الدولة المغربية . ” (2)
– و ” مع الدعوة الادريسية الشيعية الزيدية انتشر الاسلام و تعمق في بعض المناطق، و تأسست النواة الأولى للإدارة المغربية ، و مع انقسام الدولة الادريسية إلى عدة إمارات تكونت عدة مراكز حضرية شكلت فيما بعد نواة و أرضية لتقبل السلطة المركزية، و بالتالي هيأت الظروف لنشأة الدولة المغربية المستقبلية . (3) “
– كما أنه رغم ” فشل الدعوات المغالية في بناء سلطة مركزية فإنها دفعت المنطقة إلى التوجه بسرعة نحو الوحدة المذهبية و السياسية، ونحو نشأة الدولة المغربية . ” (4)
غير أن هـذه الـتـجـارب، إذا كانـت قـد سـاعـدت عـلى تسهيل عملية نشأة الدولة بالمغرب؛ فإن العامل الأساسي و الحاسم الذي كان وراء ظهور الدولة المغربية ، تجسد على الخصوص في نظر الباحث في انتشار المذهب المالكي الذي أصبح الايديولوجية السياسية للمرابطين . فقد كانت ” الدعوة المرابطية دعوة دينية تحمل مشروعا إصلاحيا وفي ذات الوقت تتطلع لسلطة سياسية و مشروع لتوحيد المنطقة (5)“.
فـقـد ” استطاعت هذه الدعوة … أن توحد جنون المغرب ثم شماله، و بذلك توحد المغرب من الناحية السياسية و تأسست السلطة المركزية مع قيام الدولة الـمـركزية مع قيام الدولة المـرابـطـيـة كـسلـطة ســيـاسـيـة و حـدت كـل المجال الجـغـرافـي الأصلي للمغرب الأقصى ، و هو مجال يمتد بين تلمسان و ماوراء ملوية شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ، و من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى قبائل الصحراء جنوبا . وقد تولدت مع الدولة المرابطية الثوابت و المقومات الأساسية للدولة المغربية . ” (1)
وعموما، فرغم أهمية هذا الطرح في إبراز الدور الكبير للدعوة في تكون الدولة المغربية، فإنه يسقط مع ذلك في عدة محاذير يتمثل أهمها فيما يلي :
– المصادرة التاريخية
إن الربط المركزي بين نشأة الدولة و انتشار الدعوة الاسلامية بالمغرب ، أدى إلى مصادرة جزء كبير من التاريخ الـسـياسي المغربي بدعوى أنه لم يـشـهـد تـبلور أية سلطة سياسية أو إرهاصات لدولة مغربية . وهكذا فإن الحقبة السياسية التي تمتد من ما قبل الاحتلال الروماني إلى الفتح الاسلامي تعتبر، وفـق هذا المنظور، حقبة فارغة من كل تنظيمات سياسية .
و يتم الاستدلال على ذلك من انعدام أدبيات تاريخية محلية . في حين أن الأدبيات التاريخية الرومانية القديمة لا يصح الاعتماد عليها نظرا لتعاملها مع تاريخ المغرب من موقع التبعية . (2)
بالاضافة إلى أن ذلك ، فـهـذا الـطـرح لا يمنح أدنى أهمية لكل المظاهر التي يمكن أن ترمز لوجود سلطة سياسية، فهي لا تعدو في نظره أن تكون مجرد محاكاة سياسية للامبراطورية الرومانية . (3)
وعلى هذا النحو ، يـسـتـرسـل هـذا الـطـرح فـي مصادرة كل المظاهر و كل الأشكال السياسية التي عرفها المغرب، و التي تـحـدثـت عـنـها الأدبـيـات الــتاريـخـيـة الرومـانـيـة لـيخـلـص إلى انعدام وجود أية ارهاصات
أو ملامح لسلطة سياسية أو دولة مغربية طيلة هذا العهد . وهكذا يتم التأكيد على أنه ” بالنسبة لطبيعة السلطة في عهد باغا و بوغوس التي تثير نوعا من الغموض و اللذان كان يـطـلـق عليهما لقب ملك مما يستوحى منه أنهما كانا يمثلان سلطة مركزية في بلاد المور، فباغا لا نعرف عنه شيء سوى تلك المساعدة التي قدمها لمسينسا . هذه المساعدة لا يمكننا أن نعتبرها دليلا ماديا على وجودسلطة مركزية لأن أي قبيلة قوية أو رئيس اتحاد قبلي كان من الممكن أن يقدم تلك المساعدة إن اقتضتها الصداقة الشخصية أو المصلحة العامة . أما بالنسبة لبوخوس الأول فرغم أن سالوست يؤكد عدم معرفة الرومان أي شيء عنه فإن الروايات الرومانية تتحدث عنه كملك لبلاد المور و نوميديا الغربية بعدما أضيفت إلى منطقة نفوذه بعد خيانته ليوغرطة و تسليمه للرومان، إلا أننا نتساءل عن المناطق التي سلمت له و المناطق التي كانت تحت سلطته في بلاد المور ؟ (1) “
ثم ينتهي هذا الطرح بالقـطع بـ ” أن الاعتماد على أسماء ملوك و أمراء أو نقود تحمل سنابل قمح و سمكة تون و صورة نحلة و عنـاقـيد عنـب … أو مدن تظهر كعواصم ، ليكسوس وليلي، طـنـجـة … هل يمكن الاعتماد على كل ذلـك لاثـبـات وجود دولة في غـيـاب تـام لـسلطة واضحة و مؤسسات قارة و تنظيمات هيكلية و وحدة مجالية و في غياب الوقائع التاريخية التي توضح الغامض و تلحم المبتور و تؤول المتناقض ؟ ” … ” و حتى إذا فرضنا وجود سلطة سياسية عامة و اعتبرنا أن الممالك التي ظهرت في الفترة الرومانية كانت مستقلة ولاتندرج ضمن سلطة الولاة الذين يحكمون باسم روما فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماهي حدود هذه الممالك ؟ و ما هو مجال توسعها ؟ ” (2)
وبعدما يجهز هذا الطرح على مختلف المظاهر و الرموز التي كانت تجسد وجود ملامح دولة مغربية منظمة سياسيا يـتـم تـبـسيط و تقزيم كل الحركات التي قامـت لمواجهة المـحتل الروماني ، و اعـتـبارها فـقـط ردود فعل قبلية محدودة و مـشـتـتـة . (1)
مـن خـلال كل هذا يتبين أن هذا الطرح تعمد منذ البداية، و ذلك تحت ضغط فكرة مسبقة حول طبيعة نشأة الدولة في الـمـغرب حددت معالمها فلسفيا لاتاريخيا، أن يشكل و أن يجهز على كل ما ورد من حقائق تاريخية في الأدبــيـات الـرومانية القـديـمة . فـمـوضوعيا، على الباحث أن يتعامل مع هذه المعطيات، حتى و لو وردت في أدبيات أجنبية . إذ كيـفـما كان الحال ، فـهـذه الأدبـيـات لن تـخـتلق حقائق غير موجودة ؛ بل إن المفارقة أن هـذه الأدبـيـات عـنـدما تـتـحدث عـن الـمـلـوك و أمـراء مـغـاربـة و عـن مـجالس خواص تحيط بهؤلاء الملوك ، وعن مشاركة جيوش هؤلاء الملوك في الحروب التي وقعت بين روما و قرطاجة أو في اشتراكها في الحرب الدائرة بين يوغرطة و جيوش روما … يعتبر كل ذلك أشكال قبلية أو زعامات لاتحادات قبلية . فهذه أول مرة نرى أن مؤرخي محتل ما يقومون بتمجيد تاريخ أمة محتلة في حين يقوم باحثون محليون بالتنقيص من هذا التاريخ و رفض معطياته بدعوى كتابته ” بروج استعلاء و تفوق ” المحتل !!
– الخلط المنهجي
يتبنى هذا الطرح مـفـهـومـا خـاصـا لـلـدولة في المغرب يقوم بالأساس على ربط نشأتها بتجاوزها للواقع القبلي و توحيدها للمجال المغربي الأصل . و يتضح ذلك من خلال التعريف الذي أسبغه بزاوي على الظاهرة الدولتية المغربية . “فالدـولة باضـافـة اسـم الاسرة الحاكمة تعني سلطة سياسية تتجاوز نظام القبيلة و تتحكم في بعض مناطق المغرب ، و تتوفر على بعض الهياكل الادارية و السياسية للدولة ، ولكنها لم ترق إلى مفهوم الدولة المغربية لأنها لم تـستـطـع توحيد كل مناطق و أقاليم المغرب الأصل تحت سلطتها ، في حين أن مصطلح الدولة المغربية سيستعمل عندما تستطيع سلطة سياسية ما – غير أجنبية – من توحيد كل مناطق و أقاليم المغرب الأصل تحت سلطتها و ضمن نفوذها أي أن اسم الدولة المـغـربـيـة يطابق اسم الدولة المركزية التي تؤول إليها جميع السلط داخل رقعة من الأرض و تتحكم في جميع الاقاليم الداخلة في هذه الرقعة ” (2)
من خلال هذا التعريف ، يظهر أن هذا الطرح يركز بالأساس على الدولة المركزية بالمغرب و ليس على الدولة المغربية بصفة عامة . و من المعروف تاريخيا أن الدولة المركزية هي مرحلة متطورة في حياة كل المجتمعات السياسية ؛ ففي أوربا مـثلا لم تنشأ الدولة المركزية إلا في القرن 17 م ، و في فرنسا بالضبط لم تتكون الدولة المركزية إلا في عهد لويـس 14 فـي حين أن الدولة في هذه المجتمعات قد نشأت قبل ميلاد المسيح بحقب طويلة و خضعت لتطورات متتالية توجت بظهور الدولة المركزية و في المغرب أيضا لايمكن أن نحدد ظهور الدولة المركزية مع المرابطين . إذ أن الدولة المركزية المغربية لم تتكون إلا في عهد السعديين و توطدت مع العلويين لتترسخ بعد الحماية . أي أن الـدولة الـمركـزيـة الـمـغربـيـة ليست هي الدولة التي تستطيع فرض سيادتها على مختلف مناطق المغرب ( الأصل) ؛ بل هي التي تستطيع السلطة المركزية فيها أن تصبح هي السلطة الوحيدة في البلاد و تستطيع القضاء على كل الوسائط السياسية سواء كانت قبائل أو زوايا و غير ذلك من الوسائط، و هذه مرحلة لم تصلها الدولة بالمغرب إلا بعد انتهاء فترة الحماية .
– النظرة الاختزالية
ركز الطرح بشكل أساسي عـلـى الـدعـوة كعامل حاسم في نشأة الدولة بالمغرب . و يتضح ذلك بالخصوص من اهتمامه بالدين كعنصر فعال في تجاوز النظام القبلي و توحيد مـخـتـلـف الـمكـونات السياسية حول السلطة المركزية و نجاح المرابطين في تحقيق الوحدة السياسية المغربية و إرساء مقومات الدولة بالمغرب .
ورغم انه لايمكننا أن نـغـفـل مـا لـلـدعوة من دور أساسي في تسريع عملية التوحيد السياسي ؛ إلا أنه لايمكن أن نـقـطـع بـدورها الـحاسم فـي نشأة الدولة بالمغرب . فالدولة المغربية نشأت قبل ظهور الدعوة الاسلامية بحقب طويلة، أي أن ملامحها كانت قد حـددت على الأقل في حدود القرن الثالث قبل الميلاد(1) ثم تطورت فيما بعد مع مختلف القوى السياسية التي تداولت حكم المغرب .
ثم إن الدعوة المرابطية، رغم أنها لعبت دورا كبيرا في توحيد أنحاء المغرب و إضفاء الشرعية السياسية على حكم المرابطين ، فإنها مع ذلك لم تلغ الدور الكبير الذي لعبته العصبية الـصنهاجية في إرساء مـقومـات الدولة . فالـدعوة و العصبية قـد لعبا دورا تفاعليا في تحقيق المشروع المرابطي . وهذا ماركز عليه الجابري ، الذي اعتمد عليه صاحب الطرح بشـكل كبير ، عندما أشار إلى ” أن العلاقة بين العصبية و الدين … علاقة تآزر و تعاضد و تكامل : الدين يـزيد مـن قـوة الـعـصـبـيـة بالـتحقيق من مظاهر التعصب … و العصبية من جهتها تمتح الدعوة الدينية قوة و فاعلية . ” (1)
لكن الدور الحاسم يبقى مع ذلك للعصبية خاصة في بلد مثل المغرب بدليل ان المرينيين صعدوا للسلطة بدون دعـوة ديـنـيـة . بالاضافة إلى ذلك فابن خلدون، الذي يبدو أن جزءا كبيرا من أفكاره قد صيغ كأرضية لهذا الطرح ، لم يـغـفـل الـدور الحاسم الذي لعبته العصبيات في تقوبة و إرساء أسـس الدولة بالمغرب ، بما فيها عصبية لمتونة ؛ إذ أشار في الفصل الـخامـس مـن المقدمة الذي عنونه ( في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة العصبية التي كانت لها من عددها ) إلى مايلي :
” و السبب في ذلك كـمـا قـدمنا أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس و التحاسد الذي في أهل العصبية و تفرد الوجهة إلى الحق، فإذا حصل لهم الاستبصار في أمـرهـم لم يـقـف لهم شيء لأن الوجهة واحـدة و المطلوب متساو عندهم و هـم مـسـتـمـيـتون عـلـيـه . وأهـل الـدولة التي هم طالبوها و إن كانوا أضـعـافهم فأغراضهم بالـباطل و تخاذلهم لتــقـيـة الموت حاصل فلا يـقـاومـونهم و إن كانـوا أكـثـر مـنـهـم بـل يـغلبون عليهم و يعاجلهم بـمـا فيهم من الترف و الذل و هذا كما وقـع للعرب صـدر الاسلام ” … ” و اعتبر ذلك أيضا دولـة لـمـتـونـة و دولـة المـوحديـن كان فـقـد بالـمـغرب من الـقـبائل كثـيـر مـمـن يـقـاومـهـم فـي العدد و العـصـبـية أو يـشــق عـلـيـهـم إلا أن الاجـتـمـاع الـديـني ضـاعـف قــوة عـصبـتـهـم بالاسـتـبصار و الاسـتـمـاتة كـما قـلـنا فلم يقـف لهم شيء … ” (2)
و لـعـل هـذا الـنـص الـخـلـدونـي يـوضح أن الـدعـوة الـدينية لم تشكل أبدا عاملا حاسما في نشأة الدولة بالمغرب ؛ بل هـي قـبـل كـل شيء أداة لـتـوحـيـد الـعـصبـية الـطامـحـة لـلـحكـم للـقـضـاء عـلى مـنافسيها من القبائل و الـعـصـبـيات الأخرى . “فالدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم” في رأي ابن خلدون ؛ إذ أن “كل أمر تحمل عليه الكافة ، فلا بد له من العصبية ، و في الحديث الصحيح … مابعث الله نبيا إلا في منعة مـن قـومـه ، و إذا كـان هـذا فـي الأنبياء و هم أولى الناس بخرق العوائد فما ظنك بغيرهم أن لا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية . ” (1)
من هنا يتم التساؤل عن الكيفية التي تم بها القـفـز على مختلف هذه الأفكار الخلدونية أو على الأرجح بمصادرة بـعـضـها لـلـتـركيز عـلـى الـبـعـض الآخـر و ذلـك للتدليل على (دور الدعوة في نشأة الدولة المغربية) . ويمكن أن نفسر هذا الموقف بتبني هذه الطرح لمنظور إيديولوجي في معالجة واقع تاريخي مغربي له منطقه التطوري الخاص به . (2)