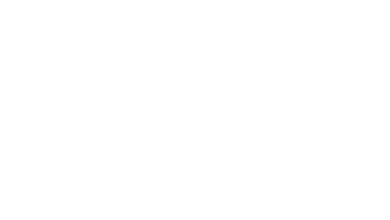سؤال الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن:مداخل نظرية حول تفاعل المؤرخ مع قضايا الساعة (إبراهيم القادري بوتشيش)
هل يمكن للمؤرخ الخوض في حدث لحظي تتشكل مشاهده تحت سمعه وبصره قبل أن يختمر الحدث وتكتمل حلقاته؟ وهل تعدّ المادة التاريخية الخام التي يلتقطها من اللحظة الراهنة وافية غير منقوصة؟ وأين هي المسافة الزمنية التي عليه أن ينتظرها قبل أن يلملم استنتاجاته، ويصدر أحكامه؟
تلك هي الإشكالية المنهجية التي نروم وضع الإصبع عليها ونحن نعالج سؤال الحرية النسائية بالمغرب، في ضوء خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي لا تزال تفاعلاتها تتناسل، ولا تزال ردود الفعل تجاهها تتشكل إلى حدود كتابة هذه السطور.
على وقع هذا السؤال المنهجي، نسعى في هذا المدخل إلى معالجة الإشكاليات الإبستيمولوجية التي يصطدم بها المؤرخ عند معالجة قضايا الساعة في مجتمعات تمور بالتحولات ، وتتداخل فيها الاختصاصات العلمية والسلط المعرفية، مما يتولد عنه إثارة سؤال المشروعية، ومن له حق التدخل في الاختصاص…
عديدة هي الأحداث التي تمرّ أمامنا في تاريخ الزمن الراهن، تتسارع عقاربها تحت أعيننا عبر وسائل الإعلام التقليدية، أو من خلال الوسائط المعلوماتية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، ومنصّات التواصل الاجتماعي؛ تثير فينا غريزة المتابعة والمشاهدة، تولّد لدينا التساؤلات الحارقة، والهواجس المعرفية الشائكة، وتقدم لنا ” مادة تاريخية” ساخنة وفائرة. بيد أننا لا نستنهض أقلامنا كمؤرخين لتدوينها وتحليلها، تاركين الفضاء مفتوحا لأقلام الصحفيين والباحثين في العلوم السياسية والنشطاء الحقوقيين والميديائيين الذين ينقلون ويسجلون “أحداث الساعة” عن كثب، ليقدموها للمؤرخ كمادة تاريخية تحفزه – في مراحل لاحقة، وربما بعيدة- على الاستقصاء والتنقيب والتحليل بعمق وتؤدة. لا يُفهم من هذه الإيماءة تبخيس دور الإعلاميين والنشطاء وغيرهم في الاكتفاء بتزويد المؤرخ بالمادة التاريخية، أو التقليل من أهميتهم في إماطة اللثام عن وقائع التاريخ اللحظي. فمن باب الإنصاف والموضوعية القول أن بعض الصحافيين تعاملوا مع الخبر كوسيلة وليس كغاية[1]. ووظفوا الآلة الإعلامية كأداة لفهم قضايا التاريخ الراهن[2]، فتفاعلوا بعمق وحميمية مع بعض أحداثه ومفاصله الكبرى.
يحضرني في هذا الصدد نموذجا للصحفي اللامع “ديفيد هالبرستام” David Halberstam الذي كان شاهد عيان على الحروب التي شنتها الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي، وكتب حولها مباشرة تقارير ومقالات ومؤلفات حصد بعضها جوائز علمية مرموقة. ولا غرو فقد أفلح هذا الصحفي في إضاءة الزوايا المعتمة من أحداث نصف قرن من الأمجاد والانتكاسات الأمريكية، بمنهج تاريخي موثق ومضبوط، وصل به إلى أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو الحدث الذي نجح فيه بإشراقة قلمه في الجمع بين صفتي الصحفي والمؤرخ، حين جعل تحت الضوء لأول مرة في التاريخ، الدور البطولي لرجال الإطفاء، من خلال معاينته عملية إخماد نيران التفجيرات الإرهابية في نيويورك[3]. ولولا هذه المعاينة الميدانية وتسجيلاتها، لصارت ملحمة رجال الإطفاء نسياً منسياً كلما انطوت السنون، وتقادمت ذاكرة الزمن.
وعلى نفس المنوال، نجح الصحافي المؤرخ ” هنري أمورو” Henri Amouroux, في الانضمام إلى كوكبة المؤرخين الفرنسيين الألمعيين، عندما أصدر عشر مجلدات من”تاريخ فرنسا تحت الاحتلال” بأسلوب صحفي بسيط، ولكنه موثق بالوثائق والمراجع، ناهيك عن مؤلفات تاريخية أخرى جعلت كتبه تتربع على عرش المبيعات. وقد كلّفه ذلك جهدا مضنياً لم يتوقف طيلة 18 سنة، قبل أن يتم نشرها كاملة[4]، وهو إنجاز ضخم نعتقد أنه يوازي أو يفوق الجهد الذي يقوم به بعض المؤرخين المحترفين.
وسواء كانت كتابات الصحفيين للتاريخ بهذا النموذج المثخن الذي يمثله نموذج “هنري أمورو” أو الاقتصار على تسجيل الخبر من دون توظيف خبرة المؤرخ وصرامته المنهجية وحفره في قعر التاريخ ودهاليزه، فإن مشهد الكتابة في قضايا الساعة يوحي وكأن الصحفي سيّجها بسور سميك، ليجعلها حكرا عليه، بحضوره الميداني الدائم، واستقصائه للأخبار في عين المكان، مقابل إشاحة المؤرخ وجهه عن هذا الفضاء الزمني الفائر، المفعم بالأحداث، وهي ملاحظة تنطبق على موضوع الحرية النسائية والمعركة الحقوقية مدار هذه الدراسة، حيث ألقت الصحافة الأضواء على الحدث، في الوقت الذي توارى قلم المؤرخ، وتراجع إلى الخلف.
سبق في تجارب بحثية سابقة أن وضعنا الإصبع على قضايا ساخنة من التاريخ الراهن، حين سلّطنا شعاعا من الضوء حول تداعيات انتفاضات الربيع العربي في العقد الثاني من الألفية الثالثة ، وعلى سنوات الجمر في سبعينيات القرن العشرين، تبيّن من خلالها أن قضايا الساعة تستحق أن تنتقل من مربع اهتمامات الصحفي وعلماء السياسية وناشطي حقوق الإنسان، إلى مربع اهتمامات المؤرخ، لتوضع تحت مبضع تحليلاته وتشريحاته، وتستفيد من آليات اشتغاله[5].فالمؤرخ لا يتعهّد الماضي كحقل أساسي في مشاريعه البحثية فحسب، بل يشتغل أيضا – على غرار الصحفي والسياسي- بقضايا الحاضر وإشكالاته المعقدة والملتبسة، ويجعل من تحليل البنية مفتاحا لقراءة الظرفية، والفهم العميق لمجريات لحظات التاريخ الآني، وفكّ شفراته من قلب السياق التاريخي، وتأصيل القضايا الكبرى الممتدة في الماضي. ولا يساورنا الشك في أن إضاءات هذه العتمات، تجعل المؤرخ مساهما في تأثيث نقاش مجتمعي متوازن، وتفاعل بناء مع الرأي العام، من زوايا التاريخ والفكر، بهدف إعادة الهيبة لصنعته، وسيولة سلطتها المعرفية.
في هذا المنحى التفاعلي، نسعى هذه المرّة إلى فتح ورش نحسب أنه يندرج أيضا في مركز اهتمامات مؤرخ التاريخ الراهن، وقضاياه الساخنة التي لا تزال في مرحلة المخاض والتحوّل. يتعلق الأمر بحدث ظهور مشروع “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” الذي نعتبره حدثا تاريخيا ومفصليا في تاريخ الحركة النسائية بالمغرب، لأنه شكّل متنا خطابيا غير مألوف حول حرية المرأة المغربية، بإحالة الموضوع على المواثيق الدولية، ممّا أحدث رجّة فكرية قوية، وانقساما في الرأي العام المغربي حول مدى قبول نصوص القانون الدولي، والمواثيق العالمية كمصدر منتج ومحدّد للحرية النسائية، خاصة في الشقّ المتعارض مع التشريع الإسلامي. كما طرح من جديد سؤال الهوية، وإشكالية ترسيم حدود السيادة والتصادم بين التشريعات الوطنية والقوانين الدولية. بوضع مفهوم الحرية ذاته على محك النقد والمساءلة في ضوء المفاهيم الحضارية المتعارضة، والبيئات المستقبلة.
وقد ولّد هذا الانقسام – ولا يزال – نقاشا فكريا صاخبا حول مرجعيات حرية المرأة بالمغرب، وانعكست معالمه في التدافع الذي حدث بين الحركات الإسلامية المسنودة بالمرجعية الدينية، والجبهة الحداثية المنشدّة إلى المرجعية الكونية والمواثيق الدولية، وهو تدافع سلمي، رغم ما شابه أحيانا من نبرات استفزازية لفظية، سرعان ما اضمحلت أمام الموجة التغييرية السلمية الناعمة التي غدت تؤطر الرأي العام المغربي، بفضل ما يشهده المغرب من تحولات تؤشر على تراجع نسبي لمنظومة التقاليد والأعراف المحافظة المتسيّدة، ومحاولة إيجاد منطقة وسطى يتم فيها التوافق والتعايش.
أحسب أن مشروع”الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”الذي يمثّل محور هذه الدراسة يجسّد محطة جديدة في تاريخ الحرية النسائية بالمغرب خلال الزمن الراهن. ومع أنه موضوع يندرج أصلا في حقل الدراسات القانونية والسياسية، فإنه يُعَدُّ أيضا مستندا تاريخيا مركزيا يضاف إلى مستندات حقبة التاريخ الراهن، ويشكّل حدثا بارزا بحكم ما تركه من صدى عميق داخل المجتمع المغربي.
تأسيسا على ذلك، فإن دراستنا ستنطلق من حزمة من الأسئلة التي نعتبرها أسئلة حارقة نظرا لراهنيتها، ولصعوبة الحسم في الإجابة عنها، لأنها تعكس بعض مظاهر الصدام بين الشريعة الإسلامية والقوانين والصكوك الدولية، وبين الهوية المغربية، والهوية العابرة للقارات. ويمكن إجمالا إثارة تلك الأسئلة على النحو التالي:
1-ما هي الخطوط الكبرى لتمثّلات الحرية النسائية كما وردت في مشروع “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”؟ وما هي مرجعياتها والسياقات التي ظهرت فيها؟ وكيف قدمت نصّا جريئا يتكئ على المرجعية الدولية، و”يتفاوض” مع ثوابت الهوية المغربية؟ وكيف أحدثت مواقف متباينة بخصوص الحرية النسائية بالمغرب؟
2-ما هي الإستراتيجية التي تبنتّها القوى المعارضة لخطة العمل الوطنية في معركتها الفكرية لإجهاض هذه المبادرة الجريئة التي تروم تحرير المرأة؟ وكيف واجه واضعو الخطة خصومهم المتشبثين بالمرجعية الإسلامية؟
3- ما مدى الهزة التي أحدثتها “خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” في المجتمع المغربي ونخبه وعقلياته ؟ وفي الأسرة التقليدية؟
4- ما هي مفاهيم الحرية التي جرى النقاش الساخن حولها بعد ظهور الخطة؟ وهل يمكن الحديث عن حرية واحدة، أم حريات تتشكل وفق الظرفيات الزمنية والمعطيات التاريخية التي أنتجتها؟ علما أن مفهوم الحرية ذاته مفهوم لا يزال في دائرة الجدل، بسبب ما يلفّه من إشكاليات نظرية[6].
5- ما هي ممكنات التحليل النقدي لرؤى وتوجهات كل من أنصار المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية ومنظورهم لحرية المرأة المغربية من أجل تذويب مساحات التعارض، والمساهمة في التوفيق والتقارب بينهما ؟
تلك جملة من الأسئلة التي يخيّل إلينا أنها أسئلة حارقة، لأنها تطرح إشكالية ذات بعدين ثقافيين نسعى لوضعهما معا تحت مبضع التفكيك والتشريح، فهي تطرح حرية المرأة المغربية في ضوء قطبين متعارضين: مبدأ سمو التشريعات الوطنية المسنودة بالمرجعية الإسلامية، والهوية الوطنية والخصوصية التاريخية، ومبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، والمفاهيم المعولمة “المفروضة” من القوى العالمية المتحكمة التي تروم نسج تنميط ثقافي معولم، يتجاوز الهويات والخصوصيات، ويسعى إلى ترويض القيم المحلية لصالح القيم العالمية.
قبل ملامسة الأجوبة الممكنة عن هذه التساؤلات التي سنتناولها بالإسهاب والبسط في فصول ومباحث هذا الكتاب، نرى من باب المداخل المنهجية أن نطرح تساؤلات مرتبطة بزوايا النظر التاريخية التي يتم معالجة الموضوع وفق قواعدها وآليات اشتغالها من قبيل: هل بإمكان المؤرخ أن يؤرخ لحدث قريب لم يَبُحْ بعد بكل أسراره، ولم تكتمل بعد كل معالمه وحيثياته وتفاصيله؟ ألا تعد هذه المحاولة التاريخية “تطفلا” من قِبَلِ المؤرخ، وخروجا عن قواعد الكتابة التاريخية التي تفترض وجود مسافة زمنية تسمح باختمار الحدث التاريخي، واتضاح ملامحه الدقيقة، وانفتاح مغلقاته؟ وهل تنطبق هذه المحاذير على دراسة مشروع “الخطة الوطنية لإدماج المٍرأة في التنمية” باعتبارها مستندا أو وثيقة تاريخية تتطلب من المؤرخ التريث، واتخاذ المسافة الزمنية اللازمة حتى تظهر كل المعطيات والوثائق الأخرى، وتتضح بعض الزوايا الخفية التي لا تزال إلى الآن ملتبسة أمام عين المؤرخ؟ وهل يعتبر انخراط المؤرخ وتفاعله مع قضايا التاريخ الراهن وضمنه مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة- مدار دراستنا- “تطاولا” على تخصصات معرفية لها الحق في طرق الموضوع، أم أن هذا التفاعل يندرج في مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية؟
نطمح إلى الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال محورين نعتبرهما مدخلين لتأكيد مشروعية التأريخ لحدث راهني كمشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وما تمخض عنها من مواقف.
1- في جدوى التأريخ للحاضر : صعوبات ومطبّات:
يعدّ تاريخ الزمن الحاضر L’histoire du temps présent من التحقيبات الجديدة التي قرضت مكانتها في حقل البحث التاريخي، بعد أن كان المؤرخون يزّاورون عنها، نتيجة عوامل سنعرض لها عند التحليل، وهو عبارة عن لحظة تاريخية يعايشها المؤرخ، ويتفاعل مع أحداثها، لذلك يسميه البعض بالتاريخ الآني، أو التاريخ الجاري كما يطلق عليه البعض اسم التاريخ القريب أو التاريخ الراهن أو التاريخ الفوريHistoire immédiate[7].
وتتجسّد أبرز صعوبات التأريخ للزمن الراهن في استمرار جريان وقائعه لحظة التأريخ لها، من دون أن تكون حلقاتها قد اكتملت بعد، مما يحول دون تقديم مادة تاريخية كافية وقابلة للاستهلاك النهائي. لذلك فإن غياب المسافة الزمنية أمام المؤرخ، تأتي في طليعة المطبّات المعرفية التي تعيق البحث في التأريخ للحاضر. فالمؤرخ يحتاج إلى مدى زمني كاف حتى يختمر الحدث التاريخي، وتنكشف مضمراته، وتنجلي أسراره، وتنقشع التباساته، ليبدأ بمعالجته في تؤدة وهدوء. كما أن الحدث التاريخي الذي يتشكّل أمام عينيه، يبقى رغم أهميته ناقصا ومنفصلا عن ((بقية التاريخ وتوابع الحدث ))[8]،لذلك يتأكد مع مرور الزمن أن بعض النتائج والاستنتاجات، ليست سوى مجرد مقدمات وتمهيدات للأحداث، أو حتى فرضيات، وهو ما يزيد من إرباك عمل المؤرخ، ويجعله استنتاجاته معلّقة، أو مؤجلة إلى حين.
صحيح أن التاريخ الراهن يعدّ إيجابيا بحكم أن شهوده لا يزالون على قيد الحياة، ويمكن بالتالي استثمار شهاداتهم المباشرة. لكن هذه “الشهادات “تشكل عائقا إبستيمولوجيا في مجال التوثيق إذا كان أصحابها من الفاعلين الكبار في صنع الحدث ، والمؤثرين فيه سلبيا، وغير راغبين في أن ينجلي فعلهم. فالشاهد في هذه الحالة يعمد إلى طمس كل ما يمت بصلة للحدث، حتى لا يحاسب عليه.
ومن جملة الصعوبات التي تعتور سبيل مؤرخ التاريخ الحاضر، عدم إمكانية اطلاعه على كافة الوثائق والأحداث الجارية في الأرشيف التاريخي لأسباب قانونية “مفروضة”، إلى حدّ جعل بعض المؤرخين من طينة “فرانسوا بيداريدا “Bedarida يطالب بإزالة القفل عن ذخائر الأرشيفات الوطنية والدولية، حتى تكون متاحة للجمهور، وينادى بتبسيط المساطر القانونية للولوج إليها، واستثمارها في الدراسات التاريخية[9]. بيد أن الإشكالية لا تزال مستعصية بسبب بقاء بعض الأحداث “الفائرة” تحت المراقبة، وحساسية بعض الوثائق، فضلا عن جملة من الإكراهات التي يتعذّر معها “إطلاق سراح” كل المستندات والشواهد.
يضاف إلى هذه المطبّات المعرفية التي تعترض سبيل مؤرخ التاريخ الآني، مسألة الموضوعية التي هي من أبرز السمات التي ينبغي للمؤرخ أن يتشح بها أثناء مزاولته لحرفته كما تنصّ على ذلك أعراف المدرسة الوضعانيةL’école positiviste . فلا شك أن معالجة حدث يعيش المؤرخ أطوار بنائه، ويتابع لحظاته، تكون له انعكاسات سلبية على أحكامه وتخريجاته التي تتأثر سلباً بضغوطات واختلاف التيارات والأطراف المشاركة في الحدث.
في هذا السياق، نفهم انتقاد المؤرخ الفرنسي، والأب الروحي المؤسس لمدرسة الحوليات “مارك بلوك” أحد أساتذته الذي كان يشيح بوجهه ّعن كل ما له صلة بالتاريخ الحاضر. بل كان يعيب على بعض طلبته دراسة مواضيع تنتمي زمنيا للمرحلة الراهنة، تحت حجة أن هذا التاريخ تاريخ “معاصر جدا” يدنّس عفّة التاريخ بسبب المجادلات والاختلافات والمواقف الذاتية التي يفرضها الحاضر ، والارتجاعات العاطفية التي تستبد بالمؤرخ وهو يكتب عن حقبته، وهو ما لم يكن يقنع التلميذ والمؤرخ الصاعد آنذاك “مارك بلوك”[10] .
بيد أن كل هذه الاعتراضات حول تدخل المؤرخ في فضاء التاريخ الراهن، مردود عليها. وقد كفانا الصديق المؤرخ التونسي فتحي ليسير، مؤونة الردّ بتفصيل على هذه الاعتراضات، اعتماداً على عدد من الدراسات الغربية التي أثبتت نسبية هذه المعوّقات المنهجية المزعومة، وفجاجية الشروط الصارمة التي وضعتها المدرسة الألمانية الوضعانية في القرن 19، والتي لم تعد اليوم مواكبة لدوران عجلة التطور الإبستيمي. واستطاع بقدر كبير من التماسك الحجاجي أن يدحض ما أسماه “البدونات الأربعة” التي يزعم خصوم التاريخ الراهن أنها تنزع عباءة المؤرخ على الباحثين في هذه الحقبة المسماة بالتاريخ الراهن[11].
ونضيف إلى اعتراض الباحث التونسي على حجج خصوم التاريخ الراهن من غياب الموضوعية لدى المؤرخ عند تأريخه حدثا يعايشه، ما أفرزه هذا الموضوع من مناقشات ساخنة في أوساط الفلاسفة والمفكرين في الغرب. فقد سبق أن انتقد “جورج هانز غادامير”Gadamer في هذا الصدد المدرسة التاريخية الوضعانية، واعترض على مطالبتها المؤرخ بالتجرد من أهوائه وذاتيته. فالذاتية وفق بيان “غادامير” وإن لم تظهر في العلن، فإنها تظل تمارس فعلها في الخفاء، بدلا من تمثّلها كموجهات علنية في عملية الفهم والتحليل، فالأهواء هي التي تؤسس موقفنا الوجودي الراهن. كما أن دراسة التاريخ هي في نهاية المطاف عملية تأويلية تستحضر الذات شئنا أم أبينا، ولا تلزم المؤرخ بالانسلاخ عن قضايا الحاضر[12]. ولتجنب استبداد الذاتية في تأويل الأحداث التاريخية، فإنه يحرص على أن تكون عين المؤرخ في أي عملية تأويل موجهة نحو “الشيء نفسه”، لكي يدركه “شخصيا”، علما أن الإدراك هو الذي يساعد على قراءة التاريخ بمقاربة سليمة نسبيا[13].
وعلى نفس المنوال، أكد” بول ريكور”Paul Ricœur نسبية الموضوعية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبيّن بقدر كبير من بُعْدِ النظر، أن ذاتية المؤرخ تتدخل (قصدا أو بغير قصد) في جميع مراحل الكتابة التاريخية. ويتحدّى في نقده للموضوعية التي تزعمها المدارس التاريخية الوضعانية إلى وقوع هذه الأخيرة نفسها في فخّ الذاتية، من خلال إشارته إلى بعض السمات التي تبرز البُعْدَ الذاتي في منهجية روادها. ففكرة الاختيار(اختيار الموضوع)، وحكم الأهمية Jugement d’importance الذي يحكم هذا الاختيار، وتنوع معايير الانتقاء تبعا لنظرية أو لفرضية العمل التي يتبناها المؤرخ، كلها موجهات تتجلى فيها ذاتية المؤرخ، تحت عناوين مختلفة، تعمل خلف الستار ، في أفق ما يسميه ب “التخطيطات السردية”[14].
وإذا كان التاريخ الراهن قد تعرض للإقصاء والرفض، بل وحتى الازدراء ردحاً طويلا من الزمن، فقد بدأ يجني ثمار مشروعيته بعد معركة فكرية أفرزت منجزاً بحثياً محترماً تراكم مع مرور السنين، وتبيّن أن أحداثه ووقائعه توفّر للمؤرخ ما لم توفره له الثروة الأرشيفية في الحقب التاريخية الأخرى. وحسبنا أن راهنية أحداث هذه الحقبة تسمح للمؤرخ من الاحتكاك المباشر بمصادر ووثائق جديدة فجّرتها الثورة الرقمية من قبيل وثائق ويكيليكس ووثائق باناما. كما تتيح له إمكانية الاتصال المباشر بالشهود الذين لا يزالون على قيد الحياة. ناهيك عن استثمار معطيات الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي، وشرائط اليوتيوب، والكتابات الجدارية والرسوم الغرافيتية التي رافقت انتفاضات الشارع العربي إبان أحداث الربيع العربي، ورمزية الشعارات والهتافات المصاحبة للحركات الاحتجاجية ودلالاتها، وغيرها من المصادر ذات القيمة المضافة.
والراجح عندي أن هذه الثورة الرقمية تجعل حقبة التاريخ الراهن غنية الموارد والمصادر، بل محظوظة لا في المجال الأرشيفي التقليدي فحسب، بل في غنى هذا الأرشيف الذي أضيفت إليه ألوان جديدة من الوثائق، تشمل الصوت والصورة وحركات الجسد، والآهات والأحاسيس والعواطف والضحك المرّ [15]، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على مواقف الرأي العام في منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما لا يتاح إلا بقدر ضئيل بالنسبة للحقب الأخرى، بسبب تكتّم المصادر على صوت الفضاء العمومي بتعبير “هبرماس”، حيث تحتكر السلطة كافة وسائل الإعلام.
وبالنسبة للمغرب، ارتبط ظهور التاريخ الراهن- إلى جانب التحولات العالمية الآنفة الذكر- بالانفراج السياسي والحقوقي، وبداية تجربة الانتقال الديمقراطي مع حكومة التناوب سنة 1998، ثم تشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهيئة الإنصاف والمصالحة في بداية الألفية الثالثة. وزاد من الإسراع بوتيرة هذه التحولات على المستوى الوطني، تأسيس أرشيف المغرب سنة 2007، وإقرار دستور 2011، وخاصة فصله 27 الذي ينصّ على حق المواطن في الحصول على المعلومات. وأميل إلى الظن أن جلّ هذه المعطيات تتيح للمؤرخ إمكانية التدخّل في النقاشات المجتمعية الساخنة التي تشكل المفاصل الأساسية للتاريخ الراهن، وضمنها الحرية النسائية المغربية التي سنعالجها في ضوء مستند “خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” .
2- حول مشروعية تفاعل المؤرخ مع أحداث التاريخ الراهن:
نحاول ملامسة إشكالية مشروعية تفاعل المؤرخ في أحداث تاريخ الحاضر، وضمنها الحرية النسائية مدار هذه الدراسة من خلال مقاربتين: أكاديمية وأخلاقية.
- على مستوى المقاربة الأكاديمية: الحاجة إلى مؤرخ التاريخ الراهن:
إن التأريخ للزمن الراهن يشكّل آلية من آليات رفع سقف الجودة الأكاديمية للبحث التاريخي. لا بل إن منسوب قيمة ومصداقيةمؤرخ هذه الحقبة يزداد ارتفاعا، وتعلو أسهمه، لكونه شاهد عيان عمّا يكتب، وله من الملكات الفكرية والخبرة ما يجعله يقرأ الحاضر بخلفية تاريخية، فيساهم في تنوير الرأي العام، والكشف عن الحقائق أو زيفها، والوصول إلى الأحكام التي تكفل للمجتمع الفهم العميق لتعقيدات الحاضر، ورسم شبكة خطاطات المستقبل .
ومع أن بعض المفكرين من طينة “ديكارت” و”بول فاليري”[16]تشككوا في أهمية التاريخ وعدم جدواه في الحاضر، فإن مسالك التفكير تجعلنا نقتنع أنهالحقل المعرفي الذي لا تتوقف الحاجة إليه، ما دام أن موضوعه هو الإنسان. ولا شك أن النقطة المشتركة بين الأحياء والأموات هو تجسيدهم لنوعية الكائن الإنساني المستمر على مدى التاريخ. فالكائن البشري هو الذي يجسّد القاسم المشترك بين عوالم الماضي والحاضر والمستقبل وينسج المترابطات بينها.كما أن الوعي بالزمن الراهن يعني الوعي بالمستقبل، والانكباب على الأسئلة الجوهرية للفترة الراهنة. ونحسب أن عدم فهم الحاضر يتولّد عن الجهل بالماضي، وهو ما يعكسه قول “جاك لوغوف”: (( لا يقتصر الجهل بالماضي على الإضرار بمعرفة الحاضر فحسب، بل يفسد العمل ذاته في الحاضر))[17]. وأن ((من يريد أن يمسك بالحاضر من خلال ما هو راهن، فلن يفهم ما هو راهن )).والمؤرخ الناجح هو الذي يحوّل واقعه المعاش، إلى أداة للتفكير التاريخي.
ولا يخامرنا الشك في أن الحضور المباشر للمؤرخ في قلب الأحداث التاريخية، يرقى بمستوى تحليله لها، ويجعله مشاركا فيها، متفاعلا معها، خاصة إذا كان متملّكا لناصية المنهج العلمي، ولو أن هذه المهمة لا تخلو دروبها من غبس ووعورة في السير. ومع ذلك نعتقد أنها تجربة فريدة، وتمرين شاق ومتجدد بحكم وجود المؤرخ في قلب الوقائع، وبحثه عن الحقائق الثاوية خلفها، ومتابعته الدقيقة لها لحظة بلحظة من داخل الواقعة نفسها. فالانتصار في معركة حربية أو الهزيمة فيها، ليست حدثا تاريخيا يدوّنه المؤرخ ويحلله بناء على المعطيات والوثائق التي تحويها رفوف مكتبته، بل يتحسّس الحقائق ويتسمّعها من المجاورة اللصيقة بالحدث، ومن قلب الميدان الذي جرت فيه، فيتشبّه في سلوكه بالغول الذي يتشمّم رائحة فريسته لاصطيادها عن قرب، بدل النظر إليها عن بُعْد مهما كان حادّ البصر.
لعلّ هذا القرب ومجاورة المؤرخ للحدث، ما يحيلنا على نموذج المؤرخ الفرنسي “مارك بلوك” Marc Bloch الذي ساهم في الحرب العالمية الثانية محاربا ضد ألمانيا النازية، وخلالها ألف كتابه الشهير” الهزيمة الغريبة” L’étrange défaite[18]. لم يكتف “بلوك” في هذا الكتاب بإمساك القلم في يد والأوراق بيد أخرى، بل تفاعل مع مجتمعه وقضية بلده التحررية، فارتدى بذلته العسكرية بوصفه ضابطاً سابقا في الجيش الفرنسي، ودلف إلى ساحة الحرب كمؤرخ وشاهد عيان فاعل ومتفاعل، حيث كان يزوّد ناقلات الجيش بالبنزين، ويلاحظ ويدوّن ويحلّل بعمق ما رآه بعدسات عينيه. ولا شك أن حضوره في ساحة الوغى، جعله يلاحظ قوة وسرعة جيش هتلر، وكيف اجتاح الأراضي البلجيكية والفرنسية عام 1940 بترتيب دقيق وتخطيط محكم، في الوقت الذي كان الجيش الفرنسي يتراجع في حالة فوضى، ومن دون خطة مدروسة.
وفي نفس المنحى العاكس لجدوى للتاريخ في فهم الحاضر بالماضي، وتقديم أجوبة لما يشغل بال الرأي العام، قدّم المؤرخ الفرنسي المتألق “باتريك بوشرون” Patrick Boucheron محاضرة افتتاحية عند ولوجه كوليج دوفرنس Collège de France في درس افتتاحي بتاريخ17/12/ 2017 ، بعنوان ” ما يستطيعه التاريخ؟” ، وفيها حاول أن يفك لغز خلفيات العمليات الانتحارية التي هزت باريس في 13 نوفمبر 2013، وخلفت رجّة كبيرة في أوساط الرأي العام الفرنسي. وفيها أبحر بين مرفأي الماضي والحاضر، ليعثر على إجابات تشغل المواطنين الفرنسيين وغيرهم، مبتدئا بتاريخ السلطة في أوروبا الغربية من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر، وتاريخ توسع العالم في القرن 15، والعلاقات البينية بين الشرق والغرب، ليستخلص أن الحاضر غير منفصل عن الماضي، وأن ((الحقبة التاريخية ما هي سوى زمن نحن من نحدده ونعطيه لأنفسنا، بحيث أننا يمكن أن نستغله كما نريد، أو نتجاوزه، أو ننقله كما يحلو لنا))[19]. صحيح أن الزمن يسير في اتجاه تصاعدي ويخضع لرياح التغيير، ولكنه زمن مستمر متماسك غير مفكك.
ولعلّ ما يزيد من مشروعية عملية ربط المؤرخ بالتاريخ الحاضر، أن مستوى وعي المجتمعات تجاه التاريخ ودور المؤرخ في تحليل المجتمع الراهن والعلاقات بين أفراد المجتمعات قد ارتفع نسبيا، وساهمت الطفرة التكنولوجية والثورة الرقمية في انفتاحها من أجل التعبير عن نفسها أكثر مما كان في الماضي، حيث كانت وسائل الإعلام الرسمية متسيّدة، وجرائد المعارضة محاصرة، بل وحتى مصادرة. والحال أن صوت الرأي العام الذي يحتاجه المؤرخ، والذي ظل مكبّلا دهرا طويلا، فُكَّ نسبيا من أغلاله اليوم، فبدأت دائرة تاريخ المقدسات تتقلص، والطابوهات التاريخية تتساقط، وفضاء الممنوعات يُخْترَق، ومن ثم أصبحنا أمام مجتمعات تنتقل من دائرة الانغلاق والتوتر والانفعال والعنف، إلى مجتمعات منفتحة عن العلوم، تبحث وتنقب وتناقش قضايا تاريخية لم يكن لها وزن في السابق، مما زاد من حاجة المجتمع إلى المؤرخ.
والجدير بالملاحظة أن التأريخ للحاضر ليست فكرة مستحدثة، بل تضرب في جذور الفكر التاريخي.فتأصيل معايشة المؤرخ للأحداث التاريخية وتدوينها، واستشرافه للمستقبل في ضوئها، أمر لا تخطئه العين الفاحصة. فبالرجوع إلى الإسطوغرافيا القديمة والوسيطية، يتضح أن فكرة التأريخ للحاضر، لم تكن غائبة عن فكر بعض المؤرخين المتميزين من أمثال المؤرخ اليوناني “هيرودوت” الذي كان شاهد عيان على “حاضره” آنذاك، وتوغّل في معرفة أحداث زمنه، فأفلح في تشخيص النسيج الداخلي لمجتمعه، انطلاقا مما رأى وسمع، فدوّن تاريخا حاضريا في غاية الأهمية.
ولا تعوزنا الأدلة عن مساهمة العقل التاريخي الإسلامي بمنجزه التراثي الضخم ما يؤكد تهمّم بعض المؤرخين القدامى أيضا بالتأريخ لحاضرهم ، وتشخيص ومتابعة متغيراته ، والإمساك بخيوط التحولات التي شهدتها عصورهم. نستحضر في هذا الصدد مؤرخين من طينة المسعودي والطبري وابن خلدون وابن حيان وابن الخطيب وغيرهم ممن عاشوا في قلب الوقائع والأحداث الكبرى، فأرخوا تأريخا عيانيا لعصرهم، وفهموا زمنهم فهماً شموليا بمعايشته، والتفاعل مع وقائعه، واستنطاق أحداثه استنطاقا مباشرا، وتحيين مستجداته، فاستطاعوا أن يدركوا منعرجاته وتموجاته. كما عبّروا عن مواقفهم وردود أفعالهم، فغدوا بتلك الصفة شهود عيان على زمنهم، وترجموا ما بدواخلهم و في وجدانهم وأحاسيسهم وملاحظاتهم وانطباعاتهم ما أَثْرَوا به المادة التاريخية، وأفاضوا في تزويدنا بالنصوص والروايات المعاصرة والوثائق المباشرة.
أما في الزمن الراهن، ومنذ سقوط جدار برلين في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، واكتساح الثورة التكنولوجية، والقفزة التي حصلت في مسار التطور المعرفي، وانفتاح التاريخ وتداخله مع العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتغيّر التحقيبات التقليدية، فلم يعد الشك يحوم حول فكرة التاريخ الحاضر، بل حصل على اعتراف جماعي بأنه ((تاريخ مثل التواريخ الأخرى ))[20] ، مما جعل الباحثين يتحدثون عن شرعية ما أسماه فرانسوا هارتوغ بالحاضرانيةLe présentisme[21].
ب- على مستوى المقاربة الأخلاقية: شرف مهنة المؤرخ
يذهب المؤرخ الفرنسي “مارك بلوك” في بيانه التاريخي إلى أن التاريخ ليس إشكالية فكرية وعلمية فحسب، بل هو أيضا قضية تكتسي بُعْداً أخلاقيا[22]،ومن ثمّ تبدأ مسؤولية المؤرخ المعرفية المتماهية مع قضايا مجتمعه في الحاضر كما في الماضي، لتجعل منه مثقفا عضويا يخوض معركة القيّم.
فالمؤرخ وفق هذا البيان لا يعيش بمنأى عن مجتمعه، أو بمعزل عن القضايا الساخنة التي تحفر مجاري التغيير الجارية تحت سمعه وأمام بصره، بل يمارس مهنته (( من خلال الاتصال الدائم مع واقع اليوم ))[23]، كغلاء الأسعار، وورشات إصلاح التعليم، ويقدّم آراءه في التنمية، وتطوير الإبداع والابتكار. كما يمكن أن يكون مشاركا في الاحتجاجات في الشارع والساحات العمومية، ليعريّ كافة أشكال الفساد والاستبداد. ويمكن كذلك أن يكون نشيطا من دعاة السلام، ومساهما في ترسيخ قيّم حقوق الإنسان، متجاوزا السؤال الإبستيمولوجي للتاريخ، ليصبح مؤرخا “مناضلا” يتحمل مسؤولياته، ويدخل بقوة في ساحة النقاش، فيدلي بدلوه دفاعا عن الحرية والعدالة، وعن الحق والحقيقة…يقتحم معركة الكرامة الإنسانية، ويجعل من إضاءاته التاريخية طاقات تعبيرية تنطق بالمبادئ والقيّم الأصيلة التي تستنهض إنسانية الإنسان. وتجعله ينخرط في جبهة الوازع الأخلاقي لاستثمار قدرات الروح الكامنة في أعماق البشرية، ومقاومة الظلم والتبعية والاستعباد الذي تستنبته وتوسع رقعته الرأسمالية والعولمة المتوحشة باستمرار، بهدف تأسيس عالم عادل، واعد بالخير والفضيلة والعدالة الاجتماعية.
وبدون هذا ” الحراك ” الملزم، لا يكون المؤرخ وفيّا لحرفته، وبالتالي ماذا يبقى له من شرف المهنة إذا لم يندمج مع أحداث زمنه، ويغطس في قعرها، وينبش في مشاكل الحياة اليومية، ويتفاعل معها بعمق من أجل الفهم والإدراك؟ كيف يبقى منشدّا للماضي في زمن ألغت فيها الثورة الرقمية والتكنولوجية المسافة الزمنية بين الماضي والحاضر، وأصبح تاريخ الزمن الحاضر يتشكّل أمام أعين المجتمع؟.على المؤرخ أن يتفاعل مع مشاكل مجتمعه، ويقدم ” كشف حسابه” للقراء بتعبير “مارك بلوك”، ليحوّل علم التاريخ إلى علم للتغيير[24].
صحيح إن مهمته تكمن أساسا في البحث عن الحقيقة، غير أن الحقيقة التاريخية لا تنفصل عن الحق وعن الحياة، بل هي عبور لساحة الدفاع عن الحق. فإذا كانت الحقيقة غاية علم التاريخ، فإن المسؤولية الأخلاقية هي منتهاه[25].
ووفقا لهذه الرؤية الملتزمة، نعتقد أنه بقدر ما تحاول دراستنا البحث عن حقيقة أسباب الجدل والخلافات الناتجة عن ظهور خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية بين أنصار المرجعية الإسلامية، والحداثيين الناهلين من مرجعية المواثيق الدولية، فإنها نبحث في العمق عن حقوق نساء المغرب في الحرية، من منطلق الالتزام والمسؤولية الأخلاقية.
لقد وعى الغرب منذ عقود بأهمية التاريخ الراهن، وبمركزية دور المؤرخ كمشارك في صنع القرار، وخبير ينصت المجتمع السياسي لأفكاره، حتى أصبح الجميع يقرأ للمؤرخ، وصارت كتاباته تصل إلى المتلقي عبر مختلف الوسائل، لتتحوّل إلى نقاشات ساخنة حول قضايا الساعة من تحليل للأزمات الاقتصادية، وتفسير لمشاكل الهجرة والبيئة والانتخابات، وتطور الأحزاب السياسية، بل صار يُسْتَدْعى لقاعات المحاكم ليدلي برأيه، ومن ثمّ أصبحت الخبرة التاريخيةL’expertise historique تحت الطلب، بل أحيانا مؤثرة في الرأي العام[26].
ولم يشذّ المجتمع المغربي عن هذه التحولات، فمنذ بداية الألفية الثالثة، أخذت القضايا الكبرى التي كانت ممنوعة في سوق التداول، أو جرى تمييعها أو تهميشها على الأقل، تطرح من جديد: فمبادرة الإنصاف والمصالحة تطلبت العودة للأحداث: أحداث سنوات الرصاص، صور التعذيب، الشواهد الطبية، الاستماع إلى أصوات ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وتسجيل الروايات الشفهية والشهادات. بمعنى أكثر دقة، استلزمت المبادرة العودة إلى التاريخ الحاضر ، وإلى المربع المسكوت عنه، بِعُدَّة وثائقية مباشرة، يحضر فيها الصوت والصورة والألم والإحساس، وحتى البكاء الذي يحكي وحشية الافتراس، والحاجة لإعادة حقوق الضحايا.
نفس القول ينسحب على حركات الاحتجاج، وخاصة احتجاجات الريف ومعضلة تنميته التاريخية، حيث طالبت بعض أصوات الرأي العام بحضور أساتذة التاريخ الجامعيين المتخصصين في تاريخ الريف إلى قاعة المحكمة للاستماع إلى آرائهم حول الدوافع التاريخية التي أدت إلى الحراك الاجتماعي بتلك المنطقة المهمّشة. وقِسْ على هذه المواضيع الساخنة في تاريخ المغرب الراهن موضوع حقوق المرأة وحريتها الذي هو مركز هذه الدراسة .
الحاصل أن دحض جلّ الاعتراضات التي وجهت لمؤرخي التاريخ الراهن، فضلا عن سخاء المعطيات الرقمية والتكنولوجية التي رفعت من كمية المعلومات والمواد الإعلامية التي يحتاجها المؤرخ، وظهور حاجة المجتمع المدني المغربي إليه ليكون شاهدا على العصر رغم تهميشه من قبل الجهات المسؤولة، كل ذلك يعطي المبرّر والمشروعية لدراسة الحرية النسائية بالمغرب كموضوع في التاريخ الحاضر، اعتمادا على مستند مشروع “خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، والمواقف التي تولدت عنها، مما يسمح بمعالجته في ضوء رؤية تاريخية. لكن إلى متى يظل المؤرخ للحرية النسائية في الزمن الراهن مرتديا عباءة الحياد؟
3- حول الحيادية في قضايا راهنية والمسؤولية التاريخية للمؤرخ:
إذا سلّمنا بأن مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية يجسّد وثيقة أو مستندا تاريخيا، فسيشكل بالأحرى حجر الزاوية في دراستنا، إلى جانب وثائق أخرى أو مستندات ومواثيق دولية، ومؤلفات وخطب وتصريحات وكتابات صحفية وبيانات، سنبني عليها تركيبنا لهذا العمل للإجابة عن الأسئلة السالفة الذكر، والتي وصفناها بالأسئلة الحارقة، بسبب ما تتضمنه من تحديات لمفاهيم ومقولات تندرج في خانة الطابوهات والممنوعات المتصادمة مع تشريعات دينية، أو حتى مع القيّم الاجتماعية والأعراف السائدة.
ومن الإنصاف القول منذ البداية، أن تعاملنا مع هذه الوثائق لا يمكن أن يكون تعاملا حياديا مطلقا. فمثل هذه الوثائق التي نؤسس عليها دراستنا إلى جانب وثائق معارضة وكتابات أخرى تصطف مع هذا الطرف أو ذاك، تفرض علينا منهجيا طرح بعض الأسئلة، واستحضار بعض الوقائع التي لا نسعى لجمعها فحسب، بل فهمها وتفهمها في ضوء المرجعية التراثية والحداثة معا، ما دامت المرجعيتان معاً شكّلتا الخيوط الناظمة لأدبيات الأطراف المتدافعة.
وتأسيساً على ذلك، لن يكون تعاملنا مع هذه المستندات التاريخية المعتمدة تعاملا يقوم على التحليل الصارم للوقائع بكيفية تقنية مجردة، أو تغييبا للطابع الأخلاقي في معالجة الأحداث ونتائجها، ولا حتى لعب دور المدعي العام أو هيئة الدفاع. بل سيتمّ بحث الوقائع بهدف كشف دلالاتها المتوارية وراء النوايا، سواء كانت سياسية أو حزبية أو إيديولوجية. علما أن هذه النوايا لا توجد على قارعة الطريق، بل تستلزم التنقيب والتحليل والبحث عن آليات للتفسير، وصولا إلى إجابات تقربنا من نتائج ظهور ذلك المستند أو تلك الوثائق، بما فيها الوثائق المعارضة، وما خلفته من نقاشات صاخبة، ووقع كبير على المجتمع، ثم الوقوف على كيفية تدبير العقل المغربي بكل مكوناته لهذا الحدث المفصلي.
بيد أننا ونحن نسعى إلى تقديم هذه الوقائع التي أفضت إلى ظهور خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية كأحداث تاريخية في الزمن الراهن، لا يمكن أن ننفلت من آثارها كمعركة للقيّم، تتوخى الانتصار للحقيقة والحق، ضدا على الافتراءات والإيديولوجيات الماسخة، وأن نقوم بالتقييم والنقد الذي يتطلبه الموقف. إنها معركة تنطلق من حرية واستقلالية فكر المؤرخ، لتتوغّل في عمق الحرية النسائية مدار هذا البحث. إنها باختزال شديد معركة أخلاقية أو كما يسميها مارك بلوك ” أخلاقية المهنة “. فالمؤرخ لا تكتمل قامته كمؤرخ ماسك بناصية الوثائق والنصوص فقط، بل كمؤرخ قيمي- أخلاقي وعادل، علماً أن التاريخ الجديد فتح أمام البشر طريقا جديدا نحو ما هو حقيقي وبالتالي نحو ما هو حق[27].
بهذا الخيط الموجه الذي يصبو إلى التوليف في البحث عن بعض الحقائق لتأكيد حق المرأة في الحرية، سنتصدى لمعالجة الموضوع في شموليته ومن كافة واجهاته. فلنبدأ أولا بدراسة السياقين الداخلي والخارجي اللذين كانا وراء ظهور مشروع “خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”.
[1] بياض، الطيب، الصحافة والتاريخ، إضاءات تفاعلية مع قضايا الزمن الراهن، ط2، دار أبي رقراق، الرباط 2019، ص 12. وينظر تحديدا مبحث: التاريخ بأقلام صحفية، ص 51- 57 حيث أعطى الباحث نماذج من الصحفيين- المؤرخين الذين كتبوا التاريخ، وخصوصا التجربة المغربية المتمثلة في الصحافي محمد الباهي، ص 55-57 والتجربة الفرنسية المتجسدة في فرانسوا فوريه François Furet ص74- 50.
[2]المرجع نفسه، ص 48.
[3]Frachon, Alain, « David Halberstam, journaliste, historien et essayiste », Article Publié dans Le Monde, le 27 avril 2007, consulté le 19 /5/ 2018 dans :https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2007/04/27/david-halberstam-journaliste-historien-et-essayiste_902815_3382.html.
[4]Amouroux, Henri, La Grande Histoire des Français sous l’Occupation, éd. Robert Laffont, 10 volumes, 1976-1993.
[5] بوتشيش، إبراهيم القادري،”مواطن القوة والضعف في الشهادات الشفهية: دراسة تطبيقية في تاريخ المغرب الراهن ( 1973- 2005)” ، بحث نشر ضمن كتاب التاريخ الشفوي: المفهوم والمنهج وحقول البحث في المجال العربي، ط1، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة 2015 ، ج1، ص 163 – 200.
ينظر أيضا: بوتشيش، إبراهيم القادري، “الربيع العربي كحلقة جديدة في التحقيب التاريخي: الإرهاصات التأسيسية لكتابة تاريخ غير مدوّن”، نشر ضمن كتاب : التاريخ العربي وتاريخ العرب: كيف كتب وكيف يكتب؟ الإجابات الممكنة، ط1، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 2017، ص 101- 145. وانظر أيضا دراسة أخرى للباحث نفسه بعنوان: “سؤال تجديد أدوار المثقف في ضوء تحولات الربيع العربي: دور التواصل الشبكي والميداني كخيار استراتيجي”، نشر في كتاب: دور المثقف في التحولات التاريخية، أعمال المؤتمر الرابع للعلوم الاجتماعية والإنسانية، ط1، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 2017، ص 601- 636.
[6] الريسوني، أحمد، مقالات في الحرية، ط1، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة 2014، ص 10- 11.
[7]Soulet, François, L’histoire immédiate, PUF, Paris, 1994 ; Chauveau, Agnès, Tétart, Philippe (dir), Questions à l’histoire des temps présents, Bruxelles, Ed Complexe 1992.
[8] ليسير، فتحي، تاريخ الزمن الراهن: عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر، منشورات جامعة صفاقس، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، دار محمد علي للنشر، ط1 ، صفاقس- تونس 2012 ، ص67 .
[9]Bedarida, François,” Méthode et pratique de l’histoire du temps présent”, Correspondances, Bulletin de l’IRMC, no 42, Octobre 1996, p6.
[10]بلوك، مارك، دفاعا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ، تقديم جيرار نوارييل وجاك لوجوف، ترجمة وتقديم أحمد الشيخ، ط2، منشورات المركز العربي – الإسلامي للدراسات الغربية، القاهرة 2013، ص 112.
[11] للمزيد من التفاصيل حول الرد على اعتراضات المنتقدين لتاريخ الزمن الآني، انظر ليسير، تاريخ الزمن الراهن…م.س، ص 71- 79.
[12]Gadamer, Hans- Georg, Vérité et méthode, les grands lignes d’une herméneutique philosophique, Paris- Aubier 1982, p 303.
[13]فرّو، قيس ماضي، المعرفة التاريخية في الغرب، مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية، ط1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 2013، ص57.
[14]درويش، حسام الدين، إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا بول ريكور وعلاقتها بالعلوم الإنسانية والاجتماعية: نحو تأسيس هيرمينوطيقا للحوار، ط1، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 2016، ص380.
[15] ينظر: بوتشيش، الربيع العربي…..م.س، ص 133- 136.
[16]Valéry, Paul, Regards sur le monde actuel, Gallimard, collection “Idées”, Paris 1945, p 35.
[17] تقديم جاك لوجوف لكتاب مارك بلوك: دفاعا….م. س، ص 69.
[18] ترجم هذا الكتاب للغة العربية من طرف الباحثة عومرية سعيد سلطاني ، ونشره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة ترجمان، بيروت 2021.
[19] بوشرون، باتريك “ما يستطيعه التاريخ “، ترجمة جلال الحكماوي، الدار البيضاء 2018، ص 9- 10؛ بياض، الصحافة…م.س، ص18.ينظر نصّ المحاضرة في الموقع الإلكتروني لرباط الكتب:
[20]Prost, Antoine,” L’histoire du temps présent : une histoire comme les autres “, Bilan et perspectives de l’histoire immédiate, dossier du no 30-31 de Cahiers d’histoire immédiate, 2006-2007,p 21-28.
[21]Hartog, François, Régimes d’historicité, présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil 2003, p55
مرجع مذكور عند: ليسير، تاريخ الزمن الراهن…..م.س، ص 29.
[22] بلوك، دفاعا….م.س، ص 58.
[23]المرجع نفسه، ص 69.
[24]Bloch, Marc, Apologie pour l’Histoire ou métier d’Historien, Arman Colin, Paris 1993, p 24.
[25]Ibid, p 28.
[26] ليسير، تاريخ الزمن الراهن….م.س، ص 95.
[27] تقديم جاك لوجوف لكتاب مارك بلوك، دفاعا….م.س، ص 74