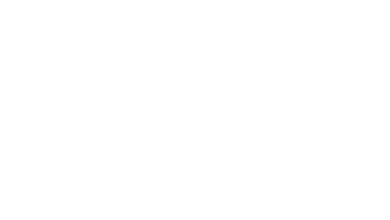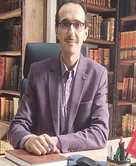المشروع الإصلاحي لابن الأعرج (عبد الرزاق بنواحي)
تقديم
حظي مفهوم الإصلاح بالعالم الإسلامي عامة وبالمغرب خاصة خلال بداية القرن العشرين باهتمام كبير من طرف النخب العلمية والفكرية التي اهتمت بمجالاته وأبعاده. واتخذ أسماء مختلفة كالنظام والتجديد والتحديث وغيره . كما تم تحديد زمنه التاريخي بلحظة الاصطدام بأوربا خلال بداية القرن التاسع وما أسفر عنه ذلك من تحولات على مستوى بلدان المجال المتوسطي وبلاد المشرق ودول المغارب.
كما أن استعمال مصطلح الإصلاح بالمغرب تم تداوله في مجالات متعددة ،منها ما هو مرتبط بما هو مادي كالإصلاح العسكري ،والتقني ونقل المعارف الجديدة، وتعريف مرتبط بإصلاح الفكر ،والسلوك، أطرته السلفية الإصلاحية التي بدأت بالحجاز ثم انتقلت إلى المشرق العربي ودول المغارب، وهذا الإصلاح الذي هو نقيض الفساد، ارتبط وجوده بظهور الأنبياء والرسل الذين بعثوا من أجل الإصلاح والتغيير ضمن توجيهات ربانية منصوص عليها في القرآن والسنة. والمتفحص لكتاب الله يجده مليئا بالآيات التي تدعو إلى إصلاح السلوك ومحاربة الفساد الديني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
لذلك اختلطت إثر “صدمة الحداثة” مفاهيم الإصلاح والتحديث، وتقاطعت معانيها في مجالات عديدة فمن جهة كانت فاجعة الهزيمة سببا في استفاقة الشعوب، والنخب ،للبحث عن سبل إنقاذ البلاد من التهديد الأجنبي. وتعالت أصوات الإصلاح خلال هذه الفترة ،ومن جهة ثانية دب الاختلاف بين النخب العلمية والسلطة حول توجهات هذا الإصلاح. ويعتبر السليماني من المصلحين المغمورين بالرغم من إنتاجه الفكري ومساهماته الإصلاحية.
ومن خلال هذه المداخلة سنحاول إبراز جوانب من فكره وتدخلاته . إذ يعتبر من الذين ساهموا في تحليل أسباب تخلف المغرب ،من خلال تدخلاته على مستويات مختلفة من أجل النهوض والإصلاح ومواجهة المد الاستعماري ،في شقيه العسكري والفكري ،والدعوة إلى بناء الذات عبر الاجتهاد ،ونبذ التقليد ،والاستفادة من التاريخ . فمن هو السليماني إذن وما هي مشاريعه الإصلاحية؟
أ. التعربف بشخصيته وسيرته:
1. سيرته وحياته
هو أبو عبد الله محمد بن أبي عبد الله محمد السليماني الحسني الفاسي، ولد ونشأ بمدينة فاس سنة 1285هـ/1868م تلقى تربيته الأولى على يد والده وتعلم تحت رعاية شيوخ فاس المشهورين، وهو من أسرة عريقة في المجد والصلاح تعرف بأولاد محمد بن يحيى من غريس في أحواز تلمسان . انتقل جده إلى فاس سنة 1260/1930م،ويتصل نسب أسرته بسليمان بن عبد الله الكامل جد بعض شرفاء المغرب الأوسط الذين ترجم لهم السليماني في الجزء الأخير من كتابه زبدة التاريخ. وتتلخص تربيته في حفظه للقرآن على يد أحد شيوخ مدينة فاس، السيد أبي العباس أحمد بن محمد الفشتالي، وكذلك حفظه لأمهات الكتب وكل ما تيسر له من العلوم. كما يعتبر والده محمد بن عبد القادر السليماني أهم مصدر له في تعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية من فقه وحديث وتوحيد وغيرها.
ولما بلغ من العمر حوالي عشرين سنة، انخرط بجامعة القرويين ، وانكب على حضور الحلقات العلمية الموزعة بين دراسة كتب الإمام مالك في الفقه، ومختصر خليل وصحيح البخاري، بين القرويين والحرم الإدريسي، على يد شيوخ وعلماء مشهورين كمحمد بن التهامي بن المدني جنون، ومحمد القادري، ومحمد بن الكبير الإدريسي، وابن صالح العامري، وأحمد بن الجيلاني المغاري وأبي عبد الله محمد بن التهامي الوزاني، وأبي عبد الله الشيخ حماد بن عمرو الصنهاجي، وأبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري الحسني وغيرهم من الأعلام.
اشتهر السليماني بقصائده الحماسية، التي شجب من خلالها ممارسات المستعمر، وحث فيها المغاربة على النهوض ماديا ومعنويا لفك العزلة السياسية عن أنفسهم وذلك بقصائده المطبوعة بروح الوطنية الصادقة والنزعة الدينية التحررية، وخير مثال على ذلك ما نظمه إثر انتصار الأتراك على اليونان في معركة “أزمير” ونظم في ذات المناسبة قصيدة سماها “تركيا الجديدة” علقت عليها الصحف العربية والإسلامية آنذاك بقولهم: “صوت آت من المغرب”، وقد تسببت له قصائده الشعرية مضايقات عديدة، بلغت ذروتها لما اندلعت المقاومة بالريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي ضد الإسبان وهزيمة هؤلاء بواقعة “عروي”. حيث تفاعل السليماني مع هذه الأحداث تفاعلا إيجابيا على غرار باقي المغاربة، فنظم على إثر ذلك قصيدته المشهورة التي مطلعها : “دع الفتيان تمرح في القصور” وقد بادرت صحيفة “العهد الجديد” التونسية إلى نشرها بتوقيع السليماني. توفي السليماني سنة 1344/1926م بمدينة فاس مخلفا إنتاجا علميا وتاريخيا مهما لازال حبيس الرفوف في الخزانات العامة والخاصة باستثناء ما تم نشره في حقل التاريخ.
2.إنتاجه العلمي:
• “اللسان المعرب عن تهافت المعمرين حول المغرب” وهو أول ما ألفه السليماني كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه “زبدة التاريخ..”. لخص فيه أخبار المغرب الأقصى والأوسط وعلاقات حكامه مع الأجانب في الأندلس، وفي القسم الأخير قدم فيه رؤية حول ما يجب تناوله من العلوم العصرية وموقفه من الحرية والمدنية. وقد انتهى من تأليفه سنة(……؟…) ويعتبر هذا القسم مهما بالنظر إلى دعوته التحديثية في إصلاح التعليم. وقد نشر هذا الجزء دون تحقيق بمطبعة الأمنية بالرباط سنة 1971 بمبادرة ابن المؤلف عبد الملك السليماني.
• “زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ” يتكون من أربعة أجزاء، تناول في الجزء الأول تاريخ شمال إفريقيا وممالكها ومآثرها، وقد انتهى من تأليفه يوم 6 جمادى 1343هـ.، وتعرض في الجزء الثاني لتاريخ المغرب الأوسط ،وقد انتهى من تأليفه يوم 18 ربيع الثاني سنة 1344 /1926م كما أشار لذلك في الصفحة الأخيرة من الكتاب. أما الجزء الثالث فقد تحدث فيه عن بقية أخبار المغرب الأدنى ، تونس وليبيا،
• في حين تحدث في الجزء الرابع عن فلاسفة أوربا وأمريكا وإسهاماتهم في مشروع النهضة الحديثة وعن الصراع بين رجال الدين وعلماء النهضة الأوربية، مشيدا بدور العلماء المسلمين وإسهاماتهم في نهضة أوربا كذلك. كما ذكر بعض المخترعات الحديثة في المجالات المختلفة ثم قدم ردودا لدحض مزاعم بعض مفكري الغرب وأقوالهم عن الإسلام .
كما ترجم في هذا الجزء لمعظم الشيوخ الذين أخذ عنهم وتربى على أيديهم. علاوة على شروح كتبها على هامش بعض القصائد الشعرية ، كما ألف دليلا شرح فيه مناهج التدريس بالمدرسة الحرة التي أسسها بفاس، حيث ضمنها توجيهات وإرشادات حول التعليم ،والتلقين، وبرامج المواد الدراسية ؛وحصصها اليومية ،ونماذج من دروس القراءة والكتابة ،ودروس القرآن الكريم ،والدين والتربية الخلقية ،ومبادئ العلوم العصرية، إضافة إلى مواضيع ومقالات في مجالات اقتصادية وسياسية، واجتماعية وفلسفية تبرز حقيقة رؤيته الإصلاحية التي نحن بصدد التنقيب عنها واستنباطها من مؤلفاته السالفة الذكر.
فيما يخص المرجعيات التي يرتكز عليها الفكر الإصلاحي عند السليماني فهي متنوعة حسب تنوع المواضيع التي تناولها في كتاباته. وتعتبر المرجعية الدينية من أهمها، لكونها تطغى عليه في كل كتاباته، بل جعلها على غرار باقي المفكرين، الذين عايشوا نفس الواقع ونفس الأحداث، مصدرا لمعارفه وأفكاره. وأثناء تقديمه وشرح لقصيدة التيجيني الصوفية صرح بانتمائه للمذهب السني المالكي المغربي، كما أن تربيته ونشأته وتعليمه، ساهمت في تبلور تلك الرؤية وإفراز ذلك المنهج. وللسليماني أيضا، اهتمامات أخرى في مجالات العلوم الإنسانية، تحيلنا إلى مرجعيات أخرى إضافية تتجلى في اهتمامه الكبير بعلم التاريخ، وفلسفته ،مما يدل على انه تأثر بالفكر التاريخي عند المسلمين، وخاصة ابن خلدون ،الذي أحال عليه في كتاباته، إضافة إلى اهتماماته الفلسفية وتأثره الملحوظ بالفلسفة الغربية وخاصة فلاسفة عصر الأنوار مما جعله يتحدث عن مواضيع لها علاقة بالعدل ،والحرية ،والعلم ،والسياسة ،والحقوق المدنية. ومن مرجعياته كذلك التي استند عليها في كتاباته الإصلاحية، انخراطه في تحليل بعض القصائد الصوفية. أضف إلى ذلك مقاربته الشعرية، من خلال اهتمامه بأغراض شعرية تخدم توجهه الفكري، وخاصة بعض قصائده المرتبطة بدعوته الإصلاحية، التي تجمع بين الحماسة والروح الدينية والوطنية.
وقد حدد مواطن الضعف في الخلل الحاصل عند كثير من الناس بسبب إعراضهم عن منهج السلف في التغيير. ورأى أن أوربا عملت على تطوير أساليبها التقنية ،واستعدت استعدادا قويا لكي تحسم الموقف لها في النهاية. كما يصور دائرة الصراع ليس فقط في عدم تكافؤ القوة المادية في السلاح ،ولكن تشمل في نظره القوة العلمية والقوة الاقتصادية وسماها بـ: « قتال بلا سيوف ولا رماح».
كما يلخص السليماني رؤيته للتاريخ وهدفه من كتاباته من خلال قوله في هذا الصدد « لقد فسد مزاج هذا المغرب وتغير والمعروف منه تنكر، وكل زعيم شرخ، وباض الشيطان في دماغه وفرخ، وجمدت الأفكار وكثرت الأشرار، وسقطت الهمم العالية وتنوسيت العوائد السامية ،وأهمل أبناء الزمان دراسة التاريخ الذي هو أساس طبيعة العمران على ممر الزمان. لا جرم أن بدراسته تتأدب الأجيال وبتعاطيه تتهذب منهم الأفعال، إذ يعمد اللبيب لمحاسن من مضى فيرتكبها، ويمج ذوقه مساويه فيرفضها، سيما من سمت همته لفلسفة التاريخ التي تمثل الأعمال الجليلة في أوج المعالي والكمال، وتشخص المساوي في مهاوي الانحطاط والضلال. فأنت ترى فن التاريخ اليوم نضب ماؤه، وتكدر صفوه ورواؤه، وعادت رجال المغرب تنفر من معينه وتسأم. وكسد جوهره في سوقهم فلا يسام بدينار ولا درهم. وقد تكسد اليواقيت في بعض المواقيت. ».
يبدو أن الحدث التاريخي الذي عرفه المغرب كان يستدعي الوقوف للدراسة والتحليل أكثر من جمعه ولفه في كتاب حتى يتسنى لنا الاستفادة منهما استفادة عملية. ذلك ما أراد أن ينبهنا إليه السليماني من خلال تعبيره هذا، وثم هدف آخر يحثنا على الاهتمام بالتاريخ هو الإهمال الذي لقيه لدى أبنائه ونفورهم منه وذلك راجع لكونهم لم يدركوا بعد قيمته التي لاتسام بدينار و لا درهم، حسب السليماني.
هكذا إذن يطرح السليماني الاهتمام بالتاريخ وفلسفته وهي رؤية ميزته عن بعض معاصريه بشهاداتهم أنفسهم. وذلك بسبب الأفكار التي طرحها والمنهجية التي تناول بها تحليل هذه الأفكار، وفيما يلي بعض شهادات معاصريه حول إنتاجه وفكره ،لتسليط الضوء أكثر على هذه الشخصية وتميزها. فبعد انتهاء السليماني من كتابة “اللسان المعرب” في 10 محرم 1330ه/1908م، بفاس، تلقى مجموعة من التقاريظ لمؤرخين وعلماء وكتاب معاصرين له نوهوا من خلالها بما تضمنه الكتاب من أفكار تحديثية وإصلاحية جديدة. فوصفه أحمد بن المأمون البلغيثي( 1865-1929م) بالمؤرخ السياسي الناصح للأمة. ورأى أن الأمة في حاجة إلى الاهتمام بما طرحه من أفكار بغية الخروج من أوحال التقهقر والانحطاط. كما دعا عبد العزيز محمد بناني إلى نشر وتدريس وتأليف ما طرحه السليماني « فما أحوج أهل وقتنا إلى تصدي علماء بلدتنا إلى نشر وتدريس وتأليف ما أشار إليه ». وأشار أحمد بن محمد الخزرجي إلى أن المؤلف طرح أفكارا غريبة لم يعتدها الناس ووصف كتابه ب « الغريب الفائق في الحسن والإتقان». ودعا بدوره إلى النسخ على منواله قائلا: « فما أحوج أهل العصر إلى الكرع في حياضه وتنزيه الطرف في بديع رياضه». ويرى عبد السلام بن محمد الطيب الشرفي أن السليماني جاء بشيء ميزه عن أقرانه بما فيه من الفوائد التي تنم « عن سعة علمه وطول باعه». أما أحمد ابن المواز (توفي سنة 1341هـ/1922م ) فيرى في تقريظه أن المواد التي تعرض لها المؤلف متميزة ومليئة بالعبر والمواعظ أراد بها السليماني تبصرة العموم قصد الاهتمام بالأعمال العصرية وحضارة الأقطار الأخرى. وأضاف بأنه ركز على بعض المسائل العقلية والنقلية والملح الاقتصادية وبذلك يرى أن الكتاب روضة ذات أزهار «مع إيجاز شيق واختصار أنيق..». وقد دعا محمد الحجوي ( ت: 1375هـ/ 1956م ) – بعد الإشادة بالمؤلف – المغاربة إلى إمعان النظر في دعوة المؤلف ونفض غبار الكسل عن عقولهم لأن المجد في العلم والتربية المستقلة عن المستعمر للحفاظ على الهوية وتوجيه التدريس إلى تخصص الأبناء في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والفكرية وإتقان هذا التخصص. أما محمد بن الحي الكتاني (توفي سنة 1382 هـ/ 1962م) فيرى في مؤلفه حض على الأخذ والتمسك بأمور العصر من الصنائع النافعة ووصف المؤلف بالعبقري الأوحد المطلع على أحوال الوقت. هذه الشهادات التي أوردناها هي في جوهرها مكملة لما قلناه عن المؤلف وإنتاجه. وتتجلى أهميتها، كما أسلفنا في كون قائليها معاصرين له.
ب. التعريف بمشروعه الإصلاحي
تناول السليماني معضلة التخلف التي لحقت بالمغاربة بسبب إهمالهم للتاريخ الذي اعتبره من أسس التنمية والرقي الحضاري ، وسنقتصر في هذه النقطة على الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتعليمي الذي تحدث عنه السليماني في بعض كتاباته.
1. الإصلاح الاقتصادي عند السليماني.
يربط السليماني أمر إصلاح الوطن بدور “الفضلاء والأمناء الأحرار من الرجال” المطالبون بوحدة الفكرة والتوافق عبر الاجتهاد والاستعداد الديني والعلمي المنبثق من قوله تعالى ” وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ )
مصطلح الاطلاع الذي ذكره السليماني يعني الاحتكاك ودراسة التراث الأوربي اقتصاديا وعلميا، واقتباس كل ما هو مفيد فيه على غرار ما قام به علماء العرب من بغداد وقرطبة ،واستردادها عبر طرق علمية حديثة تبدأ من الترجمة إلى مرحلة تطبيق كل ما يمكن تحصيله من علوم ومعارف وتكنولوجيا تاركين مفاسد الغرب المنافية للآداب والدين، وبهذه العملية نكون فعلا قد حققنا ما أسماه السليماني “بالاستعداد للطوارئ”.
ومن أصول الاستعداد يقرر السليماني أن تلقين العلوم الصناعية يعتبر فرض كفاية على أفراد الأمة، ويبين ذلك بوضوح أكثر عندما يركز على أن الآلة الحربية ،سواء كانت سيوفا ،أو رماحا ،أو مدفعا ،أو بارودا أصله من المعادن المستخرجة من باطن الأرض ،وهي كمواد أولية لابد لها من مختصين وعارفين لاستعمالاتها المختلفة . وتمر هذه المعرفة بمراحل مختلفة من عملية التصفية (تصفية معادن الذهب والفضة)، التي تكثر النقود الوطنية ،وتعظم ثروة الأمة لتصير قادرة على مناهضة ما سواها ،وانتهاء بكيفية تسويق هذه المواد وتصريفها . كما يثير السليماني الانتباه إلى أصل آخر من أصول الاستعداد الاقتصادي ،والمتمثل في التركيز على ما سماه بـ “معرفة صناعة الفلاحة وترقيتها..” .هذه الترقية التي تعني تنميتها من أجل الاستغناء نهائيا ،أو جزئيا عن بضائع الغير.
واستغناء الدولة عن غيرها من شأنه أن يسهم في بلورة سياسة حمائية تعمل على تقوية، وتنمية إنتاجها الداخلي ،واستغلال موادها الخام وبذلك ستفتح المجال أمام ترقية عملتها وازدياد نقودها وهو ما عبر عنه السليماني بقوله:” وتبقى في البلاد نقودها وتزداد على مر الأيام ثروتها”. واعتبر هذا مؤشرا حقيقيا للتمدن الحقيقي، باعتباره يسهم في استغناء الأمة المتمدنة عن غيرها في جميع حاجياتها، وبالتالي تقوي من مركزها، ومكانتها في العالم.
إن التجارة الحقيقية، في نظر السليماني، ليست تلك المتعلقة بجمع النقود من ذهب ،وفضة ،والتوجه بها نحو أوربا قصد اقتناء نتائج أرضهم ومصانعهم من ملابس قديمة وغيرها، فهذا العمل من شأنه أن يستنزف خيرات البلاد قد يصل إلى الإفلاس، بل التجارة في نظره هي العمل على تصريف منتجات البلاد وخيراته من محاصيل زراعية ،وإنتاج صناعي، ومواد أولية ،ثم تصديرها نحو الخارج، وأخذ قيمتها نقدا وهو ما عبر عنه بالعملة الصعبة. وهي عملية داعمة للغنى والرقي وهي التي كانت وراء “اغتناء أوربا ونمو ماليتها”.
فإغراق السوق الداخلية بالمنتوجات الأوربية يخالف في رأيه المصلحة الداخلية، وبالتالي قد يكون سببا في الأزمات الاقتصادية المتكررة التي تعاني منها الشعوب المستعمرة. وذلك لكونها تقضي على الإنتاج المحلي ،الذي يعتبر عربونا على قدرة الشعوب على الا نعتاق من التبعية. ولم ينتج هذا الوعي الاقتصادي الإصلاحي، الذي حرره السليماني عن فراغ، وإنما بعد دراسة مستفيضة للفكر الرأسمالي الذي يعتمد نظريات الفكر الاقتصادي الليبرالي ،ومقارنته بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي وضع لبنته الأولى كل من عبد الرحمان ابن خلدون وتلميذه المقريزي.
ويشترط السليماني في تحديث المجال الاقتصادي توفر الشروط الموضوعية لذلك ،خاصة على المستوى الاجتماعي، فهو يرى أن تتمتع الأسرة في هذا الباب بنوع من الاستقرار ،وذلك من أجل التعاون على “العمل وتمهيد المعاش” هذا التعاون تعبر عنه التئام “العائلة فالقبيلة فالمدينة فالأمة فالحكومة” ومرحلة التعاون هذه أساسية إذ تبين مدى تقارب الشعوب فيما بينها تقاربا اجتماعيا ،سياسيا واقتصاديا. هذا التقارب الشمولي هو الذي يمكن، حسب السليماني، من تيسير التوجه نحو العمل، وخدمة الأرض ،وتكوين الإنتاج، وبالتالي المساهمة في تكوين وتطوير “مصادر الثروة وطرق الارتزاق”.
فالاستقرار الاجتماعي ثم السياسي هو المدخل الرئيسي الذي دعا إليه السليماني قصد العمل على تحديث وتطوير المجال الاقتصادي ،مما يبين تأثره بالفكر الإصلاحي السلفي ، وبالأفكار التحديثية الغربية خلال القرن التاسع عشر . وللسليماني تدخلات في مجال الإصلاح السياسي الذي اكتسبه على ضوء دراسته لتاريخ العلاقات المغربية المتوسطية منذ التاريخ القديم إلى المرحلة التي عاصرها مرورا بالتاريخ الوسيط والحديث.
الإصلاح السياسي عند السليماني :
عرف عصر السليماني أحداثا سياسية لعبت دورها في تحديد توجهاته واختياراته، وأنارت طريقه للخوض في بعضها والمشاركة في تحليلها واستنباط مواقفه منها، ويرى أن الكتابة في السياسة لها علاقة وطيدة بالتجارب التي يعيشها الفرد وبمدى قدرته على استيعاب ما يجري ،واستنباط العبر ،والدروس من التاريخ ، فقد عبر عنها السليماني بقوله : “فهي تجارب أيام الحياة ومراجعة تاريخ العالم ودراسة طبائع الأمم ..”
من خلال قراءتنا لكتابات السليماني على المستوى السياسي ،ظهرت لنا قدرته على تكوين فكرة عن السياسة وشروطها ، فقد حدد السليماني وظيفة الرجل السياسي بشروطها، والتي حددها بالاتصاف بمكارم الأخلاق منتقدا بذلك نظريات الغرب، الداعية إلى نبذ الأخلاق واستعمال الحيل قصد بلوغ الهدف. ويبدو أن ابن الأعرج تأثر بما طرحه ابن خلدون في هذا المجال في مقدمته ،إلا أنه اطلع على النظريات الحديثة ودرسها وصاغ مفهوما لتعريفه للسياسة. كما اقترح بعض الشروط لنجاح المفاوض السياسي والتي حددها في أسلوب الخطاب ،ولين الجانب ،وملائمة الطباع ،والثقة ،والعلم ،والتجربة ،وغيرها. ولا غرو أن الأحداث التي عرفها المغرب وجهل بعض المفاوضين السياسيين، حسب السليماني، في معالجة بعض القضايا، كما حدث خلال حرب تطوان، هو الذي ولد مثل هذا الطرح عند السليماني يظهر ذلك من قوله: « فاستشاط المندوبان (يقصد الفقيهان الزبدي الرباطي والفقيه التطواني المكلفان بالتفاوض مع الإسبان لمعالجة قضية تطوان) غيظا بجهلهما مع قصورهما في تأدية مأموريتهما ولم يعملا بما يقتضيه الحال…». أما واجب السياسة فــ « يستدعي الإحاطة بجميع المنافع التي تنجم عن صلات الأمم قويها وضعيفها، بعيدها وقريبها، على اختلاف مللها ونحلها وعلاقات بعضها ببعض، وتبادل الكرامة والرغد وأمان الضعيف العاجز، وصيانة السلم والألفة بين أجناس البشر جميعها».
من خلال مقاربة السليماني لمشروع الإصلاح بين المشرق والمغرب ،تبين له أن الإصلاح بالمشرق وأهله كانت له شهرة أكثر عن مثيله في المغرب، لأن المغاربة، حسب قوله، أهملوا التاريخ والإصلاح معا ،وأن أهل المشرق أحسنوا تدبير المرحلة “بالحراك” الفكري والسياسي، الذي انخرط فيه معظم شبابهم ومن ذلك قوله:” ومنذ استفحلت دول أوربا وقوي طمعها، في فتح البلاد النائية عنها، فضاقت شبان الشرقيين بمزاحمتهم درعا، وانشأ أدباؤهم جمعيات خيرية وجرائد وطنية سلكوا فيها مسلك حرية الأفكار من بث النصائح، والتعريف بمقاصد المزاحمين. فسمت بذلك أفكارهم وعلت مداركهم، وظهر فيهم الكتاب السياسيون والعلماء الرياضيون والخطباء المصقعون والرجال المخلصون، وصار يرجى لمستقبلهم الفلاح والنجاح، حقق الله الرجاء ونصرهم على الأعداء” أما بالنسبة للمغاربة فيرى أنهم على جانب من الجهل، وخاصة العامة منهم الذين تأصلت فيه البداوة والخاصة منهم انكبوا على الملذات يقول ابن الأعرج في ذلك: “أما نحن معاشر المراكشيين فمادام شبابنا على جانب من الجهل بعواقب الأمور وعامتنا على غاية من تأصل البداوة، وخاصتنا منهمكة في البذخ ،واستلذاذ الحلاوة، فلا مطمع في نجاحنا ولا رجاء لفلاحنا ، بل مادمنا غير متشوفين لمجد الأوطان وتعزيز السلطان ،فلا يجمل بنا حتى حكم أنفسنا بأنفسنا. لذلك ألقينا بمصالحنا لغيرنا جهلا بإرادتها، ألهمنا الله لمصالح العباد وعمارة البلاد آمين”.
كما أن مشروع الإصلاح تميز بقصور الفاعلين ، وضعف النخب التي كانت في دواليب السلطة، فقد أشار السليماني ضمن كتاباته إلى ميلاد مشروع سمي بمجلس الأعيان، الذي كان يترأسه السلطان المولى عبد العزيز سنة 1905م ، من أجل حل بعض المشاكل المرتبطة بالإصلاح بالمغرب، ويمثل ذلك المجلس ممثلين عن المدن الكبرى. ومن بين مهامه مناقشة بعض الإصلاحات المفروضة على المغرب من قبل فرنسا. وقد اعتبره البعض مقدمة لفرض الحماية على المغرب، وحسب بعض الباحثين فإن المؤلفات التي أرخت للمرحلة “سكتت عن تحديد أصول وأهمية المجلس وبالتالي نتائج أعماله” لكن في المقابل تحدثت عنه بعض الكتابات الأجنبية، معتبرة إياه من صناعة المخزن قصد التعبير عن رفضه للإصلاح. وسبب ذلك أن المجلس أبدى مقاومة في قبول المقترحات الفرنسية لأن ” ممثلي الشعب قد رفضوها وأن رجال الدين لم يقبلوها” كما أشار محمد بن الحسن الحجوي إلى سلبيات هذا المجلس كذلك، في حين اعتبره علال الفاسي ” نواة صالحة للتطور الدستوري المنشود” وقد تعرض السليماني لهذا المجلس وأبدى رأيه فيه ، عكس ما ذهب إليه علال الفاسي، كونه لبنة أولى لتأسيس مجلس دستوري كما سبق، بحيث اعتبره مجلسا لا فائدة منه لاعتبارات تتمثل في كون النخبة المختارة الممثلة في هذا المشروع تتصف بالجهل بعلوم السياسة ، وعدم قدرتها على اتخاذ موقف محدد، أو على الأقل أن تكون لها اقتراحات تخرج المغرب من أزمته. كما أن تأسيس هذا المجلس، حسب السليماني، فرضته الضغوط الأوربية المتزايدة، وليس إرادة مخزنية ، قصد التهرب من الإصلاح، كما زعمت بعض الأقلام الأجنبية ومن ذلك قول السليماني:” ولما استحكمت الفوضى، وأشرفت الأمور على الانحلال، وجدت الدول ، ذات المصالح بالمغرب، السبيل في طلب الإصلاح بشدة الإلحاح، واقترحت على حكومة المغرب بفارغ صبر بث النظام، ونصب ميزان العدل، وفتح الطرقات بين العواصم لتسهيل المواصلات. وكانت الحكومة في عجز عن تنفيذ ذلك مع عدم إمكان تأجيله لوقت آخر” هذه الأسباب التي دفعت السلطان عبد العزيز إلى المبادرة من أجل تأسيس مجلس الأعيان كما عبر عن ذلك ابن الأعرج من خلال قوله:” وعند ذلك ظهر لهذا السلطان أن دعا جماعة من أعيان عواصم المغرب كتطوان وطنجة وسلا ورباط الفتح ومراكش إلخ، فأقاموا بمدينة فاس كنواب الأمة يترددون صباحا ومساء على دار الحكومة لمجلس الوزراء لأجل المفاوضة في الشؤون الكبرى التي أحاطت بالمكان. فكانت هذه الجماعة لا يحسن أعضاؤها سؤالا، ولا يفقهون جوابا، وإذا استشيروا أجابوا بقولهم: الخير فيما اختاره سيدنا السلطان فكان وجودهم وعدمهم سواء، وقد أنفقت الخزينة عليهم أمولا طائلة”.
الإصلاح التعليمي عند السليماني
على المستوى الشكلي، فالسليماني لا يرى مانعا من اقتباس نفس البرنامج التعليمي الفرنسي، رغم كونه يدعو إلى أمة حربية متعلمة لمنافسة الغرب في شتى المجالات، واستنباط كل ما يمكن أن يقدم لهذه الأمة ويجعلها في مستوى التقدم العلمي. لذلك تجده يركز على تعميم التعليم ،وحسن انتشاره بين سكان المدينة والبادية على السواء، كانتشار المساجد ،وكذلك تميز بدعوته إلى الاهتمام بالشكل الذي يجب أن تكون عليه المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية ،والعالية ،من بناء فخم، ومنظر جميل يؤكد الرغبة الشديدة في ربط التلميذ بالمؤسسة وربط علاقة تواصلية دائمة معها دون ملل. ويعتبر من الأوائل في بداية هذا القرن الذين ساهموا في تأسيس أول مدرسة حرة بفاس، حسب ما ورد في اللسان المعرب ، حيث ساهم فيها بتسطير أولويات البرنامج الدراسي الذي يراه ملائما لتلك المرحلة.
أما البرنامج التدريسي الذي يقترحه ابن الأعرج، فله دلالات تحديثية مهمة فعلى المستوى البيداغوجي يرى السليماني أن الطفل عندما يبلغ سن الخامسة من عمره يخضع مباشرة للتعليم الأولي ،من خلال ولوجه للكتاب القرآني قصد تلقينه الحروف والكتابة وآداب العبادة كالصلاة باعتبارها عبادة يجب على الطفل أن يتعلمها منذ سن مبكر، وأن يمارسها عند السابعة من عمره، وباقي الفرائض، وآداب الحوار ،والتكلم مع الكبار ،وحفظ القرآن الكريم ،خاصة السور القصيرة ،من سورة النبأ إلى سورة الناس، مع حسن الترتيل والتجويد ومعرفة مخارج الحروف كقاعدة أساسية لتعلم ما سيأتي. فهذه الآداب المذكورة يمتحن فيها التلميذ بعد مرور سنتين ،وإذا حصل على الشهادة من “مجلس الامتحان ” المنعقد وقته يؤهله للدخول إلى المدرسة الابتدائية”
لأن الحفظ، حسب قوله، مرحلة أساسية يمكن أن تقوي ملكة التلميذ واكتسابه قوة الذكاء بعد الحفظ والتسلح بالمبادئ الأساسية. هذه الخريطة البيداغوجية التي رسمها السليماني تعني طرحا جديدا في مرحلة ولوج عالم الحداثة في المجال العلمي. ولكن المضامين الفكرية والبرامج المقترحة مؤسسة على مبادئ الوطنية والدين كأساس وقاعدة. فهو عندما ركز على قضية “السؤال والجواب” فهذا معناه ترسيخ فكرة الجدل واستعمال المنطق عند التلميذ منذ الوهلة الأولى حتى لا يصبح وعاء يملأ بما شاء معلمه أو مدرسه من أفكار.
كما حدد المنهجية التي يجب أن يكون عليها التدريس ،وكيفية التعامل مع البرنامج التعليمي ،وطرق تلقينه للأجيال. فهو يرى أن الأستاذ يجب أن يتبع طريقة الإملاء للتلاميذ وهؤلاء يأخذون ما يملى عليهم ويكتبونه في دفاتر أو كتب صغيرة معدة للمدارس “من أجل مراجعتها” وفي نهاية الحصة تتم مناقشة الدرس قصد فهمه أكثر عبر أسئلة وأجوبة. وتتخلل الفترة الدراسية حصة من الاستراحة في إحدى حدائق المدرسة لبضع دقائق، ثم ينتقلون لدرس آخر مع أستاذ آخر،أو نفسه يتبعون فيه نفس المنهجية ،وهكذا كل يوم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا، ومن الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة مساء. ويسلكون فيها المسلك الأول، وهكذا على ممر الأيام باستثناء أيام الخميس والجمعة والأعياد والمواسم . وكل تأخر للتلميذ يجب أن يبرر بعذر مقبول.
لاشك أن هذا البرنامج المقترح من طرف السليماني، مقتبس شكلا فقط من البرنامج التعليمي الفرنسي، مع إخضاعه للواقع المغربي بمضامين تعليمية تساير رؤيته المؤسسة على التميز عن الآخر. هذا التميز المتمثل في مضامين البرامج الدراسية للمحافظة على الثقافة الإسلامية وهويتها. بالتركيز على اللغة العربية التي هي مفتاح كل العلوم سواء منها الشرعية أو العلوم الوقتية، إضافة إلى دعوته إلى تعيين يومي الخميس والجمعة يومين للعطل الأسبوعية ،انسجاما مع دول العالم الإسلامي، عوض يومي السبت والأحد الجاري بهما العمل في الأعراف الأوربية.
كما حدد أيضا سنوات التلقين في المرحلة الابتدائية بأربع سنوات ويفرض الانتقال إلى المرحلة الثانوية بإجراء امتحانات أسبوعية تجمع نقطها لتضاف إلى نقطة الامتحان الأكبر، الذي ينعقد على رأس كل سنة في نهاية الموسم الدراسي، أثناء دخول فصل الصيف. وينظم هذا الامتحان بحضور الأعيان، والحكام ،وأولياء التلاميذ بحيث يمتحن التلميذ في الفنون المختلفة التي تناسب حالتهم ،وعند نجاحهم يتم تكريمهم بتنظيم حفلات في آخر السنة مع تقديم هدايا مشجعة “ويبقى التلميذ في هذه المدرسة مدة أربع سنوات. وفي كل أسبوع يمتحنه أستاذه فيما سلف ،وإن أحسن ،ولو بعض الإحسان ،يعطيه شهادة خصوصية في دفتر صغير تنفعه يوم الامتحان الأكبر المنعقد على رأس كل سنة ،وعلى رأس “كل أيام بطالة المصيف المعلومة” في مجلس حافل يحضره الأعيان والحكام وآباء التلاميذ. ويسأل التلميذ على رؤوس الملأ في فنون مختلفة تناسب حالته. فإذا فاز بنيل الشهادة من الحاضرين تصدع عليه الموسيقى بألحانها الشجية ،ويناوله رئيس المجلس كتابا في فن من الفنون ،أو آلة من الأدوات المدرسية بعد تقبيله. فإذا صادف السنة الرابعة يتأهل للدخول إلى المدرسة الثانوية”.
هذه المرحلة الثانوية يراها السليماني تقتصر على المدن دون البوادي ،ويسافر لها التلميذ من البادية ،وتعد برامجها أكثر عمقا من تلك التي تلقاها في المرحلة الابتدائية ،ومحتوى المواد لا تختلف كذلك عنها، إنما ستزيد التلميذ دراية أكبر ويلخصها المؤلف في علوم العربية ،وعلم الكلام ،والعلوم الحسابية كالجبر ،والهندسة ،وعلم التقويم ،والمراصد وغيرها. ومدة الدراسة فيها أربع سنوات ،كالمرحلة السابقة ،وعندما يحصل التلميذ على الإجازة تؤهله لولوج الجامعة التي يتخصص فيها الطالب في شعبة من الشعب التي يراها قادرة على أن تؤهله إلى هدفه العلمي المنشود.
ويقسم السليماني هذه المرحلة إلى فروع، منها القسم العسكري ،ثم القسم الملكي، وهو بدوره ينقسم إلى أقسام ،يتخرج منه القضاة ،ورجال السلطة ،والمحامون ،والمدرسون ،والولاة، كما يتخرج منه قناصل الدول والسفراء ،والوزراء، والمهندسون ،والأطباء ،وغيرهم. كما يرى المؤلف أن التلميذ خلال هذه المرحلة الجامعية لا يجب أن يكتفي بدروس أساتذته ،بل يجب أن يتعداها إلى الاهتمام بالمصادر ،والمراجع خارج الحصة التي من شأنها أن تعمق مداركه وتوسع معارفه يقول: “ومن وصاياهم أن لا يقتصر التلميذ الحاذق على دروس المدرسة بل همته تؤديه إلى زيادة العلم خارجها…”
خاتمة
يمكن القول، إن السليماني ينتمي إلى المدرسة الإصلاحية الواقعية ،مما جعله يسلك منهجا مغايرا في طريقة معالجته لقضية الإصلاح والتحديث. بحيث استطاع من خلال كتاباته البحث عن جذور الأزمة التي هي التخلف عن الركب بسبب إهمال المغاربة للتاريخ ، وغياب التجديد الفكري، والجهل الذي طبع الفئات العريضة من المجتمع،
كما أن النهوض المطلوب لن يتم إلا عبر اعتماد العلم والدين، باعتبارهما توأمين لا يمكن الفصل بينهما ، ومن ذلك قوله: ” فيا أيها الإنسان التائه في معترك الحياة، إن الأمم الحية رفعت رؤوسها بعدما أفاقت من غشيتها، واستيقظت من ثقيل نومتها، ونفضت غبار الكسل عن ثوبها، وانخرطت في سلك أهل النباهة من أترابها. فأسلك سبيلها في الحرص على التعليم. فلا تدع علما إلا قرأته، ولا فنا إلا درسته، وأجعل آداب دينك الحنيف أساسا تبني عليه مدينتك، والعلوم الكونية التي حررها سلفك صلة بينك وبين من جاورك واكتنفك تكن من الفائزين في معترك الحياة.”
كما حث على إعادة الاعتبار للتربية الدينية والوطنية. فالغلبة اليوم للآخر ويجب تقبل الهزيمة ولابد من التعامل مع تراث الآخر وتقبل التمدين باعتباره أصبح ضرورة وليس خيارا وان استرجاع مكامن القوة يمر عبر الرجوع إلى عمل السلف الصالح بغية الحفاظ على العقيدة والأخذ بأسباب التغيير من خلال المنظومة التحديثية الغربية.
ومجمل القول، فقد حاول السليماني المساهمة في تحليل الأزمة التي عرفها المغرب خلال بداية القرن العشرين ، ونظرا لبعده عن دواليب السلطة فقد كان يتمتع بجرأة سياسية، في تحليله لبعض المظاهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وجاءت تدخلاته عبارة عن مشاريع إصلاحية مهمة على المستوى الفكري والتربوي والعلمي، فقدم وريقات قابلة للتطبيق أثناء الفترة المدروسة، مناديا بالتشبث بالثوابت الوطنية والاستقرار مع وجود نظام يحمي مصلحة الأفراد والجماعات. ولا يرى مانعا في التواصل مع الغرب والاقتباس منهم في كل ماله علاقة بالتطور العلمي والتقني، لأن العالم الإسلامي، في نظره، يعيش مرحلة تدهور، وهي حقيقة يدعونا للاعتراف بها. ولابد من امتلاك الجرأة على التصريح بوضعنا. وعملية الانتقال إلى مرحلة أفضل لا تتم بالأماني أو الكسل بل بالجد والعمل.
فهل كانت مشاريع الفكر الإصلاحي خلال هذه الفترة صرخة في واد؟ أم أن الدولة المغربية غيرت مساراتها بعد فشل مشاريع المقاومة بالمغرب، رغم ما حققته في الميدان من ملاحم وبطولات؟ وهل اعتمد رموز الحركة الوطنية هذه الأفكار العلمية، التي دعت إلى إعادة النظر في المناهج المختلفة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؟ أم أن الضغوطات الأوربية أجهضت كل تلك المحاولات التي عبرت عن يقظة النخبة المغربية المتألقة ،ومساندة التيار الوطني المنفتح ،واستلهام طرق التغيير من المنظومة الأوربية نفسها؟